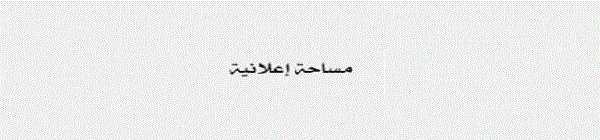قمة كامب ديفيد محاولة من أنظمة الخليج لأداء دور إسرائيل نفسه في المنطقة
طغاة الخليج في «كامب ديفيد»: على خطى السادات
هذه القمّة هي محاولة من أنظمة الخليج لأداء دور إسرائيل نفسه في المنطقة
أسعد أبو خليل
يحمل اسم «كامب ديفيد» معاني خبيثة ولئيمة في الذاكرة العربيّة الحديثة. هناك دُبّرت المعصيّة الأولى في عهد جيمي كارتر (متى أصبح هذا نصيراً للعرب؟)، ودُبّر بعدها في عهد كلينتون (وبمشاركة من آل سعود) وأد القضيّة الفلسطينيّة بالكامل. وهذه القمّة هي جائزة ترضية من الإدارة الأميركيّة لطغاة الخليج مكافأة لهم على طاعتهم وولائهم وصمتهم عن الاتفاق المنوي عقده بين النظام الإيراني وبين الدول الستّ. لكن غياب الملك سلمان (بحجّة متابعة الوضع في اليمن والإشراف على الإغاثة المُكلّلة بالقنابل والصواريخ) وغياب أداته ملك البحرين (بحجّة حضور مهرجان بريطاني للخيول) تركا امتعاضاً في حلق الإدارة الأميركيّة، وفي بعض وسائل الإعلام الأميركيّة.
لكن الإعلام الصهيوني السائد شديد الحرص هذه الأيّام على احترام مشاعر طغاة الخليج وتلبية مطالبهم طالما هي لا تتعارض مع مصالح العدوّ الإسرائيلي، لا بل تخدمها. لم يرفض اللوبي الصهيوني طلب تسليح لدولة خليجيّة منذ الثمانينيات. أصبح الخلاف بين دولة العدوّ الإسرائيلي وبين طغاة الخليج من التاريخ شبه السحيق. على العكس، فإن سفراء المملكة وباقي المشيخات الشخبوطيّة تنسّق مع اللوبي الإسرائيلي قبل تقديم طلبات تسليح ومن أجل جسّ مشاعر وكلاء اللوبي في داخل الكونغرس.
النظام السعودي يحلم باتفاقيّة أمنيّة تربط بين واشنطن وكل دول الخليج
كان غياب الملك السعودي سابقة في العلاقات الدبلوماسيّة بين البلديْن. شاب العلاقات بين الدولتيْن اللتيْن تتمتّعان بـ«صداقة دائمة» على قول جورج دبليو بوش، توتّر وإشكالات في الماضي: حدث ان الملك عبد الله بن العزيز عتب على الرئيس الأميركي في 2005 بسبب مناصرته للحرب الإسرائيليّة على فلسطين في غزة (كأن مَن سبقه في البيت الأبيض كان أقل مناصرة للحروب الإسرائيليّة) لكن مكالمة هاتفيّة واحدة من بوش الأب كانت كافية لإزالة الغيوم، وقدِم بعدها الملك عبدالله في زيارة إلى مزرعة بوش في تكساس. مَن لا ينسى صور تلك الزيارة وهي تظهر بوش وعبدالله يمشيان يداً بيد تحت سطح القمر (للمناسبة، هل بكى جورج بوش أيضاً على كتف السنيورة؟). في تلك الزيارة وفي جولة في المزرعة ظهر أمام الملك عبدالله في سيّارة بوش اوزّة، وأخذ عبدالله ظهور الأوزّة المفاجئ على أنه نذير خير وإشارة إلهية كي يمضي أكثر في تحالفه مع الإدارة الأميركيّة. (بقع العلمانيّة في العالم العربي لا تجرؤ على السخرية من الإشارات الإلهية عند آل سعود: فقط تسمية «النصر الإلهي» للدفاع البطولي عن لبنان بوجه العدوان الإسرائيلي هي التي تخدش علمانيّتهم).
إن غياب سلمان بن عبد العزيز علامة فارقة في العلاقة بين البلديْن ولها أسباب عديدة. كنتُ أتحدّث مع مستشار سابق (أميركي من أصل عربي) في وزارة الدفاع السعوديّة وقد خبر العلاقة مع الأمراء هناك وقال لي: لا تقلّل من عامل العنصريّة من قبل آل سعود نحو أوباما ذي البشرة السوداء. لقد تربّى الجيل الأوّل من أمراء آل سعود في قصور تعجّ بالجواري والغلمان، وتناوب معظمهم على نكاح الجواري والغلمان من دون سؤال. وتحرير العبيد في المملكة عام 1964 لم يكن إلا شكليّاً، وبحثّ غربي لإنقاذ آل سعود من الحملات الناصريّة التقدميّة الفعّالة ضد الحكم المتخلّف في الخليج. واستمرّ الرقّ في المملكة لسنوات بعد العتق وهناك عائلات مُستعبدة بأفرادها تعمل في القصور. من المُستبعد ان يهين ملك سعودي رئيساً أميركيّاً ذا بشرة بيضاء بهذه الطريقة. (والمفارقة، ان أوباما أيضاً، كممثّل لدولة الرجل الأبيض العظمى، يتعامل مع العرب بعنصريّة معاكسة). لكن ليس الموقف عنصريّاً فقط. هناك أسباب سياسيّة خصوصاً أن سلمان كان قد وافق على حضور القمّة التي قاطعها، وفي هذا إمعان في مخالفة الأعراف الدبلوماسيّة وفي إهانة المُضيف.
من المعلوم في هذه القمم ان المشاورات والمفاوضات تسبقها، وان القمّة تُعقد فقط من أجل الصور التذكاريّة والمصافحات والدردشات ومن أجل غرض الدعاية السياسيّة عن وثوق عرى العلاقة بين اميركا ووكلائها المطيعين في دول الخليج. وكان سقف المطالب السعوديّة والخليجيّة عالياً جدّاً. ببساطة، كانت دول الخليج تطلب ان تُعامل كما تُعامل دولة العدوّ الإسرائيلي. لكن هذا مستحيل قانوناً لأن الإدارة الأميركيّة ملتزمة تاريخيّاً وبقوانين من الكونغرس بضمان التفوّق العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي النوعي ضد إيران وضدّ كل الدول العربيّة، كلّ على حدة أو مجتمعةً. وحده عبد الرحمن الراشد المُعلّق في جريدة الأمير سلمان وأولاده، «الشرق الأوسط»، لاحظ ذلك فكتب ممتعضاً: «هناك وعود من الإدارة الأميركيّة لإسرائيل بأنها ستعزّز دفاعاتها، لتضمن استمرار تفوّقها على إيران والمنطقة». لكن لاحظوا ولاحظن أن الراشد كتب «إيران والمنطقة». أيّ منطقة يا عبد الرحمن الراشد؟ المنطقة الأمازونيّة أم المنطقة الباسيفيكيّة؟ أم أن الاعتراف بالتزام الراعي الأميركي بضمان تفوّق دولة العدوّ الإسرائيلي على كل دول العرب، بما فيها دول الطاعة في الخليج، محرج لمَن يروّج ليل نهار ان التحالف بين أميركا وبين آل سعود هو في صالح الطرفيْن، وان أميركا لا تريد إلا الخير للملكة القهر، وأن مرتبة آل سعود في واشنطن لا تضاهيها مرتبة؟ لم يرد الراشد أن يكتب «إيران والدول العربيّة» فظنّ أن «المنطقة» تفي بالغرض وإن بالتورية. إن هذا الالتزام يضع سقوفاً وحدوداً وضوابط على مدى الدعم الأميركي العسكري وحتى السياسي لدول الخليج.
لكن تطوّر العلاقة بين تلك الدول والراعي الأميركي عزّز الكثير من الأوهام في أذهان طغاة المنطقة إذ ظنّوا أن مرتبة تلك الدول ستُرفّع إلى مرتبة إسرائيل كحليف استراتيجي وثيق لأميركا. إن استضافة كل تلك الدول لقواعد عسكريّة أميركيّة عملاقة منذ 1990 بالإضافة إلى استضافة قواعد لأجهزة مخابرات أميركيّة متعدّدة دفع تلك الدول للظنّ أنها باتت في مرتبة العدوّ الإسرائيلي نفسه عند أميركا، خصوصاً أنها شاركت أيضاً في الحروب الأميركيّة الجارية في المنطقة من دون توقّف منذ عام 1990 (بصورة علنيّة، وهي غير الحروب السريّة. وحتى مملكة القهر التي صارحت الراعي الأميركي عام 2003 بمعارضتها للغزو الأميركي للعراق، شاركت بقوّة في العدوان الأميركي ضد العراق وأمدّته بالمساعدة والتمويل والضيافة للدلالة على إذعانها).
لكن هيهات. فإن حظوة إسرائيل عند أميركا لا تضاهيها حظوة، كما أن ثقة أميركا والعدوّ الإسرائيلي باستمرار حكم دول الطغيان الخليجي هي ضعيفة تاريخيّاً – كما يظهر فيما يتسرّب تقطيراً من وثائق دبلوماسيّة اميركيّة. إن دولة العدوّ تسمح لدول الخليج باقتناء كميّات هائلة من الأسلحة الأميركيّة (وبما يعزّز وضع الخزينة الأميركيّة) لكن من دون الإخلال بموازين القوى العسكريّة المُختلّة جداً لصالح العدوّ. وكان النظام السعودي يتوقّع مثلاً الحصول على طائرات «إف 35» لكن أميركا أفهمته أن هذه الطائرات المتقدّمة والسريّة متوفّرة فقط للعدوّ الإسرائيلي في المنطقة العربيّة، وإن الطائرات الأدنى مرتبة مسموحة من قبل اللوبي الإسرائيلي للتصدير إلى دول الخليج من أجل قصف اليمن وتدميره، وقصف من ترتأيه مصلحة العدوّ الإسرائيلي من أعدائه في المنطقة. لم تكن قائمة التسلّح هي المشكلة الوحيدة، وقد وافقت أميركا على قائمة مشتريات أخرى من كل تلك الدول بمليارات الدولارات. لا تمانع أميركا أن تتلقّى المليارات من هذه الدول مقابل سلاح محدّد وبسيطرة أميركيّة كاملة (اعترفت الصحافة الأميركيّة أن وزارة الدفاع السعوديّة كانت تتقدّم خلال الحرب الجارية في اليمن بقائمة أهداف من أجل قصفها إلى وزارة الدفاع الأميركيّة للموافقة عليها، أو تعديلها).
لكن النظام السعودي طلب أكثر من ذلك بكثير. كان النظام السعودي يحلم باتفاقيّة أمنيّة تفصيليّة تربط بين الإدارة الأميركيّة وكل دول الخليج من أجل ضمان ديمومتها وأمنها واستقرارها. طلب النظام السعودي من الإدارة الأميركيّة اتفاقية موقّعة تضمن حماية أميركا (وبكل الوسائل بما فيها السلاح النووي لو توفّر) لأمن مملكة آل سعود بوجه كل الأخطار والتحديات والتهديدات. لكن نشب خلاف بين الطرفيْن حول الجملة الأخيرة. أرادت أميركا التسليم بحماية أميركا للمملكة من التهديدات على ان تكون خارجيّة محض (وحسب التقويم الأميركي لا السعودي)، بينما ترفض السعوديّة، ومعها كل دول الخليج، التمييز بين التهديدات الخارجيّة والداخليّة. وهذه الضمانة المطلقة أرادها آل سعود للطمأنة بعد الزلزال المصري ورحيل حسني مبارك، حليف أميركا وآل سعود (ورأى آل سعود ان الإدارة الأميركيّة خذلت الحليف الوثيق وأنها كان مُلزمة بالسماح له بقتل مَن يريد من شعبه للبقاء في الحكم، ووافقتها إسرائيل في ذلك). لكن أميركا لم تستطع ان توافق على هذا النوع من الالتزام. ماذا لو ان دولة العدوّ الإسرائيلي قرّرت ذات يوم تغيير نظام الحكم في المملكة؟ هل ستأتي أميركا وتصدّ إسرائيل؟ حتماً، لا. كما أن الإدارة الأميركيّة وجدت صعوبة بالغة في التزام ضمان استقرار المملكة بوجه أخطار داخليّة. وحتى الأخطار الخارجيّة: تعلم الإدارة الأميركيّة أن المملكة تتفنّن في عزو كل حركة معارضة داخليّة في تاريخها إلى مؤامرة خارجيّة خطيرة، من الشيوعيّة العالميّة إلى الناصريّة الإقليميّة إلى المؤامرة الفارسيّة. هذا هو ديدن آل سعود وديدن باقي سلالات النفط والغاز. لم يتوصّل الطرفان إلى اتفاق حول تحديد ماهية الأخطار والتحديّات التي يتوجّب على أميركا التدخّل ضدّها. كما أن اميركا لم تكن في وارد توقيع اتفاقيّة امنيّة عسكريّة مفصّلة في هذا الشأن، حتى لو توصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن تحديد ماهية الخطر الخارجي.
لكن الموضوع الإيراني كان سائداً وحاول النظام السعودي ان يفاتح الإدارة الأميركيّة بشأن ملاحظاته واعتراضه مقابل تنازلات اميركيّة. وأتى آل سعود وصحبهم إلى واشنطن بدعم كامل من الحكومة الإسرائيليّة التي ضغطت على حلفائها في الكونغرس من أجل الضغط بدورهم على إدارة أوباما لتقديم ثمن سياسي لتلك الدول. ولقد قدّمت تلك الدول خدمة سياسيّة لأوباما قبل الحضور إلى «كامب ديفيد» عبر انتهاج سياسة نفاق في موضوع الاتفاق النووي الإيراني: ففي العلن، أعلنت دول الخليج تأييدها فيما هي عارضته سرّاً وفي المداولات مع واشنطن. هي لم ترد ان تحرج الرئيس الأميركي بعد إذلاله في الكونغرس على يد نتنياهو.
هذا لا يعني أن آل سعود لم يحصلوا على تنازلات أميركيّة: فلقد حصلوا على تنازليْن مهميْن (بالنسبة لهم). أولاً، وافقت الإدارة الأميركيّة على إضافة بند متعلّق بالوضع السوري إلى جدول المحادثات من دون ان تلتزم المساعدة الميدانيّة في تغيير النظام هناك. ولقد أراد الحكم السعودي من خلال تحالفه مع الحكومة التركيّة وإطلاق العنان لـ«جبهة النصرة» لقيادة معارك «الثورة» من أجل إبهار واشنطن والكونغرس بزخم السياسة السعوديّة الجديدة. ثانياً، لم يأتِ الأميران السعوديّان (وليّ العهد ووليّ وليّ العهد) هكذا عفواً. كان قرار التغيير في داخل الأسرة الحاكمة بتأييد وتدخّل مباشر من الحكومة الأميركيّة. لقد قلب هذا التغيير الذي أعاد إلى الحكم وبقوّة الجناح السديري (أو جناح من الجناح السديري، بالأحرى) الموازين في داخل العائلة، ولقد سُجلت اعتراضات من داخل نخبة العائلة ضد القرار (لم يكن قرار البيعة بالإجماع هذه المرّة) لكن الدور الأميركي قلّل من حجم الخلاف أو أنه فوّت الفرصة على إمكانيّة بروز جناح معارض لخط التوريث الحالي لأن الدور الأميركي حاسم في ترجيح دفّة الاختيار والقرار. ثالثاً، هناك تنازل ثالث وهو متوقّع: لقد أزعجت الإدارة الأميركيّة أنظمة الخليج جرّاء حديث أوباما مع توماس فريدمان (هناك في الصحافة العربيّة من يأخذ بكلام وتعميمات المعلّق الصهيوني على أنها معلّقات في الحكمة والبلاغة في القرن الواحد والعشرين مع ان شعبيّته تنمّ عن سطحيّة الثقافة السياسيّة السائدة في أميركا وعجزه عن التفكير أبعد من السطح)، في هذه المقابلة مع فريدمان، ذكر أوباما عرضاً ان التحدّي الأكبر الذي يواجه أنظمة الخليج هو التحدّي الداخلي من سكّان البلاد. أغضب هذا الإقرار مشاعر الطغاة، وسخّروا أبواقهم للردّ عليه، لأن الأنظمة ترى في نفسها مشاعل للحريّة والتنوير و… قطع الرؤوس متى أينعت. هذه أنظمة ترفض الاعتراف بأنها تواجه معارضة من أي نوع، ولا ترى انها تستحق المعارضة. هذه أنظمة تسمح لآل سعود مثلاً بعقد مؤتمر عن اليمن في الرياض وإعلان أن النظام السعودي سيشرف على الانتقال الديمقراطي المدني في اليمن. لكن أنظمة الخليج أساءت فهم تصريح أوباما. كان الأخير يعني ان من مصلحة تلك الأنظمة التعامل مع التحديّات الداخليّة من أجل استمرارها إلى أبد الآبدين، لكن هذا لم يكف وجرحت ملاحظة أوباما مشاعر الطغاة. وعليه، فإن أوباما الذي كان قد وعد بأنه سيفاتح قادة الخليج بهذه الحقيقة، عاد وتجاهل الموضوع بالكامل في قمّة «كامب ديفيد». ومتى كانت اميركا تثير مواضيع حقوق الإنسان والديمقراطيّة مع حلفائها أو حتى مع خصومها (مثل الصين) إذا كانت المصالح التجاريّة تقتضي عكس ذلك. إن رؤساء أميركا يثيرون قضايا حقوق الإنسان مع الطغاة الحلفاء لماماً وعلى هذه الطريقة: «ديروا بالكم على حقوق الإنسان، والآن لننتقل إلى مواضيع أهم مثل النفط أو التجارة أو بيعكم ما تشتهون من السلاح». لم تذكر أي وسيلة إعلاميّة ان أوباما أثار موضوع التحديّات الداخليّة مع أي من قادة الخليج، أو موضوع تنامي قطع الرؤوس في مملكة القهر. رابعاً، قدّم أوباما تنازلات أخرى لتلك الدول: فهو لم يثر موضوع التمويل والتسليح الخليجي للمنظمّات الإرهابيّة. إن مصدر التمويل الرئيس لـ«داعش» وباعتراف أميركي يأتي من مملكة القهر السعوديّة. لكن الحكومة الأميركيّة تنصرف، كما كتب الصحافي البريطاني، بريان ويتكر، إلى الحديث عن حماية دول الخليج من أخطار خارجيّة (حقيقيّة أم مزعومة) فيما تهمل الحديث عن حماية العالم من مخاطر نابعة من دول الخليج عينها. على العكس، هي تسرّ في ان تتجاوب مع كل مخاوفهم عبر توقيع طلبات تسلّح جديدة. وذكرت «نيويورك تايمز» ان الحكم السعودي أنفق ما يعادل 500 مليار دولار في العشرين سنة الماضية، وهو أنفق ثلاثة أرباع المبلغ في الولايات المتحدة. أصبح الإنفاق الخليجي على التسليح ليس أكثر من دعم للميزانيّات الغربيّة مقابل دعم عسكري وحماية (حماية من الأخطار الخارجيّة والداخليّة على حدّ سواء، من دون إعلان ذلك في إتفاقيّات لأن أميركا والدول الغربيّة ستتنصّل مِن هذه الأنظمة فور سقوطها كما فعلت في تونس ومصر عندما تناست دعمها على مدى عقود للطغيان في البلديْن وبرز أوباما وهيلاري كلينتون في ثياب المُحرّر للشعوب العربيّة). وتعلم أنظمة الخليج ذلك، لكن ليس لديها خيار آخر.
إن الكلام في الإعلام الخليجي عن تنويع في مصادر التسليح وعن تفتيش آل سعود عن بديل لأميركا في حال عدم حصول النظام على ما يريد، وبالكامل، هو كلام لا تأخذه واشنطن على محمل الجدّ. هذا يذكّر بتهديدات كان الملك حسين يطلقها في السبعينيات والثمانينيات عن أنه سيعيد النظر في تحالفه مع أميركا إذا لم تدعم «عمليّة السلام» بقوّة، وكانت تلك التصريحات تُقابل بسخرية في أميركا لأن الملك في الجيب الأميركي، كما ان أنظمة الخليج في الجيب الأميركي. أما ما يتحدّث عنه الإعلام الأميركي عن جسور سعودية جديدة في العلاقات الدوليّة وعن «سياسة عضليّة» فليس هذا إلا في سياق التحالف الإسرائيلي ــ السعودي الوثيق الذي بات يفوق في حميميّة التحالف الأميركي ــ السعودي. تعلم واشنطن انها تستطيع متى تشاء فرض العودة السعوديّة إلى بيت الطاعة المطلقة. كما ان العقود العسكريّة بين البلدين تفرض على آل سعود استمراريّة في العلاقة لسنوات طويلة (لضرورات التدريب والإشراف والصيانة وغيرها من ضرورات الصفقات العسكرية العملاقة).
لم تكن قمّة «كامب ديفيد» إلا تكملة لمسيرة بدأت مع استضافة السيّئ الذكر، أنور السادات هناك. عملت أميركا مذّاك على إعداد نظام عربي جديد متصالح مع العدوّ الإسرائيلي. ظن الشعب العربي ان القمّة العربيّة في بغداد كانت من أجل طرد السادات ونهجه من الجامعة العربيّة، فيما كانت الخطوة الأولى نحو طرد الشعب العربي من الجامعة العربيّة وضم العدوّ الإسرائيلي إليها كعضو شرف غير مُعلن. لم يشذّ نظام عربي عن ذلك، بعد الإجماع البغيض في قمّة بيروت حيث اتفقت كل الأنظمة العربيّة على الولوج في نفق «كامب ديفيد» الأوّل. وهذه القمّة هي محاولة من أنظمة الخليج للعب دور إسرائيل نفسه في المنطقة من دون أن تدري انه لا يُسمح لها بلعب أي دور ما لم تكن إسرائيل موافقة عليها. إن العدوان على اليمن والعدوان على سوريا (العدوان على سوريا لا يفرّق بين نظام وبين الشعب وبين الأرض في سوريا عند هؤلاء، أو عند النظام) لم يكن ليسير من دون موافقة العدوّ الإسرائيلي.
أما أوباما فهو أراد تطييب خاطر الطغاة. زحفوا زحفاً للقائه ليسمحوا له بتطييب خاطرهم عبر بيعهم المزيد من السلاح الذي يدرّ أرباحاً هائلة على الخزينة الأميركيّة. مَن يدري: لعلّ أوباما سمح لهم بلقاء ممثّلين للعدوّ سرّاً إمعاناً في تطييب الخاطر. أو لعلّه وعدهم بمزيد من السلاح الأميركي… هديّة منهم إليه وإلى الخزينة.
ملاحظة: بعد كتابة هذه المقالة وإرسالها إلى المُحرّر، نشرت مجلّة «أتلانتك» مقابلة طويلة مع باراك أوباما أجراها الصهيوني جيفري غولدبرغ، وجاء فيها للمرّة الأولى في تاريخ العلاقات الأميركيّة ــ السعوديّة هذا التهديد من أوباما إلى آل سعود (ترجمتي): «إن سعيهم السرّي – المُفترض – لبرنامج نووي سيؤزّم بصورة كبيرة العلاقة التي تربطهم بالولايات المتحدة». هنا، يرسم أوباما حدوداً للتفرّد السعودي في السياسة الخارجيّة، وخصوصاً إذا كان التفرّد لا يتلاءم مع مصلحة العدوّ الإسرائيلي.
* كاتب عربي (موقعه على الإنترنت:angryarab.blogspot.com)
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | asadabukhalil@
الاخبار اللبنانية : العدد ٢٥٩٧ السبت ٢٣ أيار ٢٠١٥