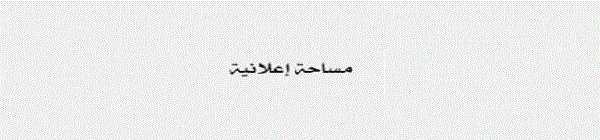مشروعُ “أبراهام” وترامب
عبدالرحمن مراد
عاد ترامب إلى البيت الأبيض بعد جولة انتخابات وفق المتعارف عليه في النظم الأمريكية، وعودة ترامب ليس اعتباطاً ولن يكون اعتباطاً؛ فقد كانت عودته كضرورة أملتها الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي العميق الذي يسير وفق خطط واستراتيجيات بالغة الدقة ووفق قيم معرفية حديثة سياسية واجتماعية واقتصادية، فعودة ترامب للبيت الأبيض الهدف منها إحياء مشروع أبراهام وهو المشروع الذي بدأ المهاد له عام 2020م بمصفوفة من الاتّفاقات وكان من نتائجه ما شهدته المنطقة العربية من تبدل وتغير في المواقف والقناعات السياسية، حَيثُ تحولت القناعات السياسة لصالح “إسرائيل” بدليل ما حدث في غزة وفي جنوب لبنان مؤخّرًا كنتيجة منطقية لمقدمات منطقية.
مشروع أبراهام يقوم على فكرة الوحدة المشتركة بين الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية؛ باعتبَار الحد المشترك بين الديانات الثلاث هو نبي الله إبراهيم -عليه السلام- وهو مشروع خطير جاء ليحقّق الوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية وقد نجح المشروع في تفكيك المنظومة الثقافية العربية والمنظومة السياسية مما ترك ظلالاً على مستوى العلاقات بين البلدان العربية و”إسرائيل” بل تسرب ذلك الضلال إلى أفراد المجتمع العربي فأصبح الناس بين راض بالتطبيع وبين رافض، وقد ساهمت حركة تطبيقات التواصل الاجتماعي في بيان ذلك بكل وضوح، خَاصَّة مع حرب الإبادة التي تقودها “إسرائيل” ضد حركة المقاومة الإسلامية لمشروع التطبيع مع “إسرائيل” التي تسعى من خلالها إلى الوصول إلى فكرة الشرق الجديد.
فكرة الشرق الجديد مرّ بعدة مراحل إلى أن وصل إلى الفكرة الأخطر وهي اتّفاقات أبراهام، التي ظاهرها الوحدة المشتركة بين الديانات الثلاث وباطنها الوصول إلى دولة “إسرائيل الكبرى” التي تمتد من النيل إلى الفرات، وهي فكرة معلنة بدأت كمشروع إسرائيلي تحدث عنه شمعون بريز في كتاب أصدره مطلع الألفية ثم تحولت إلى خطاب سياسي وإعلامي على لسان وزراء خارجية أمريكا، وتعذر هذا المشروع عام 2006م بعد حرب تموز على لبنان، واستمر منذ عام 2007م بفكرة بديلة وهي فكرة الخلافة الإسلامية التي تبناها تنظيم الإخوان الدولي، وقد اجتمع التنظيم في تركيا، وقد نجحت تلك الثورات نجاحاً جزئيًّا لكنها واجهت ثورات مضادة؛ مما عكس النتائج المتوخاة من حركة الاضطرابات في المنطقة العربية، ولكنها أحدثت شرخاً وتمايزاً طائفيًّا في المجتمعات العربية وتمايزاً عرقيًّا وثقافيًّ؛ مما مهد الطريق للتعامل مع الواقع العربي الجديد بفكرة أبراهام، التي دلت حركة الواقع على نجاحها في التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي انقسام الشارع العربي بين مؤيد ومقاوم للوجود الصهيوني، ولعل نجاح مشروع أبراهام بعد الأحداث الأخيرة في فلسطين وفي لبنان قد عزز القناعات بعودة ترامب إلى البيت الأبيض حتى تتمكّن “إسرائيل” من تحقيق حلمها في الشرق الجديد وهو في باطنه وفق معتقداتهم تحقيق دولة “إسرائيل الكبرى” التي تمتد من النيل إلى الفرات.
ومن اللافت للنظر أن اتّفاقات أبراهام التي تبنتها الإدارة الأمريكية في الولاية الأولى لترامب قد حقّقت لـ “إسرائيل” أهدافًا على مستويات عدة، خُصُوصًا في قضية تعزيز وجودها دون أن تتراجع عن حلمها الاستيطاني الاستعماري، هذا الأمر قد يجعلها تتمسك أكثر في رؤيتها للتعامل مع المنطقة العربية، أضف إلى ذلك اختيار التوقيت المناسب لإبراز هذه العلاقات وإخراجها للعلن، وقد تجلى ذلك في الموقف العربي من حرب الإبادة في غزة وفي لبنان.
نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي، والتعامل مع هذه المرحلة يفترض أن يعيد الحسابات والرؤى وبحيث تتبدل استراتيجيات المقاومة وتتعدد أبعادها؛ فالمعركة لم تعد معركة عسكرية فقط، ولم تكن كذلك في سالف أيامها، ولكننا كعرب تعاملنا معها كمعركة عسكرية، واشتغلنا على البُعد العسكري، وأهملنا بقية المستويات وهي مستويات نفذ منها العدوّ فأصبح يتحَرّك في المنطقة قتلاً وتدميراً برضى ومباركة المجتمع المسلم في غالبه معتمداً حالة الفرز الطائفي وحالة الانقسام وتنمية العدوات البينية، وقد تحَرّك في الفنون والآداب وفي فرض التطبيقات والمحتوى الثقافي الرقمي حتى يهيمن على الوعي الجمعي، واحتل العقول العربية المقاومة بالغياب والتغييب المتعمد، وبالتقليل من أثرها من خلال فرض نظام التفاهة الذي يحظى بدعم الشركات التجارية من خلال الإعلانات وتعزيز الموقف المالي للناشطين في تقديم المحتويات الرقمية الهابطة والمبتذلة، وظل المثقف الحر والمثقف النوعي يغرد خارج سرب الواقع بعد أن وجد نفسه في عزلة وفي ضياع، وقد تركته الأنظمة والواقع على رصيف الحاجة والجوع.
الواقع اليوم لا يتحَرّك وفق أحلامنا ولا وفق تطلعاتنا ومعتقداتنا، وهو يسعى إلى فرض وجوده بكل قوة واقتدار والتعامل مع هذا الواقع لا يتم بدون حركة وتعاط واستراتيجيات واضحة المعاني والأبعاد وقادرة على التفاعل مع مقدراته والتأثير فيها؛ لأَنَّنا بدون قوة ثقافية وقوة سياسية تؤازرها القوة العسكرية والاقتصادية ندور في فراغ قاتل، كما أن التعامل مع المستويات الحضارية الحديثة وخوض غمارها والاهتمام بالمثقف المتنوع والمتعدد وتوفير أسباب العيش الكريم له ومن ثم تفعيل دوره في الحياة وترميزه سيجعل مقاليد المستقبل في يدنا إن أحسنا الصناعة والتدبير والتفاعل الإيجابي والفاعل دون تحيزات وتمترس.