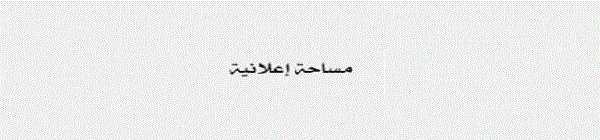السعودية وموقفها من القضية الفلسطينية.. خيانة أم استراتيجية متعمدة؟!
بينما يتحمل الشعب الفلسطيني عبء مأساة مستمرة، يصبح من المروع أن نرى كيف يختار النظام السعودي، الذي يُفترض أن يكون في صف الأمة، أن يعطل جهود أي تحالف عربي أو إسلامي لنصرة غزة. يبدو أن مصلحة آل سعود أصبحت فوق القيم الوطنية والإنسانية والروابط الدينية، مما يثير تساؤلات جادة حول نوايا مثل هذه الأنظمة التي تسعى لتمرير مشاريع لخدمة الأعداء بدلاً من خدمة شعوبها.
كيف يمكن لقادة يرفعون راية الانتماء إلى الأمة الإسلامية أن يقبلوا بتسليم ملفات الوطن لأعدائه؟ إن الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يشكل صفعة مدوية على وجه الشرف العربي والإسلامي، خاصة عندما يُنفق المليارات لدعم ألد أعداء الأمة، بينما يُذبح إخوانهم في غزة وجنوب لبنان في مجازر وحشية. تزداد الويلات والمعاناة، حيث يُحاصر الأطفال والنساء تحت وطأة آلة الموت، محرومين من أبسط حقوقهم في الغذاء والماء والدواء.
في الرياض، تبرز “الرقابة” كأداة قمعية تعيق مسار تعريف المعنى الحقيقي للحرية. خاصة، عندما تكون الأيدي القابضة على السلطة تستهدف كل من يُجرؤ على الكتابة أو التعبير عن رأيه الرافض لما يجري في غزة وجنوب لبنان. في السعودية، قبض على الناشطين لمجرد نشر صور أو تعليقات تتحدث عنما يجري في غزة ومعاناة أبنائها. إن ما يشهده الداخل السعودي من قمع يتجاوز الفهم، حيث تتجلى بطاقات الاتهام ووسم الخزي والعار على جبين نظام يدعي انتسابه للأمة، بينما ينشغل بجهود تبييض وجهه مع أعداء الأمة عبر تحويل ثروات الشعب إلى سلة خيانة.
نظامٍ يمتلك تاريخاً حافلاً بالعمالة، من المتوقع أن يتجاوز جريمته تلك إلى شن حرب شعواء لتكميم أفواه الشعب السعودي ومنعه من لعب دوره في نصرة القضية الفلسطينية؟ يكفي هذا النظام من أربابه الأعداء أن يشهدوا لـه بصفته عميلاً، كي يهرول بعيدًا عن القيم والمبادئ، لمد العدو بكل وسائل الإغاثة والدعم. إن الجسر الجوي والبحري الذي دُشّن لنقل الدعم إلى العدو الغاصب لا يكشف سوى عن سواد تاريخ نظام يتنكر لقضايا أمته.
ورغم أن هذه الأوضاع، تعزز قناعة الصهاينة بأن دعم أنظمة التطبيع الدائم، وتقويض نصرة غزة وجنوب لبنان، لن يؤدي في النهاية إلا إلى انتصارات مزيفة. ذلك أن الصراع العربي الإسلامي-الصهيوني يمثل على أرض الواقع مسار استمرارية لا يرفض ظلم الاحتلال فحسب، وإنما يكثف النداء للشعوب لتصويب أصواتها وأقلامها وجهدها ودمائها وأرواحها في اتجاه نصرة قضايا الأمة. بل لم يثبت في التاريخ أن تهاونت الشعوب في التمسك بحقوقها، فالكفاح يظل مرتبطًا بالحياة، مهما زادت التحديات.
صراع مستمر
المواجهة مع العدو الغاصب ليست صراعاً عابراً، بل تجسيدا صادقا لخيار الأمة في التحرر ونيل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. إن إخفاقات المواجهة العربية مع الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على ما يعانيه الشعب الفلسطيني، بل تمس أيضًا عقلية النظام السعودي، الذي لعب دورًا محوريًا في خذلان الأمة. فمنذ وعد بلفور عام 1917، ومرورًا بتأسيس الكيان الغاصب عام 1948، ثبت أن النظام السعودي يفتقر إلى رؤية استراتيجية تمكنه من تجاوز هيمنة القوى الكبرى.
في ست محطات، سنسلط الضوء على سلسلة الخذلان السعودي لمواقف الأمة العربية والإسلامية في مواجهتها مع العدو الصهيوني، مُبرزين الانزلاق المحزن الذي أدى إلى بلورة حالة من الانقسامات والتحديات المستمرة التي تواجه قضايا الأمة المركزية.
- الموقف السعودي من “كامب ديفيد” إلى الطوفان
في مشهد درامي من صميم الواقع، تبدأ أولى فقراته عام 1978، حيث الحدث الذي غيَّر مسار التاريخ، وهو معاهدة “كامب ديفيد” بين مصر والعدو الإسرائيلي، التي مثلت بداية لمراحل انتكاسة ستأتي متتابعة، البداية من حيث كان التخلي عن القضية الفلسطينية. ففي تلك الحقبة المظلمة، تآمرت الأنظمة العربية بالاتفاقية، لتمرر اعترافًا صادما لتطلعات الشارع العربي، ألا وهو الاعتراف بالكيان الإسرائيلي. السعودية، والتي كانت، حينها، تمتلك القوة والنفوذ، بدت غير متأثرة. وحتى اللحظة، لم يتولد لديها موقفا واضحا يعبر عن دعم حق العودة أو الانتصار للقدس، بل كانت الكلمات مُجرد صدى في صحراء النسيان.
ومع تأسيس “منظمة التحرير” الفلسطينية، تفجرت آمال جديدة، لكن السعودية لم تكن – رغم لغة الخطابات السياسية المزيفة التي كانت تلقى في المحافل الدولية والمؤتمرات العربية- لاعبًا جديرًا بالثقة في ساحات الدعم الفعلي. فبينما كانت تتحدث عن الحماية والدعم، كانت هناك انقسامات جليّة بين قيادات المنظمة. وتحديدا، حيث تفضيل الرياض لفصائل معينة كان يحمل في طياته مزيدًا من التعقيد.
اليوم، ومع أن العالم يتغير بسرعة، يبرز محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على الساحة. في حديثٍ مثير للجدل. رغم أن سفير السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر، حاول أن يضفي على الموقف شيئا من التمويه حال تأكيده بـأن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بعد حرب غزة، باشتراط أن أي اتفاق للتطبيع “لابد أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية”، إلا أن تقريرا لموقع مجلة “ذا أتلانتك” الأمريكية نقل عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تصريحات أدلى بها قبل أشهر، قال فيها إنه ” لا تعنيني القضية الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا”، في أحدث إشارة على تجاهله لهذه القضية، في مقابل تأكيد اهتمامه بالتطبيع مع “إسرائيل”.
عقب ذلك، عاد الأمير خالد بن بندر كي يكشف، لـ”بي بي سي، أن الاتفاق كان “وشيكا”، عندما علقت السعودية المحادثات حول التطبيع بوساطة أمريكية، إثر اندلاع عدوان الكيان الإسرائيلي على غزة ردا على طوفان الأقصى بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، على مواقع إسرائيلية، يوم الـ من 7 أكتوبر.
خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مدينة العلا، تعمقت الأزمة، تراجع بن سلمان في موقفه إلى مربع التمويه “ما احتاجه هو ضرورة التزام إسرائيل بالدولة الفلسطينية”، ومع ذلك، ظل بلغة منطقية تتناسب مع الهوى الأمريكي بما توحي في مضمونها من عدم ممانعة بن سلمان من تنفيذ عمليات إسرائيلية ما أسماه “مكافحة الإرهاب”، بشرط أن تكون في الإطار الزمني الذي يناسب مصالحه.
وفي خطاب متعر عن الحقيقة، ألقاه في 18 سبتمبر، بدأ بن سلمان يحاول الارتقاء بموقف المملكة إلى مناص رفيع في التملص: “لن تعترف السعودية بإسرائيل ما لم تُقام دولة فلسطينية”. وهذا التصريح هو الخيانة على أصولها، حينما يسعى بن سلمان لترسيخ “حل الدولتين”، ففلسطين هي أرض عربية لا تقبل القسمة على اثنين مهما كلف الأمر.
ومنذ صعود الملك سلمان، زادت وتيرة تقديم الخدمات للكيان الصهيوني، بداية بشن العدوان على اليمن، بغير جرم سوى رفع شعار الموت لأمريكا وإسرائيل، والسعي نحو توحيد الأمة باتجاه العدو الحقيقي لها. كما عمد بن سلمان على تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية كمنظمات “إرهابية” وزج بقادة حماس في غياهب السجون.
حملت فصول الدراما للمواقف السعودية تجاه القضية تراكما كبيرا من المعاني المتضاربة، التي أوضحت عدم جدية الرياض في دعم القضية الفلسطينية، وألمحت، في الوقت ذاته، إلى تركيز هذا النظام على إقحام القضية ضمن ألعابه السياسية في التعامل مع المبادئ على أنها مجرد أدوات للمناورة.
في خضم التصدي لهكذا مواقف، بات الشارع الفلسطيني هو المعني باتخاذ مواقف حقيقية قادرة على تحقيق آماله في دولة مستقلة. وبالفعل، هو ذلك ما حدث فجر الـ 7 من أكتوبر عندما فجر قنبلة خياراته الجديدة “طوفان الأقصى” لتغير مسار اللعبة 180 درجة مئوية.
- الأموال والاستثمارات السعودية لأجل أمن “إسرائيل”
وفي جانب الأموال والاستثمارات السعودية مع أمريكا من أجل أمن “إسرائيل”، استثمرت السعودية في مشاريع عديدة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية في الدول الغربية، في الوقت الذي كان فيه الشعب الفلسطيني على تراب أراضيه المحتلة يعاني من نقص حاد لليسير من تلك الإمكانيات. ما يُظهر تهميش القضية الفلسطينية مقابل تعزيز علاقات الاسترضاء والاستعطاف السعودي غير المبررة بأكثر من رغبة هذا النظام في بلوغ أدنى درجات الابتذال في العمالة للقوى الكبرى.
في مقال نشره موقع صحيفة “مال” العالمية للكاتب السعودي زياد محمد الغامدي تتناول فيه تقارير إعلامية حول العلاقات التجارية بين مستثمرين سعوديين و”إسرائيليين”، مشيرًا إلى عدم وجود استثمارات مباشرة من السعوديين في “إسرائيل”، لكنه يؤكد على وجود استثمارات غير مباشرة. يتمثّل هذا النوع من الاستثمارات في حصص لشركات سعودية في شركات غير إسرائيلية تملك حصصًا في “إسرائيل”. يوضح الكاتب أن هناك شركات مدرجة وغير مدرجة في السوق السعودية مرتبطة بهذه الاستثمارات، ويعتبر الكاتب أن هذا الأمر ليس مخجلاً، خصوصًا في ظل عدم وجود قوانين سعودية تمنع الاستثمار غير المباشر في “إسرائيل”.
فيما تناولت صحيفة “معاريف” العبرية توقيع اتفاقية بين الإمارات و”إسرائيل” لإنشاء جسر بري يربط بين البلدين. الاتفاق تم بين شركة “تراكنت” الإسرائيلية وشركة “بيورترانز” الإماراتية للخدمات اللوجستية، حيث سيتم تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي عبر الأراضي السعودية والأردنية وصولًا إلى ميناء حيفا في الكيان الإسرائيلي. وأكد المدير التنفيذي لشركة “تراكنت” أن هذا الخط يوفر أكثر من 80% من تكلفة نقل البضائع مقارنة بالطريق البحري.
وربما يأتي ذلك في مسار تقديم بعض الأنظمة العربية، بما فيها السعودية، مزيدا من التنازلات السياسية، تحقق من خلالها مكاسب سياسية لحظية مع دولة أو دول تتجاهل حقوق الفلسطينيين، خصوصا عندما تتشكل من وراء هذه العلاقات نماذج للتعويل المفرط على المصالح الشخصية الضيقة، على حساب قضايا شعوب بأكملها. وبصرف النظر عن أن هذه التحالفات، وتحديدا قبيل الطوفان الأقصى، كان من المخطط أن تتفاقم مخاطرها وتؤدي إلى المزيد من التعقيد في الصراع العربي- الاسرائيلي، وتشكيل مستقبل غامض يعكس حالة من الانفصام بين الوعود السياسية والواقع الاقتصادي.
كوشنر “عرّاب التطبيع”
وفي قلب التلاعب السياسي بالورقة الاقتصادية، نكتفي بالتأمل إلى صورة رسم تفاصيل حكايتها جاريد كوشنر، رجل الأعمال البارع الذي يتربع على عرش الابتكارات الاستراتيجية. في استثمار سعودي أثار الدهشة، بلغت قيمته 3 مليارات دولار، ما مكن كوشنر من ضخ الأموال في شركته الخاصة “أفينيتي بارتنرز” بعد مغادرته البيت الأبيض.
هذا الاستثمار لم يٌعد، في نظر المحللين الأمريكيين، مجرد صفقة مالية عابرة، بل لقد مثل شهادة حية لروابط سياسية وثيقة بعيدا عن الثقة المتبادلة بين المملكة والتاجر كوشنر، خصوصا، وأن لهذه الروابط علاقة وطيدة بمسار تطبيع العلاقات الإسرائيلية- السعودية.
بدى ذلك، رغم أن طرفا الصفقة، حاولا إضفاء طابع تعزيز فوائد التعاون الإقليمي إلا ثمة انتقادات من زاوية مختلفة تمامًا أثارت المخاوف واستحضرت سيلا من الانتقادات، فالكثيرون اعتبروا الصفقة بمثابة خيانة وخذلان واضح من قبل النظام السعودي للمظلومية الفلسطينية، حيث أن السعودية، التي لطالما اعتبرت قضية فلسطين أحد أبرز أولوياتها، باشرت تقديم تنازلات قد تؤدي إلى تآكل الحقوق الفلسطينية في سبيل تحقيق مصالح سياسية بأغلفة اقتصادية.
إن هذا النوع من التطبيع، فُسَّر بالدفعة الجديدة نحو تحقيق أهدافا إسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، فضلا عن كونها تعد ضربا من الخلط الذي يعكس عدم التوازن بين المطالب السياسية والاعتبارات الاقتصادية، كون أن العلاقة غير الصحية ما بين السياسة والاقتصاد أصبحت أكثر وضوحًا في هذا السياق، حيث يتم استخدام القضية الفلسطينية كوسيلة للتلاعب بالمصالح والاستراتيجيات، مما يضع الشعب الفلسطيني ومطالبه في مرمى التنازلات.
- دعم النظام السعودي للأنظمة القمعية
ساهم النظام السعودي بشكل ملحوظ في دعم أنظمة استبدادية في الوطن العربي، حيث قدم دعمًا ماليًا وسياسيًا، مما عزز من قمع الحركات الشعبية المطالبة بالعدالة وإنصاف مظلومياتها. هذا السلوك يعكس خذلان الرغبات الشعبية العربية ومشاريع التحرير، كما يحقق مصالح شخصيات تتربع على أنظمة قمعية محسوبة على النظام السعودي داخل البلدان المستهدفة، مما يجعل من هذه السياسات أداة للخدمة الذاتية بدلًا من أن تكون تعبيرًا عن تطلعات الشعوب.
وعلى سبيل المثال، فإن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، يكشف أن النظام السعودي أداة طيعة بيد الأمريكي والإسرائيلي، واتضح جليا أن العدوان هدفه الأساسي خدمة المشروع الصهيوني، ومحاولة لثني اليمن عن مواقفه المشرفة تجاه قضايا الأمة. ويتضح جليا حجم انفاق مئات المليارات من الدولارات من أجل تدمير بلد عربي مسلم. ثم تعجز المملكة السعودية عن تسيير جسر من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الذي فتح به الجوع.
لم يكتف النظام السعودي بما عمله باليمن طيلة 9 سنوات. بل زاد من حجم الضغوطات على اليمن منذ اطلاق معركة طوفان الأقصى. حيث أقدم على تشديد الحصار واتخاذ العديد من الخطوات الاقتصادية بهدف تدمير الاقتصاد اليمني. لولا أن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وقف بجدية في وجه المؤامرة الاقتصادية السعودية وتمكن بفضل الله من إفشالها وإرغام النظام السعودي على التراجع.
وخلال الأيام الماضية. أقدم النظام السعودي على تحريك مرتزقته في الداخل والدفع بهم نحو تحريك الجبهات من جديد. حيث أعلن وزير دفاع حكومة المرتزقة الجهوزية والتحشيد لاستئناف المواجهات البرية خدمة للعدو الإسرائيلي.
في السياق المتصل، يبدو أن العقم الحقيقي للنظام السعودي يكمن في عدم استلهام الدروس من التجارب السابقة، إذ كان ينبغي عليه أن يتعظ من حروبه المتعاقبة مع اليمن، بدءًا من عهد الملك سعود وحتى اليوم. يُظهر النظام، الذي يعاني من داء الانفصام والعظمة، عدم القدرة على فهم العواقب التي قد تترتب على تصرفاته. فقد شهدت السعودية حالة ذعر غير مسبوقة بعد الهجمات التي شنتها القوات المسلحة اليمنية على منشآتها النفطية في أرامكو، وهو درس يجب أن يدفع النظام للتفكير مليًا في استراتيجياته المستقبلية.
كان يجب على السعودية أن تدرك أن أي تجاوزات قد تصدر عنها، أو دعوات للعودة إلى العدوان، ستعيدها إلى عصور العنف والحرب التي عانت منها، مما يعني أن أرامكو وغيرها من الأهداف الاستراتيجية قد تصبح ثمنًا باهظًا لأي تهور سعودي. بدلاً من الاستمرار في التحريض وإعادة إشعال فتيل الصراع، كان يتوجب على النظام أن يبحث عن حلول عملية لترتيب الأمور، تجنبًا للمسارات التي أدت إلى الكوارث السابقة.
إن المعطيات على الأرض، تعكس أن النظام السعودي لا يزال عالقًا في عقم سياسي واضح. فهو يبدو كأنه منزوع الإحساس بحق الوجود والعدالة، وهو ما يعكس فشلًا في فهم العلاقة بين القيادة والشعب، وتحديد في الحال اليمنية. بل ويثبت أن قادة الاستبداد الذين يراهنون على قمع الحقائق لن ينجحوا في النهاية في مواجهة الرغبات المتجددة، وخصوصا المتصلة بأهوائهم في السيطرة وفرض الوصاية أيا الثمن. وكأن، تجارب التاريخ لم تثبت لهؤلاء القادة أن الشعوب مستمرة، وعبر التاريخ في تطوير ورفع أسقف طموحاتها نحو التحرر والعدالة، مهما واجهت من تحديات وضغوط.
- تطبيع العلاقات السعودية مع العدو الإسرائيلي
في السنوات الأخيرة، بدأت ملامح التطبيع مع الكيان الصهيوني تظهر بوضوح، عبر الانفتاح على التعاون الاقتصادي والأمني. حيث أن بعض المسؤولين السعوديين بدأوا في الإشارة علنًا إلى إمكانية إقامة علاقات رسمية مع “إسرائيل”، ما عكس تراجعًا فاضحًا عن القيم والمبادئ الإسلامية.
مع أن النظام السعودي ليس بحاجة فعليًا إلى توقيع اتفاقيات تطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حيث أن الاعتراف السعودي بإسرائيل قائم بالفعل منذ نشأته، ومن خلال العلاقات الحميمة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتجلى، في خلفياتها السياسة الاستراتيجية، السعي السعودي إلى كسب ود “إسرائيل”، بل وتؤكد في كل مراحلها حرص النظام السعودي على أمن واستقرار “إسرائيل” أكثر من حرصه على أمنه واستقراره، بدليل ما قدمته المملكة من ضمانات بتهيئة الأجواء أمام توسع الكيان الإسرائيلي في المنطقة بأسرها.
- تهميش النظام السعودي “قضية القدس عاصمة فلسطين”
في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمةً لإسرائيل، كان من الممكن للنظام السعودي أن يلعب دورًا رياديًا بارزًا في مواجهة هذه القرارات الجائرة. فمنذ الاحتلال الأول للقدس عام 1967، والتي وضعت المدينة في مهب الريح تحت نير الاحتلال، كان واضحًا أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمي محدود الاختصاص بالعربي- الإسرائيلي، بل هي رمز للكرامة العربية والإسلامية. ومع ذلك، اختار النظام السعودي في أوقات حرجة ودون وجود استجابة حقيقية، أن يفضل الصمت والتسويف، مما أضاع فرصة حقيقية لتوحيد الصفوف العربية نحو قضية القدس.
التاريخ يعلمنا أن الشعوب لا تُبنى إلا بالقرارات الجريئة والوفاء بالالتزامات الأخلاقية تجاه القضايا الجوهرية. إن سلبية النظام السعودي تجاه القضية الفلسطينية لم تكن مجرد موقف آنٍ، بل انعكست على العلاقات العربية والعالمية أيضًا. وبدلاً من أن يكون حليفًا للقضية، زادت سياساته من اتساع الهوة بين الدول العربية وأضعفت وحدة الصف.
إن الوحدة في مواجهة التحديات الراهنة تتطلب أكثر من مجرد بيانات صحفية أو تعبيرات عن نوايا. تحتاج إلى رؤية شجاعة وإستراتيجية واضحة تُنظم الجهود المشتركة لتعزيز دعم الطوفان الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وبناء تكامل عربي يُسهم في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للمظومية الفلسطينية.
- الدور السعودي في تغييب دور الجامعة العربية
في عمق الدراما السياسية المأساوية التي تعيشها أمتنا، كان قد كتب فصل اتسم بالخداع والغموض. دعيت فصول مسرحيته الهزيلة إلى منصات عربية ودولية، عزفت على خشبته سيمفونيات الدبلوماسية تحت عنوان “تبويس اللحى”، التي تجلت في حقيقتها واجهة ما تخفي النوايا الخبيثة للنظام السعودي، الذي تبنى من خلالها دعم مسارات أدت إلى تفتيت وحدة الأمة وعمقت من انقساماتها.
أعين النظام السعودي، التي كان من الواجب أن تكون شاخصة نحو القدس، انحرفت، هنا، لتغوص في تفاصيل الصراعات المذهبية والسياسية، بين كل من قومية وشيعية وسنية ورأسمالية واشتراكية. وبينما تُستلهم هذه الانقسامات، تُخصص ميزانيات ضخمة لزيادة التوتر والفوضى بدلاً من توجيهها نحو تعزيز وحدة وتضامن العالم العربي. صارت تصب في مسار دعم السعودية للرواية الصهيونية الخبيثة (إسرائيل الكبرى)، وهو المسار كان أشبه بخنجر غُرس في خاصرة الأمة، في وقت تتزايد فيه حالات الانفصام بين النخب العربية، التي باتت محاصرة بالجدران التي تبنيها الأنظمة المتواطئة مع المشروع الصهيوني، بدلًا من تعزيز جسور التواصل.
وعلى مدى 7 عقود ونيف، والتساؤلات في تزايد مضطرد: أين نحن من وحدة الصف تجاه قضيتنا الأولى، قضية القدس؟ هل نحن مُجبرون على مشاهدة الدمار والانكسار، بينما تعمق المملكة علاقاتها مع النظام الصهيوني-الأمريكي؟ حضور السعودية في القمم العربية لم يُثمر عن أي نتائج إيجابية تجاه القضية الفلسطينية، بل اعتادت الرؤية على وعود تقليدية لم تفضِ إلى تغيير ملموس. من هنا، تتوضح المشكلة: هل تعكس هذه الممارسات غياب الإرادة السياسية الحقيقية في خدمة حقوق الشعوب؟.
منذ تأسيس الجامعة العربية والأمم المتحدة، كان الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق الدول الضعيفة. ولكن مع مرور الزمن، ظهرت ثنائية القطبية، مما أثبت أن النظام الدولي استخدم كأداة لاستغلال القوى الكبرى للدول الأصغر، وهنا تأتي “النظرية الواقعية” لتؤكد أن القوة هي من تحكم هذه العلاقات.
بين أروقة السياسة العربية، جرت الأمور على العكس من ذلك المفهوم تماما، فقد حرص القوم على التوغل في فرض سياسة تلاطم الواقع المرير بآمال محطمة، ليظهر لنا النظام السعودي بصورة غير متناسقة مع تطلعات الأمة. أنه النظام الذي يقف كجدار يفصل بين الأمل في وحدة الأمة بالحرص على تكريس واقع الانقسام والتفكك، وتحديدا حيث أضحت السياسة لعبة في يد حفنة من الحكام، بعيدين كل البعد عن إرادة شعوبهم.
في ختام السردية المؤلمة
يتجلى الوجه القبيح للموقف السعودي الذي أظهر خذلانه المتكرر لقضايا الأمة، وخصوصًا القضية الفلسطينية، على مدى عقود من الزمان. إن إقدام السلطات السعودية على اعتقال القيادي الفلسطيني محمد الخضري، رمز النضال والمقاومة، لم يكن مجرد حدث عابر، بل كان تجسيدًا صارخًا للتمادي الذي وصل إليه تواطؤ المملكة مع الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتعاظم فيه محاولات التصفية الممنهجة للقضية الفلسطينية. هذا الفعل المُخزي يضع علامات استفهام على المبادئ التي تأسس عليها النظام، ويؤكد أن مصالحه الذاتية هي من يصرفه عن قيم العطاء والبذل إلى الارتهان والعمالة.
منذ نشأته وعلى طول مراحل تكوينه، ورغم كل التحولات، فإن النظام السعودي لم يُظهر حتى الآن التزامًا حقيقيًا تجاه قضايا الأمة، بقدر ما مثل في كل موقف يتخذه في قضية من قضايا الأمة مساهمة فاعلة في تعزيز الفوضى وعدم الاستقرار، وتهديدا صريخا لمستقبل العلاقات العربية والإسلامية. ذلك أن النبع الذي انبثق منه النظام هو الخذلان المتواصل وهو ما يُبرز من خلال عجزه عن تحمل أعبائه صرفا عن تقديم العون لغيره.
في سياق بعيد عن مسار النظام السعودي الخياني، لم تقف المقاومة في غزة وجنوب لبنان مكتوفة الأيدي؛ بل أثبتت عزمها وإرادتها في مواجهة العدو. لقد استطاعت أن تهدي الصهاينة موتًا لم يعهدوه منذ تأسيس كيانهم، مسلطة الضوء على أكثر اللحظات الحالكة في التاريخ الصهيوني إلى درجة أن العدو، الذي كان يُدير معارك السياسيين بالأمس، صار اليوم مُجبرًا على التفكير في الاستسلام. وهو التحول الذي لم يكن محتملا لولا انطلاقة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، حيث استيقظت الأمة واشتعلت في نفوس المجاهدين روح الجهاد وحماسة العودة.
إن زمن السكون قد ولى، وحان وقت العمل والوحدة؛ لنستعيد كرامتنا ونرفع صوتنا نحو القدس. وفي هذه الرحلة، علينا أن نُعيد بناء الوحدة الحقيقية للأمة، لنضع حدودًا لما يُمارس ضد حقوقها، ولنُوقف التراجعات تحت ضغوط القوى الكبرى.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمامنا كأمة آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قائدا ومرشدا، وبالله ربا وناصرا، وبالقرآن منهجا هاديا، وعلينا كمجاهدين ارتضينا أن نبذل أنفسنا وأموالنا في سبيل الله ونصرة المستضعفين أن نتجاوز كل الحواجز لنحرر أنفسنا من قيود الانقسامات. ولابد لهذا من أن يترافق مع مراجعة جادة لما يحدث في الساحة السياسية، خاصة من جانب النظام السعودي. إذا أراد هذا النظام تغيير المصير الذي اختاره لنفسه، عليه أن يُدرك أن دوره لا ينحصر في إصدار بيانات خجولة، بل يتطلب تحركًا فعليًا نحو العدالة.