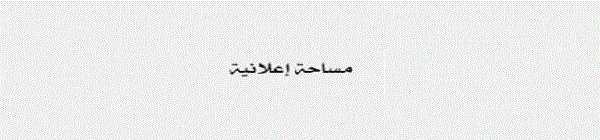طلّاب أمريكا يحاكمون قادتها
يمانيون – متابعات
تطرح الحركة الطلابية الأمريكية سؤالاً عالمياً كبيراً، يغطي فيه شبانٌ يافعون نقصاً عالمياً في الأخلاق والمبادئ التي لطالما قامت عليها المجتمعات والمنظومات القيمية العالمية.
هناك أسس أخلاقية للسياسة، حتى في أقصى براغماتيتها ونفعيّتها، هي لا بدّ أن تستند إلى أرضية صلبة تدّعي فيها الدول أنها تمثّل حقيقةً أخلاقية ما. لكن ما يشهده العصر الحالي من مرحلة ما بعد الحداثة، وفي المستوى المستجد من العولمة في عصر الذكاء الاصطناعي، يظهر انعداماً شبه تام لأسس القيمية التي من المفترض أن تغذّي نظم العلاقات بين البشر.
ثم في قلب هذا العصر المعتلّ، جاءت الأزمات الإنسانية في قلب أزمات سياسية وحربية لتفضح بصورة صارخة غياب القيم، بل انقلابها عند كبار مسؤولي العالم، ليس كأشخاص فحسب، بل كأصحاب قرار يشغلون مواقع في منظومات حكم وسيطرة، متشعّبة ومتغلغلة في كل تفصيل من تفاصيل النشاط البشري. يسيطر هؤلاء على الإعلام العالمي التقليدي بصورةٍ شبه كلية، ومن ينجو من سيطرتهم، تلتفّ حوله أفعى العقوبات والاتهامات الممجوجة والمبتذلة بالخشبية والشيوعية والإسلاموية ومعاداة السامية وغير ذلك…
كما يسيطرون على القرار السياسي في معظم العالم الغربي، وتمتد أياديهم إلى دول العالم الثالث، كمستعمرات عصرية تحتاج إلى المساعدة الخارجية الدائمة، واسمها الرسمي “ديون” البنك الدولي وصندوق النقد والدول المانحة، أو كمحمياتٍ غربية بوجه عالم ثالثي، واسمه الرسمي دول منتعشة اقتصادياً حليفة لأميركا، تشتري منها السلاح وتوفّر لها المواقف السياسية التي تناسب مصالحها، تغضب معها وترضى معها، تحزن لتراجعها وتفرح لهيمنتها.
وهؤلاء الساسة في الأغلب الأعم هم أبناء الجامعات الأميركية والبريطانية الذين كبروا، ويحكمون دولهم وشركاتهم العابرة للعالم، باسم الحضارة الغربية ولمصلحتها، وبالطبع فإن “إسرائيل” هي القاصر المجرم المدلل، الذي يحتاج للرعاية والحماية والتمكين من ممارسة الجريمة، من دون مساءلة أو حساب، ومن دون أن يحقّ للمقتولين على يديه حقّ الشكوى. وهنا يسطع مثال جارٍ الآن، تحاول فيه الولايات المتحدة تهديد المحكمة الجنائية الدولية لمنع إصدار مذكّرات اعتقال دولية بحقّ رئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين معه.
الطلاب المنتفضون يمثّلون الثقل الأخلاقي المتبقّي في العالم، وهم خطرون جداً على مستقبل “إسرائيل” ومصالح حلفائها الغربيّين في المنطقة إذا تحوّلوا إلى حركة دائمة منظّمة تعرف مكانها ودورها ومطالبها، وتمتلك الوعي اللازم والفهم الاستراتيجي المطلوب…
وقد كشفت الحرب الهستيرية على غزة زيف الكثير من ادعاءات القوى الغربية حول القيم السياسية والأخلاقية التي يروّجونها منذ عقودٍ طويلة، والتي باسمها غزوا دولاً وأسقطوا أنظمة وسرقوا ثروات، وقتلوا من شعوب تلك الدول ما لم يصل إليه أقسى الحكّام الذين جاء هؤلاء لإنقاذ الشعوب منهم، بحسب السردية التي لطالما أغرقوا بها الآذان والعيون والألباب.
الآن تبدو هذه السردية هشّة بصورةٍ تكاد لا تصدّق. وإذا كانت الأجيال التي عاصرت العقود الأخيرة من الحرب الباردة قد تمرّست على هذه الأنواع من الكذب، وبالتالي فقدت قدرتها على الشعور بالمفاجأة من جرّائها، فإنّ جيل الألفية الجديدة يرى شيئاً جديداً تماماً من مظاهر التناقض الصارخ بين ما يقال ويروّج، وبين ما هو قائم فعلاً على أرض الواقع، من مساندة كبريات الديمقراطيات العالمية لكيانٍ يمارس، مباشرةً على الهواء لنحو سبعة أشهر، جريمة إبادة جماعية على أساس عرقي، وفيها خليط من الفصل العنصري والتمييز الديني والاحتقار لقيمة الحياة الإنسانية من جهة، ولكلّ مندرجات القوانين الدولية والإنسانية التي راكمتها الدول والشعوب على مدى قرون طويلة من الزمن، ولم تتحقّق إلا ببحار من الدماء وجبال من البارود، وأعلى منها من جماجم الأبرياء وعظامهم.
وهذه الصدمة العالمية هي بالتحديد ما يفسّر دوافع الطلاب المنتفضين في الجامعات الأميركية وغيرها من جامعات الغرب. إذ يتلقّى الطلاب هناك تعليماً يغذّي عقولهم كلّ يوم بجوانب العلوم المختلفة، في مناخ يغذّي الشعور والاعتقاد بأن هذه الصروح ما هي إلا تعبير عن منجزات حضارة متفوّقة على بقية العالم، وبأنهم محظوظون بتلقّي العلم هناك، وبما توفّره لهم هذه الصروح من شعور وعلم يوصلانهم إلى أعلى مواقع القيادة في بلدانهم. وهم بعد ذلك سيشكّلون منظومة كبرى ـــــ علموا أم لم يعلموا ـــــ تخدم بدورها هذا الاتجاه العالمي المسيطر الذي تكون فيه أميركا وجامعاتها، وتالياً الجامعات والدول الغربية، أفضل مكان للتزوّد بالمعرفة من العلوم والسياسة والحياة في وقتٍ واحد، أي التعلّم على انتخاب الخيارات الصائبة في كل مناسبة.
و”إسرائيل” ضمن هذه السردية، تمثّل كياناً محمياً ومنزّهاً عن الخطأ، تتمّ خدمته ورعايته وضمان تفوّقه، ليس على أعدائه فحسب، بل على الجميع في الشرق الأوسط. هذه الأفضليات الكثيرة التي تعطى للكيان، أصبحت أعرافاً عالمية مدهشة ومستغربة. فلا أحد كان يتصوّر أنّ لدولة الحقّ بإهانة أي مسؤول أو منظّمة أمميّين لمجرّد التصريح بالدعوة إلى حماية المدنيين، أو الحديث عن تعرّضهم للقتل في الحرب، أو ابتزاز الولايات المتحدة بأنّ صدور أي مذكّرات توقيف من المحكمة الجنائية بحقّ نتنياهو ورفاقه في عصابة القتل سوف يؤدي إلى المزيد من القتل في رفح، أو الوقاحة التي يخرج بها هذا الأخير متحدّثاً للعالم… هذه أفضلياتٌ غير جديدة، وهي قائمة بفعل القوة الأميركية ولا شيء غيرها، منذ العام 1948، وهي نفسها القوة التي تمثّلها الجامعات الأميركية، لكن بوجهها الناعم.
الآن، وعلى الأقل في عيون هذه الأعداد الوفيرة والمتزايدة من الشبان والشابات المنتفضين في الجامعات، ينهار ذلك المنطق كله. وتبدو صورة مختلفة مشرقة قد تغدو مستمرة، وفيها ما يؤشّر على ولادة وعي عالمي جديد شاب ومتقدّم انطلاقاً من ركام البيوت وما تحتها من أطفال في غزة.
هذا الوعي الجديد يمثّله طلبة لم يعرفوا التفوّق المطلق للولايات المتحدة في نهاية القرن العشرين، وهم لم يروا سوى ما تمّ تلقينه في السنوات الماضية، بموازاة الحروب الأميركية في أفغانستان والعراق، والتدخّلات التخريبية على مساحة العالم، فضلاً عن التراجع الأميركي من الخارج إلى الداخل وأزماته المشتعلة الآن أكثر من أي وقتٍ مضى. وهؤلاء باتوا يقيمون المقارنات بين ما قيل لهم، وما يرونه الآن أمام أعينهم من حقيقة أميركا، وما بنت عليه إمبراطوريّتها، من سرقة للشعوب واضطهاد لها.
والخوف من هذا الوعي، وامتداده، هو ما يفسّر العنف الشديد الذي تواجه به قوات الأمن الطلبة المحتجين والمسالمين. الذين لم تعد القاعات التاريخية في جامعاتهم تليق بأسمائها السابقة، بل ما يليق بكل ما هو رفيع وثمين، هو شهادة طفلة مثل هند رجب، وهكذا حوّل الطلاب اسم قاعة هاميلتون إلى قاعة هند رجب في جامعة كولومبيا.
هذه لا تزال شرارة، لكنها شرارة مختلفة وشديدة الاتّقاد، وما هي سوى شيء يسير مما سيكون بعد ذلك حول العالم، تأسيساً على الأهوال التي شهدتها غزة، والحقائق/الفضائح التي كشفتها أمام كل من تابع ولا تزال لديه ذرة من ذرات الحسّ السليم والشعور الأخلاقي.
يعترف أنتوني بلينكن بأن “إسرائيل” خسرت معركة الرواية والعلاقات العامة، وفقدت سرديتها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وتدفّق المعلومات عبرها. ويرى قادة آخرون من الحزبين أن هذه الخسارة سوف تعزّز الاتجاه الحالي في أميركا لفرض مزيد من القيود، وصولاً إلى منع التطبيقات التي ليس لواشنطن سيطرة عليها. وهذا يقود إلى المزيد من الترابط بين القضايا الدولية، فما يبدو أنه متعلّق بغزة الآن، يمكن أن يكون مساراً واصلاً بالحرب الأميركية على الصين. ومن باب التطبيقات التي تتهم الصين بالعلاقة بها، سيكون مناسباً تماماً لواشنطن أن تتخذ خطوات عقابية، واعتماد نموذج خسارة “إسرائيل” حرب العلاقات العامة والسردية للتذرّع بخطر هذه التطبيقات عليها.
ثم إنّ أكثر ما يخيف نتنياهو والآخرين معه، هو تحوّلهم كأشخاص، وتحوّل كيانهم، إلى كيانات مدانةٍ عالمياً في المحاكم والأذهان. فالرأي العام يتغيّر، وما يحدث في الجامعات دليل على خطر كبير على الكيان، يؤشر على تغيير مستدام على المدى البعيد، وهو ما سيقضي على صورة “إسرائيل” والأسس التي بنت عليها أكاذيبها، وهي الأسس التي تقف عليها كـ “دولة” أمام الآخرين.
أما على المستوى الشخصي لهؤلاء، فيبدو أن دعوى جنوب أفريقيا وانضمام الدول إليها، وتوقّع صدور مذكّرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية، يتحوّل قادة الكيان إلى شخصياتٍ محتقرة وموسومة بجرائم الإبادة والقتل الجماعي والعنصري، وبالتالي ستتحوّل صورتهم التي روّجوا لها طويلاً إلى ما يشبه صور القادة النازيين بعد خسارتهم الحرب العالمية الثانية. وإن كانت المحكمة الحالية لا تشبه في شيء “محاكمات نورنبيرغ” في الشكل والظروف والسياق، فإن نتائجها على المحاكَمين، قد يكون فيها وجه للشبه، مع انقلاب الصورة الإسرائيلية بصورة متسارعة في كل مكان من العالم تقريباً.
سيكون لزاماً في وقتٍ ما من المستقبل القريب، أن يخجل أي مسؤولٍ عالمي بلقاء مسؤولي الكيان الإسرائيلي، وأن تلاحقهم لعنات الجرائم التي يرتكبونها أينما كان حول العالم. وصولاً إلى انهيار كيانهم.
فبعد الحرب هذه على غزة، لن يعود العالم كما كان.
– المصدر: الميادين نت