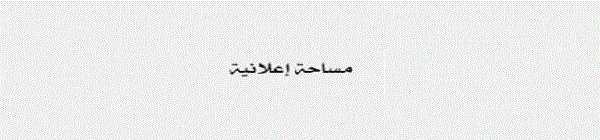المحاضرة الرمضانية الثالثة عشرة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي (نص+فيديو)
المحاضرة الرمضانية الثالثة عشرة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي 16 رمضان 1445هـ 26 مارس 2024م
لتحميل الملف
https://n9.cl/25i5v
أَعُـوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيْمِ
بِـسْـــمِ اللَّهِ الرَّحْـمَـنِ الرَّحِـيْـمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّداً عَبدُهُ ورَسُوْلُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّين.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُنتَجَبين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَالمُجَاهِدِين.
الَّلهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وَتُبْ عَليَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمْ.
أيُّهَا الإِخْوَةُ وَالأَخَوَات:
السَّـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ؛؛؛
من أهم وأبرز الأحداث في سيرة رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، وفي تاريخ المسلمين: غزوة بدرٍ الكبرى، التي وقعت في السابع عشر من شهر رمضان المبارك، من السنة الثانية للهجرة، وكذلك من أهم الأحداث في شهر رمضان، والتي وقعت فيما بعد بسنوات: فتح مكة، والذي كان في السنة الثامنة للهجرة النبوية، ولغزوة بدرٍ وفتح مكة الأهمية الكبيرة جداً- كما قلنا- في سيرة رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، وفي جهاده، وأيضا في تاريخ المسلمين؛ باعتبار ما لكل منهما (من فتح مكة، وغزوة بدر) من تأثير كبير في واقع المسلمين يمتد إلى قيام الساعة.
عندما نعود إلى غزوة بدرٍ الكبرى، نحن نعود إلى سيرة رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، الذي هو لنا الأسوة والقدوة، والذي عندما نعود إلى سيرته باعتبارها جزءاً مهماً مما نعود إليه في ديننا، ولاستلهام الدروس والعبر من المعلم والقدوة والأسوة، الذي منحه الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” النور، والهداية، والحكمة؛ ليعلمنا، وينقذنا، ويهدينا، والله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” عندما قال لنا في القرآن الكريم: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}[الأحزاب: الآية21]، كان ذلك أيضاً في سياق الجهاد في سبيل الله، ومواجهة أعداء الله، والتصدي للأخطار والتحديات، مع أنه الأسوة والقدوة في كل أمور ديننا، فعودتنا إلى سيرة رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” مسألة مهمة لنا في ديننا ودنيانا، ونستفيد منها على كل المستويات، ولها أهميتها بالاعتبار الإيماني، وباعتبار الواقع.
في هذه الظروف المهمة، والحساسة، والخطيرة، التي تعاني فيها أمتنا، وهي أمةٌ مستهدفةٌ من أعدائها بكل أشكال الاستهداف، ومن ذلك على المستوى العسكري، ليس هناك أمة استهدفت عسكرياً، وتستهدف حالياً، فيما بين الأمم القاطنة على كوكب الأرض مثلما هو حال المسلمين، أعداؤهم يغزونهم إلى عقر ديارهم، يحتلون أوطانهم، ينهبون ثرواتهم، يستبيحونهم ويقتلونهم بشكلٍ مستمر، لم تتوقف حالة القتل والاستهداف والإبادة للمسلمين، من حربٍ إلى أخرى، من غزوٍ إلى آخر، من استهدافٍ في هذا البلد إلى استهداف في ذلك البلد، من هجومٍ يباشره الأعداء بأنفسهم، بجيوشهم، بإمكاناتهم؛ أو من خلال مؤامرات يهندسونها هم، ويثيرون من خلالها الفتن بين أبناء الأمة، ويشغِّلون البعض من أبناء الأمة ضد البعض الآخر، وهكذا، نحن أمةٌ مستهدفة شئنا أم أبينا، ونحن بحاجة إلى أن نعود إلى سيرة رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، وإلى جهاده، من خلال ما قدَّمه القرآن الكريم، ومن خلال ما هو صحيحٌ وثابتٌ في كتب السِّيَّر والتاريخ؛ لنستفيد منه في واقعنا، فذلك يعنينا أيضاً، سواءً بحساب الانتماء الإيماني والديني، أو بحساب ما نواجهه وما نعانيه من تحديات وأخطار في واقعنا.
الأهمية الكبيرة جداً في غزوةٍ بدرٍ الكبرى: في كيفية قيام الأمة الإسلامية وانتصارها، ومواجهتها للتحديات والأخطار آنذاك، ونشوء وامتداد نور الإسلام، وكذلك في انتصار المسلمين، وفي تغيير الواقع الجاهلي الظلامي في الجزيرة العربية، وما تبع ذلك أيضاً في الأخير من امتدادٍ لنور الإسلام إلى أرجاء واسعة في الأرض، وإلى انتشاره عالمياً.
ولذلك أتت التسمية في القرآن الكريم لغزوة بدرٍ الكبرى تسميةً مميزة، وذات أهمية كبيرة، وتُلَخِّص لنا الفكرة عن مستوى الأهمية التي قد لا نستوعبها لتلك الغزوة، حينما سمَّها الله بيوم الفرقان، قال “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ}[الأنفال: من الآية41]، وهو يومٌ فارقٌ فعلاً، فارقٌ، ما بعده اختلف تماماً عمَّا قبله، ولمصلحة المسلمين، لمصلحة الرسالة الإلهية، لمصلحة قيم الخير والعدل والحق، ولطمس تلك الحالة من الخرافة، والجاهلية، والظلام، والباطل، والشرك، والكفر.
فيوم الفرقان نعمة كبيرة، امتدت آثارها ونتائجها المهمة عبر الأجيال، وهو محطة مهمة لاستنهاض الأمة؛ لأن الأمة في هذه المرحلة، في ظل ما تواجه من تحديات تُشكِّل خطورةً بالغةً عليها، والخطر الكبير هو: في جمودها، وقعودها، وتخاذلها، أمام تلك الأخطار التي تستهدفها، والتي لا ينفع معها التجاهل، ولا التنصل عن المسؤولية، ولا حالة الغفلة التي يصر البعض على البقاء فيها، فالأمة بحاجة إلى الاستنهاض، وبحاجة إلى استلهام الدروس والعبر، وأي دروس وعبر أبلغ من دروس وعبر نستفيدها من سيرة رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”!
عندما نأتي إلى يوم الفرقان، فيما قبله (ما قبل غزوة بدرٍ الكبرى)، بدءاً بالمرحلة المكية، قبل هجرة النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” من مكة، ومنذ أن بعثه الله بالرسالة فيها، تحرك “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” لتبليغ رسالة الله، وإيصال نوره إلى الناس، الرسالة التي بها الإنقاذ للبشرية، والإنقاذ ابتداءً لذلك المجتمع نفسه، ولمحيطه في الجزيرة العربية بكلها، الإنقاذ من الشرك، من الخرافة، من الباطل، من الضلال، من الكفر، من الظلم؛ الإنقاذ من نار جهنم، الإنقاذ من الخسارة الكبرى في الدنيا والآخرة، الإنقاذ من ذلك الواقع الجاهلي الظلامي السيء، الذي هبط بالقيمة الإنسانية للناس أنفسهم، عندما تحوَّلوا إلى عُبَّاد للأوثان والأصنام الحجرية والخشبية، وغيرها من الأوثان التي يصنعونها بأنفسهم، أو يشترونها من الأسواق بقيمتها، ثم يعكفون حولها كآلهة، ويعبدونها كآلهة، ويخضعون لها كآلهة، فيحصل مثل هذا الخلل الرهيب جداً في معتقداتهم، وفي المرتكز الأول والأساس في العقائد، يؤلِّهون تلك الأوثان والأحجار، والتي يصنعونها أيضاً من مواد متنوعة ومختلفة، ومع ذلك الانتشار الهائل للمفاسد الأخلاقية، للظلم للطغيان، الضياع في هذه الحياة بدون هدف، وضعية سيئة، كانت أيضاً منعكسةً على ظروف حياتهم بكل ما فيها، بكل ما فيها، والتفاصيل تطول عن هذا الأمر، تحدث عنها القرآن الكريم، فيما كانوا عليه من معتقدات، من ممارسات ممتلئة بالظلم، ممتلئة بالتوحش، إلى درجة قتل بناتهم، ووأد بناتهم وهُنَّ أحياء على قيد الحياة، وغير ذلك من الخرافات والمفاسد الرهيبة جداً، والممارسات السيئة للغاية، فالإسلام إنقاذ، إنقاذٌ وشرفٌ عظيم، يسمو بالإنسان؛ ليكون بمستوى إنسانيته.
مع حركة الرسول “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” لتبليغ الرسالة في مكة، واجهه معظم قريش بالتكذيب، والكفر، والصد، والإساءة، والحملات الدعائية؛ بهدف تشويهه، وتشويه القرآن، وتشويه الرسالة الإلهية، بالرغم من وضوحها، وقوة حجتها وبرهانها، وانسجامها مع الفطرة، ولكنهم كانوا يعاندون؛ لأنهم ارتبطوا بمجموعة من الطغاة، المجرمين، المستكبرين، والملأ الذين لهم دوافعهم، دوافعهم الشخصية، التي هي مبنية على الأنانية، والأحقاد، والأطماع، والكبر، والغرور، والمحافظة على النفوذ الذي هو مبنيٌ على ذلك، ومرتبطٌ به ما يمارسونه من الظلم والطغيان، ويريدون أن يكون الأمر مستمراً على ما هو عليه، فالإسلام بعدله، ونوره، وهديه، لا ينسجم مع تلك الأطماع والأهداف الشخصية، والأنانيات والممارسات الظالمة التي هم عليها، فوجدوا أنفسهم في تباينٍ مع نور الإسلام وعدله وهديه، وقيمه العالية والراقية، ومع ذلك كانوا يحاولون أن يمنعوا الناس من الإسلام، ولا سيَّما المستضعفين، من ليس له سند، ولا حماية عشائرية، توفر له الحماية من شرهم، بل البعض من العشائر والبيوتات كانوا هم الذين يتوجهون لممارسة الاضطهاد، والقمع، والظلم، تجاه من يُسلِم منهم، فعاش المسلمون عاشوا حالةً من الاضطهاد والظلم والمعاناة في مكة؛ لدرجة أن اضطر البعض منهم إلى الهجرة إلى الحبشة، فسار عددٌ منهم للهجرة هناك، وبقوا هناك؛ ليسلموا تلك الحالة من الاضطهاد.
وتزايدت حالة التكذيب، والمعارضة، والاضطهاد، ومحاولة إقناع الوفود التي تأتي إلى مكة للحج، أو للتجارة، بعدم الاستماع للنبي، ولا الإصغاء إليه، ولا الاستماع لرسالته، ولا التَّقبل لها، والمبادرة بالصد والتشويه ما قبل ذلك: ما قبل لقاء الناس بالرسول، أو سماعهم له “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”.
من بعد وفاة عم النبي (أبو طالب)، الذي كان له دورٌ أساسيٌ في حماية النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” في مكة، بما له من نفوذ وتأثير، ومعه عشيرته (بنو هاشم)، ازداد الاستهداف للنبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، وفي المرحلة الأخيرة أصبحت هناك مؤامرات لاستهدافه بالقتل؛ ولذلك أذن الله لرسوله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” بالهجرة، بعد أن وصل الوضع في مجتمع مكة إلى مرحلة لا يؤمَّل منهم أن يهتدوا للإسلام، ويتحركوا كحاضنة للإسلام، تحمل راية الإسلام، وتنشر نور الإسلام إلى بقية محيطها في الجزيرة العربية، أصبح أكثرهم- باستثناء القليل، وإلا القليل منهم- يتجهون في إطار معارضة الإسلام، ومحاربته، والصد عنه؛ ولذلك يقول الله عنهم في القرآن الكريم: {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}[يس: الآية7]، ووصل الحال إلى مساعيهم لاستهداف النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” بالقتل، كذلك هيأ الله البديل الجديد، وهم الأنصار، الذين سيتحركون كحاضنة لمشروع الرسالة الإلهية، ولحمل راية الإسلام، ولنيل هذا الشرف العظيم؛ فأذن الله لرسوله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” بالهجرة إليهم.
هاجر النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” إلى يثرب، إلى المدينة، إلى الأنصار، وبدأ مرحلةً جديدةً هناك، وانزعج المشركون في مكة انزعاجاً شديداً؛ ولذلك بدأوا تحركاتهم ما بعد هجرة النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” في عدة اتجاهات، منها:
عقد تحالفات وتنسيقات مع بقية القبائل العربية، التي هي قريبة من المدينة، أو في الطرق إلى المدينة، أو ما بين مكة والمدينة.
إضافةً إلى التنسيق السري ما بينهم وبين اليهود أيضاً.
وكل هذا في إطار العمل لمحاربة الرسول “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، والاستهداف للمسلمين، بدءاً بالتضييق الاقتصادي عليهم، اتفقت قريش مع كثيرٍ من القبائل أن يمنعوا المسلمين من أسواقهم، ومن المرور بأي نشاط تجاري أو حركة اقتصادية في مناطقهم، وكذلك بدأوا التحضيرات لمرحلة الغزو العسكري، والهجوم العسكري، والاستهداف العسكري للرسول “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” إلى المدينة؛ ولهذا الهدف أرسلوا قافلةً كبيرة- تعتبر من أكبر قوافلهم التجارية- أرسلوها إلى الشام؛ من أجل أن يحققوا مكاسب ضخمة، وقرروا في مكة، قرر مجتمع قريش أن يخصص عائدات وأرباح تلك القافلة، لتمويل هجومٍ عسكريٍ وعمليةٍ عسكرية، تستهدف النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، ومن معه من المسلمين في المدينة المنورة.
رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” كان على اهتمام مستمر، يرصد تحركات الأعداء، لم يكن في حالة غفلة، وكان يسعى إلى تهيئة المسلمين، وتحضيرهم في إطار هذه المرحلة الجديدة، التي سيدخلون فيها في مواجهات عسكرية وجهادٍ عسكري، فكان يسعى إلى رصد تحركات الأعداء، وإلى تنشيط المسلمين بدءاً بسرايا، سرايا (مجموعات) استطلاعية، تُنَفِّذ مهام استطلاعية، وتتحرك أيضاً لتكون المسألة مسألة مقبولة في الساحة، ولا تكون الحالة التي يبقى المسلمون فيها في المدينة حالة انكماش، وجمود، وقعود، تؤثِّر عليهم هم على المستوى النفسي، وتهيئ بيئة مغلقة في وجوههم في محيطهم؛ فأراد رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” للمسلمين أنفسهم، أن يكونوا هم متعودين على التحرك والخروج في تلك السرايا الاستطلاعية، وأن ينفِّذوا تلك المهام، التي هي مهام تهيئهم ذهنياً ونفسياً لما بعد ذلك من المواجهة مع الأعداء، وتنشِّطهم، وفي نفس الوقت تهيئ الساحة أمامهم؛ لتكون متقبلة لهذا التحرُّك، ولا تكون ساحةً مغلقةً في وجوههم.
عندما علم رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” بتلك الترتيبات والاستعدادات لدى قريش، والتي تهيئ لمهمة عسكرية لاستهداف المسلمين في المدينة، تحرَّك رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” وقت عودة تلك القافلة، قد أصبحت تلك القافلة آتية وعائدة من الشام، وعلى رأسها أبو سفيان، فرسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” جمع من انطلق معه واستجاب له من المسلمين في التحرك لاستهداف تلك القافلة، وكان من الوارد ابتداءً أن هذه الخطوة قد يقابلها المشركون بتحركٍ عسكريٍ عاجل من مكة، كان هذا الاحتمال وارداً منذ البداية؛ ولذلك خرج النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” بنفسه في هذه المهمة، وعلى رأس هذه المهمة، وفي نفس الوقت خرج بمن استجاب له من المسلمين، بأكثر من ثلاثمائة شخص، في بعض الروايات (ما بين ثلاثمائة، إلى ثلاثمائة وأربعة عشر شخصاً)، وهؤلاء هم الذين استجابوا له في الخروج معه “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”.
وقدَّم لنا القرآن الكريم عرضاً مهماً، عرضاً مهماً جداً لتسلسل تلك الأحداث، وقدَّم (سورة الأنفال)، التي هي بكلها تعرض من أولها إلى آخرها، وعرضاً مميزاً جداً، أحداث غزوة بدر، عرضاً مليئاً بالدروس والعبر، يبني الأمة فيما بعد ذلك، سواءً في عصر رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، أو ما بعده؛ لتكون في مستوى القوة، والمنعة، والتحرك الفاعل في مواجهة المخاطر التي تهددها.
يقول الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” في القرآن الكريم: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}[الحج: الآية39]، أتى الإذن من الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” للنبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” وللمسلمين بالتحرك العسكري، كانت هذه الآية- بعد تواجدهم في المدينة، واستقرار وضعهم فيها- هي الإعلان عن بداية المرحلة الجديدة، التي سيتَّجه المسلمون فيها لمواجهة الأعداء، إلى هذا المستوى: لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدفهم عسكرياً.
ثم عندما أتى التحرك- كما قلنا- في وقت حركة تلك القافلة وعودتها، وهي قافلة خُصِّصت عائداتها للترتيب للاستهداف للمسلمين بعملية عسكرية، يقول الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ}[الأنفال: 5-6]، نجد أنَّ الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” هو الذي أمر رسوله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” بالتَّحرُّك، لم يكن ذلك التَّحرُّك عبارة عن رأيٍ شخصيٍ من النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، أو من بعض المسلمين؛ وإنما كان أمراً من الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”، في إطار تدبيره وتوجيهاته وتعليماته، وهذا درسٌ مهمٌ لنا نحن المسلمين في هذا العصر، الذين نتقاعس عن التحرك حتى بعد أن يدهمنا الخطر إلى عقر ديارنا، نجد أنَّ رسول الله تحرَّك حركةً مسبقة، لم يبقَ هو والمسلمون معه، الذين استجابوا له، في المدينة، ويقررون أن يجلسوا حتى يأتي العدو، وحتى يهجم العدو، وحتى يدخل إلى ديارهم وبيوتهم، ثم يوافقون على التحرك.
تربية الإسلام، وهدي الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”، يربي الأمة إلى أن تكون هي مبادرة، وسبَّاقة، وتتحرك لمواجهة الخطر قبل أن يدهمها الخطر، فتتحرك حركةً مسبقة في التصدي للأعداء؛ ولهذا نجد أنَّ رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” أمره الله بالخروج، وخرج، وتحرَّك بمن استجاب له من المسلمين، مع أنَّ البعض منهم كانوا كارهين للخروج في تلك الظروف؛ نظراً للوضعية الصعبة التي يعاني منها المسلمون، كانوا في ظروف صعبة على المستوى الاقتصادي، كانوا في واقع صعب مقارنة فيما بينهم وبين إمكانات وظروف أعدائهم، الأعداء يحيطون بهم من كل مكان، وهم أتوا بالرسالة الإلهية ليتحركوا في ظل ظروفٍ وبيئةٍ معادية، ومحاربة، وغير متقبِّلة للإسلام، فهم في ظروف صعبة، وعزلة كبيرة، ومعاناة شديدة، وإمكانيات- كذلك- متواضعة، فكانوا من حيث الإمكانات، من حيث العدد، من حيث العدة، في ظروف صعبة جداً، وبالمقارنة مع واقع أعدائهم: أعداؤهم لديهم الإمكانات الضخمة على المستوى العسكري، على المستوى المادي، ولديهم العدد والعدة؛ ولذلك كان البعض قلقين جداً من التَّحرُّك في خروج النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، إلى درجة قال عنهم: {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ}[الأنفال: من الآية6]، يعني: البعض كان فاقداً لأمله بالنصر، يرى النصر أمام تلك الظروف، وفي ظل تلك الوضعية الصعبة، والإمكانات المتواضعة، وكأنه شيءٌ من المستحيلات، وكأن ذلك الخروج نتيجته الحتمية هي الانتهاء بالموت، كأنه انتحار كما يقولون، انتحار وخروج لا يمكن أن يعود بنجاحٍ وظفرٍ ونصر.
رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” بالرغم من كل ذلك تحرك، بالظروف الصعبة، مع قلة العدد والعدة، مع الإمكانات المحدودة جداً، ولم يقبل بتلك الاعتراضات، أتى الأمر من الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”؛ ولذلك لم يقبل باعتراض من اعترض، ولم يتقبَّل مساعي من حاولوا اقناعه بعدم التحرك والخروج، ولا اكترث أيضاً للآخرين: للمنافقين والذين في قلوبهم مرض، الذين سعوا بالإرجاف، والتهويل، والتخويف، {إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[الأنفال: الآية49].
من جانبٍ آخر أيضاً: بلغ الخبر إلى المشركين في مكة، أنَّ رسول الله “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” بدأ بالتحرك من المدينة، ومن معه من المسلمين؛ لاستهداف تلك القافلة، وهم من الجهة الأخرى قاموا بالخروج، وأعدوا العدة، وحشدوا إمكاناتهم، وتحركوا عسكرياً، بقوة عسكرية من مكة؛ لاستهداف النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، خرجوا جيشاً قريباً من الألف مقاتل، ومعهم إمكانيات ضخمة، البعض منهم يمتلك سيفين، ودرعين، وساقوا معهم العدد الكبير من الإبل، وكذلك كان معهم العدد الضخم من الفرسان، فكانوا يمتلكون الخيول، التي هي ذات أهمية كبيرة في القتال آنذاك، خرجوا كما قال الله عنهم: {بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ}[الأنفال: من الآية47]، هم اعتبروها فرصة أصلاً، اعتبروها فرصةً للخروج لتحقيق هدفين بالنسبة لهم:
الهدف الأول: ما كانوا يتوقَّعونه ويظنونه هم، من أنهم سيتمكنون من القضاء على النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، ومن معه من المسلمين.
والهدف الثاني: أن يعززوا بذلك من نفوذهم، وهيبتهم، وتأثيرهم في بقية الجزيرة العربية، وأمام بقية القبائل العربية.
فخرجوا بطراً، استعراض بما لديهم من إمكانات ضخمة مادية، لديهم أموال، خرجوا ولديهم مظاهر تلك الثروة، والإمكانات، والسلاح، والعتاد، والعُدة، والعدد، وأمام الناس كذلك كما قلنا، ومهمتهم التي يركِّزون عليها هي: الصد عن سبيل الله.
ما هي مشكلتهم مع النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ”، ومن معه من المسلمين؟ مشكلتهم هي في الإسلام، هم يَصُدُّون عن سبيل الله، يسعون إلى إطفاء نور الله، يحاولون أن يعملوا على إنهاء الإسلام، ووأد هذا المشروع الإلهي؛ كي لا يظهر في الساحة أبداً، ولا تقوم له قائمة أبداً، فمشكلتهم كانت هي الصد، وهدفهم ومشكلتهم مع النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” ومن معه من المسلمين هي هذه.
أصبح هناك تحرُّك من جهة النبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” ومن معه، من الذين استجابوا له من المسلمين، وَتَحَرُّك من مكة: جيش المشركين الذي قد خرج بإمكاناته، وعتاده، وعُدَّته، والقافلة التي كانت تتحرك أيضاً باتجاه مكة.
في تلك الظروف نفسها، والرسول يتحرك بمن معه من المسلمين، أتى الوعد من الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” للمسلمين: بالتمكين من إحدى الطائفتين؛ فذلك الخروج خروجٌ منتصرٌ حتماً، وسيحقق نتيجةً بوعد الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”، نتيجة مهمة للمسلمين، ولكن لا تزال في البداية مجهولة بالنسبة للمسلمين، ما الذي سيتحقق لهم؟ لأن الله وعدهم إحدى الطائفتين:
إمَّا القافلة العائدة بالأموال التجارية، التي خُصِّصت لتمويل هجوم على المسلمين.
وإمَّا الجيش العسكري، الذي قد خرج من مكة.
يقول الله “جَلَّ شَأنُهُ”: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ}[الأنفال: من الآية7]، كانت الرغبة النفسية لدى المسلمين، هي: أن يتمكنوا من القافلة؛ ليستفيدوا منها مادياً، وليتفادوا الاصطدام العسكري والقتال، يعني: لم تكن عندهم رغبة بالقتال، هم يريدون نصراً بارداً، ليس فيه قتال، وأن يتفادوا الاصطدام والقتال العسكري، ويريدون أن يستفيدوا من القافلة تلك، من إمكانياتها المادية؛ نظراً لما هم فيه من ظروف صعبة جداً، وإمكانية الاستفادة من تلك الأموال أيضاً، في تطوير وتوفير متطلبات يحتاجون إليها حتى في الصراع العسكري؛ فكانت الرغبة شيئاً، ولكن التدبير الإلهي كان لشيءٍ آخر.
فيقول الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”: {وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ}[الأنفال: 7-8]، النتائج الأكثر أهمية، والتي لها تأثير مهم جداً للإسلام والمسلمين، هي: بالتمكين من الجيش العسكري، وإحراز نصرٍ عسكري، هذا الذي ستكون له نتائج مهمة، أكثر أهمية بكثير من أن يظفروا بالقافلة، وأن يتمكنوا من القافلة العائدة بالمال، وهذا درسٌ للمسلمين، فيما يتعلق بالخيارات والأهداف الأكثر أهمية، وذات التأثير الأكثر أهمية أيضاً في واقعهم؛ ولذلك اتَّجه الطرفان وقد فاتت القافلة بعد ذلك، فاتت القافلة، وأصبح الخيار واضحاً أنه سيكون هناك صدام عسكري، وهناك وعد مسبق من الله، وعدٌ مسبقٌ للمسلمين وعدهم الله به.
وصل الطرفان: جيش المشركين الذي خرج من مكة، والنبي “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ” ومن معه من المسلمين، الذين كانوا اتَّجهوا من المدينة، وكانوا يسعون إلى اللحاق بتلك القافلة، وصل الطرفان إلى بدر، موقع بين مكة والمدينة، فيه بئر ووادٍ هناك، كل طرف وصل إلى الجهة المحاذية له، جيش المشركين وصل في الجهة التي هي إلى مكة، محاذية لهم، والمسلمون وصلوا في الجهة من الوادي التي هي الأقرب إلى المدينة، محاذيةً لهم؛ ولهذا يقول الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”: {إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ}[الأنفال: الآية42].
أتت التهيئة من الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” لالتقاء المسلمين بالجيش العسكري، بالقوة العسكرية التي خرجت لقتالهم من مكة، وعندما وصلوا هناك إلى بدر في اليوم الأول، قبل اليوم الذي وقعت فيه غزوة بدرٍ الواقعة، كانوا على المستوى الجغرافي في انتشارهم وفق ما ورد في الآية المباركة: أولئك في الجَنَبَة من الوادي المحاذية لهم، والمسلمون في الجَنَبَة الأخرى، التي هي باتجاه المدينة، ومن تلك اللحظة أصبح واضحاً أنه سيكون هناك قتال، واصطدام عسكري، وأنَّ المسلمون سيخوضون هذه المعركة، التي كان الكثير منهم لا يرغب أصلاً في أن يخوضها، بالنظر إلى حالهم، وظروفهم، وقلة عددهم، وقلة إمكاناتهم، فكانت حالة القلق من نتائج تلك المعركة مؤثِّرة على الكثير منهم، ولكن الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” أمدهم بما هيَّأهم حتى ما قبل المعركة.
في اليوم الأول، وقبل أن يأتي اليوم الثاني، الذي وقعت فيه المعركة، يقول الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[الأنفال: 9-10]، هم التجأوا إلى الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”، وهذه مسألة مهمة جداً: في كل أحوال الإنسان المسلم، في ظروف الجهاد في سبيل الله، وفي مواجهة كل التحديات والأخطار، عليه أن يلتجئ إلى الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى”، وأن يستغيث بالله “جَلَّ شَأنُهُ”، والله استجاب لهم، ووعدهم هذا الوعد: استجاب لهم، ووعدهم بأن يمدهم بعدد كبير من ملائكته: {بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ}، والهدف من دور الملائكة “عَلَيْهِمُ السَّلَام”، ومن هذا العدد، وهذا التعزيز والمدد الذي سيأتي من ملائكة الله: ما سيقومون به من دورٍ مهمٍ جداً:
على مستوى رفع الروح المعنوية:
فتواجدهم بين المسلمين سيضفي حالة السكينة، ولديهم طريقتهم هم في رفع الشعور المعنوي لدى المسلمين، فتكون الحالة المعنوية حالة مرتفعة، وأهم ما يحتاج إليه المقاتل في الميدان هو: الروح المعنوية، وفي مقدِّمة العوامل الأساسية للانتصار: الروح المعنوية، إذا كانت عالية؛ فلها أهميتها الكبيرة جداً على مستوى الثبات، على مستوى الأداء القتالي، ثم وصولاً إلى النتائج المهمة للمعركة.
التأثير أيضاً في نفوس الأعداء، التأثير من جوانب متعددة:
مهمة الملائكة الذين أنزلهم الله “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” مدداً لعباده المؤمنين في معركة بدر، لم تكن ليقوموا بالقتال نيابةً وبدلاً عن المسلمين؛ ليبقى المسلمون جالسين وقاعدين، وأولئك يقاتلون بدلاً عنهم، بل كانت المهمة في القتال للمسلمين، عليهم أن يؤدوا هذا الدور، وهذه المهمة، ولكن الملائكة هم إسناد معنوي من جهة، يسندهم على مستوى الروح المعنوية من جهة، وهناك أيضاً تأثيرات أخرى، تأثيرات على مستوى الأداء، على مستوى الفاعلية، زيادة مستوى الفاعلية في أداء المسلمين، وكذلك في التأثير على نفسيات الأعداء، فكان هذا من التأييد الإلهي المهم جداً، والذي يعد الله به المؤمنين، ليس فقط في تلك الغزوة، أو في تلك المعركة، هذا وعدٌ مفتوحٌ لعباد الله المؤمنين، الذين يتحركون حركة الإسلام في رسالته، في أهدافه، في تعليماته، في تشريعاته.
أيضاً كان مما أمد الله المسلمين به تلك الليلة، ليلة صبح الواقعة: النعاس، قال “جَلَّ شَأنُهُ”: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ}[الأنفال: من الآية11]، وهو يدل على حالة السكينة والاطمئنان التي منحهم الله إيَّاها؛ لدرجة أن يصيبهم النعاس، والنعاس هو بداية النوم، أو النوم الخفيف الذي يحصل للإنسان، وكان بدرجة لا يخرجون بها عن حالة الانتباه واليقظة، وفي نفس الوقت يشعرون معها بالاطمئنان، والسكينة، والأثر الإيجابي على أعصابهم، وعلى نفسياتهم.
{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ}[الأنفال: من الآية11]، فكان ضمن المدد الإلهي أيضاً: المطر، الماء، وكانوا بحاجةٍ إلى الماء؛ لأن المشركين سبقوهم إلى البئر التي في تلك المنطقة، والمسلمون بحاجة إلى الماء للشرب، وبحاجة إلى الماء أيضاً للأرض، الأرض كانت رملية، وإذا لم يُلَبِّدهَا الماء؛ فستكون عملية القتال فيها صعبة؛ نظراً للوضع الرملي للمقاتل عندما تنغرز رجله بين الرمل، يصعب عليه سرعة الحركة، التنقل، الحركة القتالية التي تحتاج إلى خفة، إلى مبادرة، إلى سرعة انتقال… وغير ذلك، فالله هيَّأ لهم بالمطر:
أولاً على مستوى توفير حاجتهم من الماء، وهم عملوا حوضاً يجمع لهم الماء فيه.
وأيضاً من جانبٍ آخر: يغتسلون، يحسون بالنشاط، يرتاحون، يشعرون بالانتعاش والحيوية.
وكذلك أيضاً يستفيدون في تثبيت المنطقة الرملية التي يقاتلون عليها.
فنجد كيف كان التأييد الإلهي، والله وعد عباده المؤمنين بالتأييد، يأتي التأييد بأشكال كثيرة، مما يساعدهم على أداء مهمتهم، فنجد كيف حصلت تهيئة نفسية، وتهيئة- كذلك- في الواقع وفي الميدان، وكل هذا لمصلحة المسلمين.
نكتفي بهذا المقدار، ونستكمل- إن شاء الله- ما بقي في المحاضرة القادمة.
نَسْألُ اللَّهَ “سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى” أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاكُم لِمَا يُرْضِيهِ عَنَّا، وَأَنْ يَرْحَمَ شُهَدَاءَنَا الأَبْرَار، وَأَنْ يَشْفِيَ جَرْحَانَا، وَأَنْ يُفَرِّج عَنْ أَسرَانَا، وَأَنْ يَنْصُرَنَا بِنَصْرِه، إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاء.
وَالسَّـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ؛؛؛