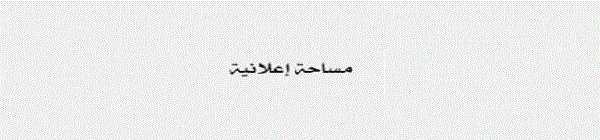مسارُ التطور الثقافي عند العرب “رؤيةٌ تحليلية ثقافية”
عبد الرحمن مراد
علينا أن ندرك أن المجتمعات الغربية في القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الميلادي كانت تعاني من أزمات وجودية ومن حروب وصراعات مدمّـرة وقاتلة تماماً كالذي يحدث عندنا اليوم، ومثل هذه المقارنة الذهنية تقول إن العرب والمسلمين يعيشون أزمنة تجاوزها المجتمع الإنساني منذ قرون، واستطاع من خلال مفكريه الكبار أن يبدعوا واقعاً جديدًا لينعم بقدرٍ من الهدوء والاستقرار من خلال التأكيد على الاحتياجات البيولوجية والسيكولوجية للإنسان، وتحقيق القدر اللازم من الأمن النفسي والاجتماعي، وهي حاجات لم يكن القرآن بغافلٍ عنها، ولا المنهج المحمدي من خلال تأكيدهما على خاصية الأمن من الخوف، والأمن من الجوع.
فما الذي يحدث في المجتمعات العربية؟
الذي يحدث في المجتمعات العربية -كما هو معلوم لكل ذي لُب أَو بصيرة- هو الامتثال للنص، وتعطيل خاصية التفكير والابتكار، وبسبب ذلك شاعت الاشتراكية في المجتمعات كقيمة كلية نصية غير قابلة للتجزئة، وفي مقابلها شاعت الحركات الدينية كاجترار تاريخي نصي غير قابل للحوار مع المستويات الحضارية الجديدة، ونشأت فكرة القومية العربية رفضاً لثنائية الهيمنة والخضوع، على وفق ذلك دارت حركة المجتمع وتوازنه في حالة اغتراب زماني ومكاني وثقافي وحضاري، فهي لم تلبِ الاحتياجات للإنسان، فالعدالة الاجتماعية عند قوى اليسار الاشتراكي كانت شعاراً لم يتجاوز شكليته؛ بهَدفِ الوصول إلى السلطة، وليس أكثر من ذلك، والقومية العربية لم تتجاوز مفرداتها، ومثل ذلك ينزاح إلى “الإخوان المسلمين” الذين دارت شعاراتهم في مربعات حاكمية الله في الأرض، ولم يصلوا إليها، وصلاح الأُمَّــة في هذا الزمان لا يتحقّق إلا وفق المقاسات الأولى للدعوة الإسلامية في زمنها القديم -كما ورد في أدبياتهم-، وتبعاً لذلك كان الصراع هو ديدن المجتمع العربي الإسلامي، لم يبتكر جديدًا واستسلم للفوارق الحضارية في مستوياتها المتعددة، وهو يستجر النظريات اللغوية والثقافية والاجتماعية والعلمية من الغرب بعد أن كان مصدراً لها ومبتكراً لكل تموجاتها، وكلّ الدراسات الحديثة تؤكّـد أن ملهم الغرب في الوصول إلى المستويات الحضارية كان ابن رشد وغيره من العلماء الذين أخذوا العلوم من اليونان والإغريق ثم أضافوا وابتكروا وساهموا في صناعة واقع جديد في حياة البشرية جمعاء.
وبالقفز على كُـلّ الأزمنة والتطورات التي حدثت في المجتمعات وُصُـولاً إلى الحالة اليمنية التي لم تكن بِمَنْأىً عن ضلال ما سلف بيانه، فالاشتراكية التي حكمت في الجنوب (23) عاماً (67-90م) عملت على تعطيل القدرات والإمْكَانات، وساهمت في ترميد حركة المجتمع، وكانت تخوض صراعاً مع الجماعات الدينية بشقيها السلفي وَالإخواني، والصراع بين تلك القوى لم يتجاوز الشعارات، ولذلك رأينا كيف تلاشت الحركة الاشتراكية إلى درجة فقدان التأثير والفاعلية الذي كانت عليه في النصف الثاني من القرن العشرين، ومثلها الحركة القومية، ولم يعد لهما من وجود يذكر حين القياس على الواقع اليوم، وها هي حركة الإخوان تعلن عن غروبها بعد أن أصبح شعارها شعاراً قاتلاً لا يحمل الخيرية للبشرية، وقد وصلت ذروة نكوصها باشتغالها على التفجيرات وممارسة الإرهاب الذي يهدّد الإنسانية جمعاء بالفناء والعدمية، ولم تكن هذه النتيجة بدون مقدمات منطقية ساهمت الأجهزة الاستخبارية العالمية في صياغتها بطريقتها حتى تستمر مصالحها في المجتمعات التي كانت تخضع لسلطتها الاستعمارية في القرن العشرين وما قبله.
ووفقاً لحركة التاريخ، نرى أن المجتمعات الحية والفاعلة في حركة المجتمع التاريخية تفرز واقعاً جديدًا كما تقتضيه حركة التدافع بين الخير والشر، والفساد والإصلاح وفق التعبير القرآني والإسلامي، وقد جاءت حركة أنصار الله كنتيجة منطقية وَطبيعية لمقدماتها التي بدأت عند مطلع الألفية وبالتحديد منذ الحرب الأولى على صعدة عام2004م وُصُـولاً إلى حالة تفجر الحدث في عام 2011م، وحركة أنصار الله كانت هي التعبير الأمثل عن القوة الجديدة، والقوة المستضعفة التي جاءت وفق سنن الله في كونه من حَيثُ المظلومية والاستضعاف، ومن حَيثُ تحقيق وعد الله بنصره وتأييده وبالتمكين لهم في الأرض، وهذه الحركة ترى في القرآن الكريم منهجاً ونظريةً يمكن السير في طريقه للخروج من المسالك المظلمة، وهي محقة في ذلك، فقد كانت سورة الأعراف تحمل مقاصد الله من خلال سرد متواليات الحدث، وبيان انحرافه عن مقاصد الله، ووجوب عقوبته، ولذلك قالت سورة الأعراف بشكل مجمل بحاجات الإنسان ومقاصد الله، وتحدثت عن العقوبات التي أنزلها على الأمم؛ بسَببِ فقدان المعيارية الأخلاقية من الحق والعدل والوجود والحرية، وبيان ذلك في سياق السورة ليس خافياً على كُـلّ ذي لب.
وقد قيل أن “دخول الغد يستدعي جِدّة نفوس الداخلين فيه وقدرة تجديده، وتجديد نفوسهم معه، حتى لا يصبح ماضياً، ومن هنا تدل الظواهر والأعمال على أن مجتمعنا إلى الآن يتحَرّك بين زمن مستحيل الرجوع، وبين آتٍ غير ممكن الإتيان إلى الآن، هذا ما تنبئ عنه دلائل اليوم إلا أن الآتي ممكن الميلاد، كما أن الماضي مستحيل الانبعاث؛ لأَنَّ لكل زمن عمل، وحيوية كُـلّ عمل أن تدفعه أفكار حياتية وتقوده أفكار حياتية، على أن يولي اهتماماً مضاعفاً بالقدرات الذهنية والإبداعية والابتكارية؛ لأَنَّها هي من تصنع الأفكار الحياتية وتقودها؛ فالهُــوِيَّة الثقافية اليمنية محرومة من الفلسفة، وإن كانت قامت على أصول مختلفة من الفكر، إلا أنها في ملامحها العامة تشكلت من النزوع الديني والحس الوطني، ومحاولة المزج بين ما كان وبين ما جدّ على العصر، والملاحظ أن غموض المرحلة زاد من غموض الفكرة، غير أن مكوناتها الأولى تصلح أَسَاساً؛ لأَنَّها بذرة حية قابلة للنمو؛ ولأن نشأتها واكبت الشكل الاجتماعي اليمني الذي يمتاز ببطء الحركة.
وعند موضوع الهُــوِيَّة اليمنية تدور الرحى اليوم؛ فهي المسبب وهي المانع فثمة مجتمعات نجت؛ بسَببِ تماسك هُــوِيَّتها من التنازع كمصر مثلاً وأُخرى وقعت في دائرة الولاءات كاليمن؛ فكان التشظي والتقاسم من نصيبها كما نشهد واقع الحال في المحافظات الجنوبية وفي تعز ومأرب.