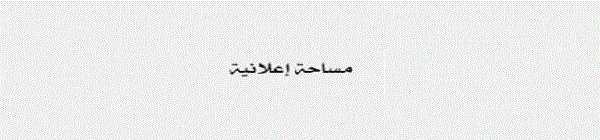نص المحاضرة الرمضانية السابعة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي
يمانيون/ متابعات
نص المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 8 رمضان 1444هـ – 30 مارس 2023م:
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُوْلُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّين.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وارضَ اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُنتَجَبين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَالمُجَاهِدِين.
الَّلهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وَتُبْ عَليَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمْ.
أَيُّهَــــا الإِخْــــوَةُ وَالأَخَوَات: السَّــلَامُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُــه؛؛؛
يقول الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” في القرآن الكريم: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}[البقرة: الآية185]، من مميزات شهر رمضان المبارك على بقية الشهور: أنه الشهر الذي أنزل الله فيه كتابه الكريم (القرآن العظيم)، وهذا يدل على:
عظمة وفضل هذا الشهر، بهذه المناسبة العظيمة، أنه شهر نزول القرآن.
كما يدل أيضًا على الصلة الوثيقة، ما بين فريضة الصيام في هدفها التربوي المهم: التربية على التقوى، والعلاقة بالقرآن الكريم، والصلة بين ذلك لتحقيق التقوى نفسها.
الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” قال عن القرآن الكريم: {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}[البقرة: من الآية 2]، فمع التربية على قوة الإرادة، والعزم، والصبر، والتحمل، والالتزام، هناك المنهج، الذي يرتبط به المتقون، يتحركون على أساسه، يعملون به، يهتدون به، في مواقفهم، في أعمالهم، في مسيرتهم في الحياة: هو القرآن الكريم، وبذلك تتحقق لهم التقوى، في كل ما تعنيه:
من وقايةٍ من عذاب الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”.
من وقايةٍ من سوء الأعمال السيئة، ونتائجها السيئة في واقع الحياة، إلى غير ذلك.
شهر رمضان فيه ليلة القدر، وهي بالتحديد: الليلة التي كان فيها نزول القرآن، كما قال الله “جَلَّ شَأنُهُ”: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}[الفجر: 1-5]، وهي ليلةٌ عظيمة الشأن، ليلةٌ ترتبط بالتدبير الإلهي، لشؤون العباد، على مستوى شؤونهم التفصيلية في العام الآتي، ولهذا يتضح لنا الصلة، صلة القرآن الكريم، بشؤون حياتنا، بتدبير أمورنا، وأنه يأتي ضمن تدبير الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” لشؤون عباده، كما قال “جَلَّ شَأنُهُ”: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}[الدخان: 3-6]، فالقرآن الكريم نزل في ليلة القدر رحمةً من الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” لعباده، وهدايةً لهم، وإنقاذًا لهم، ودلالةً لهم على طريق نجاتهم، وفلاحهم، وفوزهم، وسعادتهم، في الدنيا والآخرة، فهو نعمةٌ من الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”.
والقرآن الكريم كتابٌ عظيم الشأن، أول ما يلفتنا إلى عظمته، ويدلنا على أهميته: أنه كتاب الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، مِن علمه، وحكمته، ورحمته، ليس كتابًا ألَّفه شخصٌ ما هنا أو هناك، ولا حتى نبيٌ من الأنبياء، ولا حتى ملكٌ من الملائكة، بل هو من الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، والله “جَلَّ شَأنُهُ” ينبهنا على هذا في القرآن الكريم؛ ليلفتنا إلى أهميته، إلى عظمة شأنه، قال “جَلَّ شَأنُهُ” ليخاطب نبيه “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ”: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاً}[ الإنسان: الآية23]، فهو من الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، الذي أنزله على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه محمد “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ”، وقال “جَلَّ شَأنُهُ”: {تَنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى}[طه: الآية4]، فاذا أردنا أن نستوعب– ولو إلى حدٍ ما- عظمة القرآن، شأنه المهم والكبير، فلنتذكر أنه من الله، من الله ربِّ السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، ربِّ العالمين، ملك الناس، الذي له ما في السماوات وما في الأرض بكله، خالقِ هذا الكون، المترامي الأطراف، بكل ما فيه، من نجوم، وكواكب، وعوالم، الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” عظيم الشأن، الرب والإله، الذي خلق كل هذا العالم، الذي خلقنا جميعًا، وهو ربنا، وإليه مصيرنا، فالقرآن هو كتابه، كلماته، آياته، هدايته لعباده، كلما تذكرت عظمة الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، وتذكرت شواهد وتجليات ومظاهر عظمته، في هذا العالم الكبير، الشاسع، الفسيح، تدرك عظمة القرآن الكريم وأهميته.
وأيضًا يتصل به تدبيره، فكما هو هديه، نوره لعباده، وكذلك مِن علمه، ومِن حكمته، وبرحمته، يتصل به تدبيره، هو صلة بيننا وبين الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”.
طريقة تعاملنا مع القرآن الكريم، ومدى علاقتنا بالقرآن الكريم، يترتب عليها التعامل من الله معنا، فيما يكتبه لنا، أو علينا، يتصل بالتدبير لله، يتصل بملك الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، يرتبط بملكه وتدبيره لشؤون عباده، وهذا ما أكد عليه في القرآن الكريم، فالله “جَلَّ شَأنُهُ” عندما قال في القرآن الكريم، وهو يبين هذه الحقيقة: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى}[طه: 123-126]، الله “جَلَّ شَأنُهُ” يقول مخاطبًا لنبيه “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ”: {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً}[طه: 99-101].
مصيرك في الدنيا والآخرة، نجاتك وفلاحك، أو خسارتك وعذابك، يرتبط بطبيعة موقفك من هذا الكتاب، وعلاقتك به (بالقرآن الكريم)، فهو يتصل بتدبير الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، ويرتبط به الجزاء في الاتجاهين، في عظمة القرآن الكريم: ما احتواه من النور، والهداية لعباد الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، فهو كتاب هدايةٍ لهم، كما قال عنه: {هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ }، يدلنا، ويرشدنا، ويفهمنا، ويعلمنا إلى الخير، إلى الحق، إلى الحكمة، إلى ما فيه فلاحنا، نجاتنا، صلاحنا، وصلاح حياتنا، والمصلحة الحقيقية لنا، والخير لنا، يدلنا على ذلك، بكل ثقة، وبكل اطمئنان، ننظر إليه؛ لأنه كتاب هدايةٍ وحقٍ، ليس فيه أي شيء على سبيل الخطأ، أو يخطئ في ما يدل عليه، أو يزيغ بنا فيما يدل عليه، أو يهدي إليه، أو يرشد عليه، فيكون خاطئًا، هو كله حق، {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}[فصلت: من الآية42]، هدايته هدايةٌ حقيقية؛ لأنه من الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، قال عنه: {قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}[الفرقان: الآية6].
الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” يعلم بكل شيء، {هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ}[الحشر: من الآية22]، المحيط بِكُلِّ شيءٍ عِلمًا، من لا تخفى عليه خافية، ولذلك في هدايته في القرآن الكريم هو يهدي بعلم، وهو العليم بكل شيء، كما قال: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[البقرة: من الآية29]، يعلم بكل شيءٍ في هذا العالم، يعلم بكل ما خفي عنا، يعلم الغيب والشهادة، يحيط بكل شيءٍ علمًا، فهو يهدي بعلم، وهو يهدي أيضًا وهو المدبر لشؤون السماوات والأرض، وشؤون العباد، وهو الذي سَنَّ سُنن هذه الحياة، في كل ما يترتب على الواقع فيها، على التصرفات فيها، على الأعمال فيها، على المواقف فيها، من نتائج، ومن آثار، والمدبر لكل شؤونها بشكلٍ عام.
فالله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” يهدي بعلم، ويهدي وهو المدبر، وهو الذي يتدخل في شؤون هذا العالم، وهو الحي القيوم، فالقرآن الكريم كتابه، وهو الملك، المدبر، المهيمن على هذا العالم، ولذلك يأتي في القرآن الكريم الوعد والوعيد بكثرة، ويتصل بواقعنا، وبظروف حياتنا، وبطبيعة علاقتنا بكتاب الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”.
من عظمة القرآن الكريم: أنه المعجزة الخالدة، هو المعجزة الكبرى لنبينا “صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ”، الشاهدة على صدق نبوته، صدق رسالته، وأن الله أرسله إلى الناس، هو المعجزة الكبرى، وجعلها الله معجزةً خالدة، وليست كبعض المعجزات التي حدثت في وقتها، بقيَ ذكرها، بقيَ أثرها، لكن بالنسبة للقرآن الكريم هو باقٍ بنفسه، باقٍ على مدى الأجيال، وإلى يوم القيامة، فهو المعجزة الخالدة، الآية الكبرى الشاهدة على نبوة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين “صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ”.
وهو في إعجازه له شأنٌ عظيم، ويرتبط ذلك أيضًا بجانب الهداية للناس، نفس إعجازه فيه هدايةٍ للناس إلى طريق الحق، ولذلك يقول الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}[الإسراء: الآية88]، فإعجازه فيه أيضًا علاقةٌ بكمال هذا الكتاب، بهدايته الواسعة، بإحكامه، إحكام آياته، وما فيه من النور، والهدى، والمعارف الواسعة جدًا، التي تفوق كل تصورنا، والتي عبَّر عنها في القرآن كريم، في قول الله “جَلَّ شَأنُهُ”: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}[الكهف: الآية109].
هو أيضًا محتوى الرسالة الإلهية، وفيه خلاصة الكتب الإلهية، ولذلك هو كتاب مهيمنٌ على ما سبقه من كتب الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، هو مصدق، ومهيمن، على ما سبقه من كتب الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، وبقي محفوظًا مصونًا في نصه لكل الأجيال، وهذا أيضًا يرتبط بجانب الإعجاز فيه، عندما قال الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر: الآية9]، حفظه الله في نصه، فلم يحرَّف نصُه، وبقي متوارَثًا بين الأجيال، وحفظه الله في وجوده، ليبقى موجودًا بين المجتمع البشري، وبين المسلمين، جيلًا بعد جيل، وهذه نعمةٌ كبيرة وآيةٌ عجيبة، ولها صلةٌ بإعجازه العظيم؛ لأن هناك حرب شرسة ضد القرآن من بداية نزوله، حربٌ ضده حتى في الدفع للناس بالكفر به، بالتحذير حتى من سماعه، {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ}[فصلت: من الآية26]، محاربةٌ لما يهدي إليه، لما يدل عليه، لما يدعو إليه، محاربة شرسة جدًا، ولكن مع ذلك يستمر وجوده، انزعاجٌ شديدٌ منه؛ لأن أهل الباطل، أهل الضلال، فئات الكفر بكلها، ترى فيه أكبر مشكلةٍ أمامها، هي عجزت عن إبطاله، عجزت عن القضاء على أثره في الواقع، بقي أثره رُغمًا عنها، بقي أثره في الأجيال، بقي نوره، بقيت بركاتُه، فهي في ضعف في محاربته، وهي تحاربه بكل شدة، وهي منزعجةٌ منه غاية الانزعاج.
فالقرآن الكريم له عظمته وشأنه الكبير، يبين الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” أهميته، وقدسيته، ومنزلته الرفيعة، حتى في أوساط الملائكة، {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ }[عبس: 13-16]، له قدسيته العظيمة، وشأنه العظيم، حتى بين أوساط الملائكة، وهم الأكثر معرفةً بقدسيته، وعظمة شأنه، والأكثر إجلالًا له، وتقديرًا له.
ولذلك من شأن الإنسان المؤمن، وحتى عندما يقرأ القرآن هو يتعرف أكثر وأكثر على عظمة القرآن، وعلى أهمية القرآن، وقدسية القرآن، وعلو شأن القرآن، وأنه أقدس المقدسات في هذه الأرض، هذا يؤسس لصلةٍ وثيقةٍ، وعلاقةٍ قويةٍ، بين الإنسان المؤمن، وبين القرآن الكريم.
القرآن الكريم، مع علو شأنه وعظمته بكل تلك الاعتبارات، هو فيما يعني لنا: هو كتاب الهداية والنور، الذي نهتدي به، الذي ينقذنا من الضلال، لا نجاة لنا من الضلال، والضياع إلا بالقرآن الكريم، فالإنسان بدون القرآن الكريم، بدون هديه ونوره، سيمتلئ بالضلال، وما أكثر الضلال، وما أكثر الجهات المصدِّرة للضلال، والمروِّجة للضلال، والتي تنشر الضلال، الضلال في كل شيء:
في المفاهيم الدينية.
في الوعي.
في النظرة إلى هذه الحياة.
في المواقف.
في كل شيء، الضلال له جهات كثيرة تصدّره، تسعى لنشره، تسعى للإقناع به، تهدف من خلال ذلك إلى السيطرة على الناس، من وراء إضلالهم، والسيطرة عليهم، بعد السيطرة عليهم فكريًا وثقافيًا، وفي الرؤى والمفاهيم.
فالقرآن الكريم كتاب هداية، يهدينا إلى الحق، يهدينا إلى الحقيقة، يهدينا إلى ما فيه الخير، والفلاح، والرشاد، والفوز، والنجاة، والسعادة، ويُحصِّننا من الضلال، وهذا من أهم ما يتعلق بدور القرآن الكريم، أنه كتاب هداية، {هُدًى لِلنَّاسِ}، الناس بحاجةٍ إلى الاهتداء به، إذا لم يهتدوا به، فالبديل عن ذلك هو الضلال، بكل ما يترتب على الضلال من آثار سيئة، في هذه الحياة الدنيا، وفي الآخرة.
في جهنم أكبر عامل أوصلهم، هو العامل الرئيسي الذي أوصلهم إلى جهنم: هو الضلال، وهم هناك يصيحون في النار من الضلال، ومن المضلين، يقولون في نار جهنم: {رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ}[فصلت: من الآية 29].
القرآن الكريم هو النور، الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” قال: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ }[المائدة: من الآية 15]، قال عنه مخاطبًا لنبيه “صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ”: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُـمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ}[إبراهيم: من الآية 1].
كل بديلٍ عن القرآن الكريم، وكل ما يخالف القرآن الكريم، هو ظلمات، أفكار ظلامية، أفكار تحجب الإنسان عن معرفة الحق، عن معرفة الحقيقة، عن معرفة طريق النجاة، طريق الفلاح، الصراط المستقيم، الموصل إلى الغايات العظيمة، والأهداف الكبيرة، التي بها فلاح الإنسان، وفوزه، ونجاته، في الدنيا و الآخرة، فالبديل عنه هو الظلام، والظلاميون، الضالون، المبطلون، هم يعملون على إبعاد الناس عن الاهتداء بالقرآن الكريم، وعن الاستنارة بنوره، والتأثير عليهم ببدائل مخالفة للقرآن الكريم، من المفاهيم، والرؤى، والثقافات، والاعتقادات، والتصورات، والمواقف، وغير ذلك، يحاولون أن يسيروا بهم في هذه الحياة بمنأى عن القرآن الكريم، أن يبقى القرآن هناك، في أكثر الأحوال تبقى الصلة به صلة قراءة عادية، تلاوة عادية، لكن بعيدًا عن الاهتداء به، عن الاتِّباع له، عن التمسك به، عن التثقف بثقافته، عن الاستنارة بنوره.
لا تتحقق التقوى إلا بالتمسك بالقرآن، والاهتداء بالقرآن، والتحرك على أساس القرآن، والارتباط به في مسيرة الحياة، ولهذا يقول الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” عن القرآن: {هُدًى لِلْـمُتَّقِينَ}، هم يهتدون به؛ ولذلك، عقائدهم، أفكارهم، ثقافتهم، توجهاتهم، مواقفهم، تصوراتهم، كلها مقتبسةٌ من القرآن الكريم، يرجعون فيها، يرجعون بشأنها كلها إلى القرآن الكريم، هذا هو حال المتقين، حال المتقين، صلتهم بالقرآن، وارتباطهم بالقرآن، وتمسكهم بالقرآن، هو إلى هذا المستوى: إلى مستوى الاهتداء به، والاستنارة بنوره، والرجوع إليه، والتثقف بثقافته، فهم قرآنيون في ثقافتهم، في مفاهيمهم، في عقائدهم، صلتهم بالقرآن الكريم صلةٌ وثيقة.
القرآن الكريم في أثره التربوي، نعمةٌ كبيرة، ولا مثيل له أبدًا، والإنسان يحتاج إلى تزكية نفسه، الإنسان لكثرة ما يتعرض له من مؤثرات، تؤثر عليه في نفسيته، وفي زكاء نفسه، وفي أخلاقه، وفي سموه، وفي إنسانيته، بحاجة ملحة إلى ما يساعده على التزكية، على السمو الروحي والأخلاقي، والارتقاء الأخلاقي، وعلى تطهير نفسيته، فالقرآن الكريم جعله الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” كما قال عنه: (شِفَاءٌ)، هُوَ شِفَاءٌ، {وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ}[الإسراء: من الآية82]، له أثره العظيم، في تزكية النفس، في شفاء القلب، من كل العلل السلبية، التي تُؤثر على إنسانية الإنسان، على أخلاقه، على سمو روحه، على طهارة نفسه، طهارة مشاعره، طهارة وجدانه، يخلصك من المساوئ والمؤثرات السلبية، التي تؤثر سلبًا، تترك تأثيرًا سيئًا على أخلاقك، على نفسيتك، على روحك، وهذا من أهم ما نحتاجه، ومن أهم ما نستفيده من القرآن الكريم، هذا هو الشفاء في القرآن، يشفيك من الشك، يشفيك من كل أشكال المرض، المؤثرات السيئة، التي يسميها القرآن الكريم بالمرض؛ لأنها تبعد الإنسان عن الصحة النفسية، الصحة الأخلاقية، السلامة الأخلاقية والنفسية، تؤثر على نفسية الإنسان بالتأثيرات السيئة، فالقرآن الكريم: {هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ}.
له أثره العظيم في العلاقة بالله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، ولا مثيل له في ذلك، ليس هناك أي شيء يمكن أن يرتقي بنا في العلاقة بالله “جَلَّ شَأنُهُ”، العلاقة الإيمانية، كمثل القرآن الكريم، الله قال عنه: {لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[الحشر: الآية21]، قال عنه: {ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ}[الزمر: الآية23].
له الأثر الروحي، والوجداني الكبير، في الخشوع، في الإحساس بالقرب من الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، في السمو النفسي، تسمو نفس الإنسان، ترتقي، ترتقي عن المؤثرات السلبية، عن التوجهات السلبية، يحس الإنسان بقيمة العلاقة الإيمانية بالله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، بالأُنس بالله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، بالاطمئنان، الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” قال في القرآن الكريم: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}[الرعد: الآية28]، وذِكرُ الله أول ما فيه، وأعظم ما فيه، وأكبر ما فيه: هو القرآن الكريم، فهو يترك هذا الأثر من الاطمئنان في قلب الانسان، في مشاعره، فيتحرك في هذه الحياة، وفي أداء مسؤوليته في هذه الحياة، وهو مطمئِنّ النفس، مطمئنٌ بكل ما تعنيه الكلمة، مطمئنٌ إلى ما هو عليه، يتحرك بثبات، بثقة، ومطمئنٌ نفسيًا: في شعوره، في وجدانه، ليس في حالةٍ من الاضطراب الدائم، والتردد الدائم، والقلق الدائم، والتوتر الدائم، بل هو راضٍ بموقفه، بتوجهاته، مطمئِنّ إلى ما هو عليه، واثق، ومرتاح البال تجاه ما يقدم، وما يعمل، وما هو عليه، هو مرتاحٌ إلى ذلك، ويمنحه الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” الشعور بالأُنس به “جَلَّ شَأنُهُ”، وبالموقف الحق، والأُنس حتى بالقرآن الكريم نفسه، الأُنس بالذكر نفسه.
هذه الحالة الوجدانية من الخشوع لله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، في العلاقة بالقرآن الكريم، التي يصل إليها الإنسان المؤمن، إذا ارتقت علاقته بالقرآن، والتي هي إلى درجة اقشعرار الجلد من خشية الله، بالتأثر بآيات الله في القرآن الكريم، {تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ}[الزمر: من الآية23]، هي حالة راقية جدًا، والإنسان إذا أنطلق في مسيرة حياته بهذه الروح، الخاشعة لله، المطمئنة، الواثقة، هذه الروح التي تعيش حالة الأُنس بالله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”؛ ينطلق في مسيرة الحياة قويًا، وينطلق بثقة، وينطلق بثبات، وينطلق وهو يشعر بالأنس بالله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” حتى في أصعب الظروف، وأقسى المراحل، وفي مواجهة أكبر التحديات، لهذا أهمية كبيرة جدًا.
القرآن الكريم الذي هو كتاب الهداية، ومحتوى الرسالة الإلهية، وأساس النجاة والفلاح والفوز، والذي لابدَّ من الاهتداء به في تحقيق التقوى، كيف ينبغي أن تكون علاقتنا به؟
هي العلاقة الإيمانية، من واقع إيماننا به، إيماننا به بأنه كتاب الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، إيماننا بما يعنيه لنا، وما يترتب على ذلك، إيماننا بعظمته، بأهميته، بقدسيته، بما ذكره الله عنه وعن شأنه، ثم على المستوى العملي، على المستوى العملي، أن يكون لدينا اهتمام كبير بتلاوته، أولًا أن يكون هناك عناية بقراءته، أن يتعلم الإنسان القرآن، وإذا لم يكن متقنًا للقرآن الكريم في القراءة، فليسعى إلى أن يتقن قراءة القرآن، حتى لو كان قد تقدم به العمر، ليست مسألة تَعلُّم القرآن خاصةً بالأطفال والصبية، بل هي شاملة للجميع، أن يتعلم الإنسان القرآن، ولو كان قد أصبح كبيرًا في السن، ولو كان في مرحلة الشباب، أو قد تجاوز مرحلة الشباب، ليكون من ضمن اهتماماته: أن يسعى لإتقان قراءة القرآن الكريم، ثم أن يكون الإنسان مهتمًا بتلاوة القرآن.
في شهر رمضان عادةً ما يكون من أهم العبادات فيه: العناية بتلاوة القرآن، شهر رمضان هو ربيع القرآن، والقرآن هو ربيع القلوب، في شهر رمضان لا تفوتنا الفرصة، لأن الإنسان فيه عادةً ما يكون أكثر تأثرًا بالقرآن، وهذا شيءٌ ملموس، الإنسان يلحظه، أنه في شهر رمضان أكثر تأثرًا بالقرآن منه في بقية الشهور، فهي فرصة مهمة، لتلاوة القرآن، لسماع تلاوته، للتدبر لآياته، للاهتمام بثقافته، والتذكير منه، والتذكر به، هذه مسألة مهمة جدًا، ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم (قراءةً، أو سماعاً لتلاوته) مسألة أساسية في حياة الانسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية: أن يحرص ألَّا يفوته يومٌ واحد لا يقرأ فيه القرآن، أو يسمع فيه تلاوة القرآن، بإصغاء، وبإقبال، هذه مسألة مهمة جدًا، الإنسان بحاجةٍ إليها، بحاجةٍ إليها في:
مسألة الاهتداء بالقرآن.
والتأثر بالقرآن.
والتزكية للنفس.
والحفاظ على الروحية الإيمانية.
والانشداد إلى الله.
والتذكر لله “سُبحَانَهُ وَتعَالَى”.
ولهذا جعل الله “جَلَّ شَأنُهُ” من أهم ما في الصلاة، ومسألة إلزامية في الصلاة: قراءة القرآن، قراءة سورة الفاتحة، وقراءة قرآنٍ معها، جعلها من لوازم الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بذلك، كحالة إلزامية، إلزامية؛ حتى لا يعرض الانسان بشكلٍ تام، ويغفل تماماً عن القرآن الكريم، يبقى له شيءٌ إلزاميٌ، هو ذلك الذي في الصلاة، وفي خارج الصلاة علينا أن نكون مهتمين، ولذلك يقول الله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ}[المزمل: من الآية 20]، يقول “جَلَّ شَأنُهُ”: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[ الأعراف : الآية204]، يقول “جَلَّ شَأنُهُ”: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ}[فاطر: الآية29].
تلاوة القرآن كما هي مهمة لنا في الاهتداء به، في الحفاظ على الروحية الإيمانية، في التزكية لأنفسنا، في الشفاء لعللنا النفسية، والمؤثرات السلبية، هو قُربةٌ عظيمة الى الله، في تلاوته الأجر العظيم، الأجر الكبير من الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، ولهذا يقول هنا: { يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ }[ فاطر: من الآية 29]؛ ليبين فضيلة تلاوة القرآن، وأهمية تلاوة القرآن، وما يترتب على ذلك من الأجر العظيم؛ فهو من أعظم الأعمال قربةً إلى الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، والأجر على تلاوته أجرٌ عظيمٌ وكبير، ولذلك يقول: أمير المؤمنين عليٌّ “عَلَيْهِ السَّلَامُ”: ((وَمَا تَقَرَّبَ العِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثلِه))، يعني: قربة عظيمة جدًا، في تلاوته، في الاهتداء به، في الاتِّباع له، والإنسان إذا فرط في مسألة التلاوة، والصلة الوثيقة بالقرآن، في التلاوة، والاستماع للتلاوة؛ يتأثر سلباً، هذا شيءٌ حتمي يتأثر سلباً، في نفسيته، في مشاعره ووجدانه، وحتى على مستوى ثقافته، وفكره، وغير ذلك.
ومع التلاوة يحرص الإنسان على التدبر، ألَّا تكون تلاوة الغافلين، الذين يقرأون القرآن وهم حالة شرودٍ ذهنيٍ تام، لا ينتبه لما يقرأ، ولا يعلم ما يقول، ولا ينتبه إلى تلاوته، بل يحاول أن يركز بذهنه مع تلاوة القرآن الكريم، ويسعى لذلك، يسعى لذلك، ويستعين بالله على ذلك، الإنسان إذا تعود أن يقرأ القرآن مع الشرود الذهني، تصبح حالة يعتادها، كلما قرأ القرآن بدأ ينشغل ذهنياً بأشياء أخرى، ويشرد ذهنه نحو اهتمامات وتفاكير وانشغالات أخرى، وهي حالة خطيرة على الانسان، تبعده عن الانتفاع بالقرآن؛ لأن نفع القرآن عظيم، حتى من ظاهر ظاهر آياته، وليس فقط من عمقه، نفس التلاوة التي فيها تركيز الإنسان ينتفع بها، يستفيد منها، يفهم الكثير، يعرف الكثير، ينتفع بالكثير مما في الآيات المباركة، الله “جَلَّ شَأنُهُ” قال: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}[ ص: الآية29].
ثم أن نوطن أنفسنا على الاتِّباع للقرآن، مسؤوليتنا تجاه القرآن هي في الاتِّباع على مستوى العمل، على مستوى الموقف، على مستوى التوجهات، في مسيرة حياتنا أن نكون متبعين للقرآن، الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” قال عنه: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[ الأنعام: الآية155]، لننال رحمة الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، لنقي أنفسنا من عذاب الله، لابدَّ لنا من اتِّباع القرآن الكريم، في ساحة الحساب والجزاء، يحاسبنا الله ويجازينا على أساس علاقتنا بكتابه، {أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ}[المؤمنون: من الآية105]؟ هي الحجة التي يحتج الله بها علينا يوم القيامة، آياته، هديه، كتابه، فلذلك يجب أن نحرص على أن نكون متبعين للقرآن الكريم، وأن نسعى لاتِّباعه، والالتزام عملياً به، وهو كتابٌ عظيم الشأن، مبارك:
بركته فيما فيه من النور، والهدى، والمعارف، والعلوم العجيبة، والواسعة جدًا.
بركته في أثره في النفس، والحياة.
بركته في نتيجة الاتِّباع له، وما يحظى به من اتبعه، وتمسك به، من رعاية الله، ومعونته، ونصره، وتأييده، والخير الواسع الكبير.
ثم أن ندرك مخاطر الإعراض عن القرآن، أنها قضيةٌ خطيرةٌ جدًا علينا في الدنيا والآخرة:
في الدنيا: ضنك المعيشة، الشقاء، العناء الكبير (نفسيا، وفي الواقع).
أمَّا في الآخرة: فالنار والعياذ بالله، نار جهنم.
ولهذا يقول الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”: {وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا}[ طه: 99-101]، عندما يأتي يوم القيامة فتبعث، وتحشر، وأنت كنت من المعرضين عن القرآن، لم تُقبِل إليه، لم تهتد به، لم توطِّن نفسك على اتِّباعه، وتسعى عمليًا لاتِّباعه، كان لديك بدائل أخرى اتجهت إليها، انشغلت بها، اغتررت بها، وهي مخالفةٌ للقرآن الكريم، انحرفت بك عن نهجه؛ فالحال خطيرٌ عليك، وزرك ثقيل، وحملك سيء، يصل بك إلى قعر جهنم، لا يمكن لك الفوز ولا النجاة أبدًا، حالة خطيرة جدًا، فوزر الإعراض عن القرآن خطيرٌ جدًا على الإنسان:
على مستوى التوجه العام: عندما يكون توجهه بشكلٍ تام بعيدًا عن القرآن، لم يبنِ مسيرة حياته على أساس الاهتداء بالقرآن، والتمسك بالقرآن، والاتِّباع للقرآن، والتثقف بثقافة القرآن، والتحرك على أساسه، فهو بشكلٍ عام انصرف كليًا عن مسألة الاهتداء بالقرآن، هذه حالة خطيرة جدًا على الإنسان، حالة خسرانٍ وتوجهٌ يهلكه، يذهب به إلى نار جهنم، ليس هناك طريق بديل عن القرآن الكريم يوصلك إلى الجنة، يوصلك إلى رضوان الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”.
أو على المستوى التفصيلي والعملي: تجاه المواقف، تجاه الأعمال، الإنسان إذا أعرض عن القرآن في شيءٍ من ذلك، لم يلتفت إلى القرآن الكريم، فهذه حالة خطيرة جدًا، وعندما يُذكَّر بآيات الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، تجاه قضية معينة، أو موقف معين، أو عمل معين، فلا يتأثر، ولا يتذكر، ولا يرجع، ولا يراجع نفسه، على أساس ما هدى إليه القرآن، بل يُصرّ وفق هوى نفسه، يُصرّ على ما تقتضيه رغبته الشخصية، ومزاجه الشخصي، فهي حالة خطيرة جدًا.
ولهذا يقول الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ}[الكهف: 57]، هذه حالة خطيرة جدًا على الإنسان، في أي موضوع، في أي قضية، في أي مشكلة، الإنسان في مسيرة حياته:
سواءً في الأشياء التي ترتبط برغباتك، وشهواتك، ورغباتك الشخصية والنفسية.
أو الأشياء التي لها علاقة بانفعالاتك، وسخطك، وغضبك.
أو الأشياء التي تؤثر عليك فيها المخاوف.
لا يصرفك شيء عن الاستجابة لله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، والاتِّباع لآياته: لا تتأثر بالعوامل النفسية في حالة الانفعال والغضب، فلا تقبل آيات الله فيما تهدي إليه، في قضية، في موقف، في أي مسألة معينة، ولا تؤثر عليك الرغبات والشهوات، فتنحرف بك عمَّا يأمر الله به في آياته المباركة، ولا تؤثر عليك المخاوف كذلك، فتصرفك عن الاهتداء بآيات الله، وعن الإذعان لأمر الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”.
الإنسان مصيره مرتبطٌ بذلك، بمدى اهتدائه بالقرآن، بمدى إصغائه لآيات الله، لتوجيهات الله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، وفي ذلك الخير والفلاح، الإنسان إذا استجاب لله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، واهتدى بهديه، سار على طريق النجاة، والفلاح، والفوز، يؤتى يوم القيامة كتابه بيمينه، يكون من الفائزين، من المفلحين.
ثم نحن كأمةٍ إسلامية، في موقفنا من أعداء القرآن، ولا سيما ونحن في هذه المراحل نشهد حربًا مسيئةً مستمرةً تستهدفنا كأمة إسلامية، تجاه هذا المقدس العظيم (كتاب الله)، هناك- حتى في هذه الأيام (في الدنمارك، في دول أوروبية)، وتكررت في العالم الغربي- حالات الإحراق للمصاحف، في حفلات يعملونها، يجتمعون فيها، يصورون، يوثقون، ثم يقومون بأحراق المصحف.
جرائمهم تلك هي تشكل خطورةً عليهم، وهي في سياق ما هم فيه- في المجتمع الغربي، في العالم الغربي، في أوروبا والغرب- ما هم فيه من ضلال مبين، وانحراف عن الرسالة الإلهية، وكفرٍ بالله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” ورسله وأنبيائه، وكفرٍ بالشرع الإلهي والتعليمات الإلهية، واتجاهٍ نحو الإلحاد، نحو الكفر، نحو الفساد، إلى أحط مستوى من مستويات الفساد، يروجون لما يسمونه بالمثلية، التي تعني جريمة الفساد الأخلاقي، ومجتمعاتهم تلك، مجتمعات تنتشر فيها الجرائم، والمفاسد، والمنكرات، ويرتبطون بالشيطان، وانحرفوا عن رسالة الله، ورسله، وأنبيائه.
يقودهم في ذلك: اللوبي الصهيوني اليهودي، هو الذي يقود تلك الحالة من الانحراف عن منهج الله، وعن رسالته، ورسله، وأنبيائه، ويدفع بهم إلى الإساءة إلى الله، الإساءة إلى أنبيائه ورسله، الإساءة إلى كتبه، المحاربة لتعليماته، يسعى إلى أن ينحرف بهم عن الأخلاق الفطرية الإنسانية، التي تميز الإنسان عن بقية الحيوانات، يسعى إلى تفريغهم من إنسانيتهم بشكل تام.
وهو بذلك يُضِلهم، يُهلِكهم، وهذا يسبب لهم- بشكلٍ تلقائي في حياتهم- الكثير من المشاكل، والأزمات، والذي يتأمل واقعهم يرى بكل وضوح أنهم يتجهون إلى الانحدار، إلى الحضيض، إلى الهاوية، مجتمعاتهم غارقة بالمشاكل والأزمات الاجتماعية المتفاقمة: الأسرة تتفكك، المجتمع يتفكك، الإنسان ينشأ في بيئة لا يحس بأنه في منبت إنساني، في حاضنة إنسانية، يعيش في وضعية مختلفة، مفككة، بدون رعاية، بدون حنان، بدون عاطفة، بدون تربية.
ولهذا آثار سلبية عندهم، الإحصائيات التي تتحدث عن انتشار الجرائم عندهم، إحصائيات مهولة، ورهيبة، ومذهلة، الجرائم عندهم على مستوى الدقيقة الواحدة، أعداد كبيرة تُسجَّل من الجرائم في مجتمعاتهم، أنواع الجرائم، مختلف الجرائم.
كلما غيبوا الرسالة الإلهية في مبادئها، وأخلاقها، وتعاليمها، وانحرفوا عن القيم الفطرية الإنسانية؛ كلما توحشوا، كلما انحطوا، كلما فقدوا إنسانيتهم، وكلما انتشرت معدلات الجرائم وأصناف الجرائم، وارتفعت معدلات الجرائم في واقعهم، إضافةً إلى ما يسببه هذا لهم من سخط الله، وغضب الله، والعقوبات الإلهية، التي لها أنواع كثيرة، عقوبات الله هي أنواعٌ واسعة، أنواع العذاب أنواع واسعة، فهم لا يزالون تصيبهم بما صنعوا قارعة، والواقع يشهد، واقعهم يشهد، وسيتضح ذلك أيضًا في مستقبلهم أكثر؛ لأن الوعيد الإلهي هو وعيدٌ صادق، يتحقق حتمًا، لا ريب في ذلك، لا شك في ذلك.
لكن بالنسبة لنا نحن المسلمين، يجب أن يكون لنا موقف، تجاه محاربتهم للإسلام والقرآن، عداؤهم للقرآن هو عداءٌ صريحٌ للإسلام، والإسلام فيما يعنيه لنا هو ديننا، وديننا يجب أن يكون أغلى عندنا من كل شيء، أهم عندنا من كل شيء، لسنا بشيء إلا بديننا، بدون الدين الإلهي، الذي أكرمنا الله به، بدون القرآن الكريم، محتوى الرسالة الإلهية، الذي شرفنا الله به، وقال عنه: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ}[الزخرف: من الآية44]، نحن لا شيء، نحن ضائعون في الدنيا والآخرة.
انتماؤنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب عندما يحارب ديننا، أن نُستفز عندما تستهدف مقدساتنا، وأن يكون لنا موقف كمسؤولية، الأمة الإسلامية قادرة على أن يكون لها مواقف، مواقف هي بمقدورها، تستطيعها، وليست مكلِّفة، وليست ضارةً بها، وليست مؤثرة عليها، ولكنها مواقف ذات تأثير كبير على أولئك: موقف التعبئة التوعوية، وإعلان الموقف في التعبير عن ذلك، والمقاطعة للبضائع.
الغرب بشكلٍ عام- والدول الأوروبية منه- صنمهم الحقيقي الذي يعبدونه هو المال، هو صنمهم، هم أمة مادية، غارقة في المادة، أهم شيء عندها هو المادة، هو المال، كل وجهتهم في الحياة نحو المال، كل اهتمامهم منصَّبٌ نحو المال، لو توحدت الأمة الإسلامية، في هذا الموقف فحسب، في هذا الموقف فحسب، في المقاطعة لبضائع كل تلك الدول، التي تفتح المجال لإحراق المصاحف، وتجعل لذلك حماية قانونية، لو اتخذت الأمة الإسلامية، وهي أكبر سوق الآن في العالم؛ لأنها أمة مستهلكة، وليست منتجة، فهي سوق كبيرة وضخمة، ويعتمد عليها الآخرون إلى حدٍ كبير في بضائعهم، لأركعت أولئك، ولأرغمتهم على أن يتراجعوا عن ذلك، وأن يكفوا عن ذلك، وهنا تأتي المسؤولية في الموقف الممكن.
الأمة ستحاسب، وتُسأل وتجازى، عندما تترك ما يمكنها أن تفعله وهو في إطار مسئوليتها، في نطاق مسؤولياتها وواجباتها، ثم لا تفعله، لو توحدت كلمة المسلمين على هذا المستوى: مقاطعة جادة، وقرار صارم وحازم في ذلك، لأرغموا أولئك؛ لأنهم- كما قلنا- هم عُبَّاد المال، هو صنمهم الأكبر، الذي يعبدونه من دون الله، ويتجهون إليه، ويعطونه أهميةً فوق كل شيء.
طبعًا إذا لم تتجه الأمة الإسلامية بشكلٍ عام، فلا يعني ذلك أن يتنصل الكل، أو أن يرهن الإنسان موقفه بالبقية، هو الموقف الصحيح، الذي سيكون له فاعلية كبيرة جدًا، لو اجتمعت كلمة المسلمين– أكثر من خمسين دولة، أكثر من مليار إنسان- لمقاطعة تلك البضائع، وهم أكبر سوق لها، هو الموقف الفاعل، الموقف المؤثر، الذي كان- بلا شك- سيرغم أولئك على أن يمنعوا منعًا باتًا إحراق القرآن الكريم، وأن يحترموا هذه الأمة، أن ينظروا إليها باحترام، أن يقدروا لها مقدساتها، وحرماتها، ودينها؛ لأن في هذا استهتار بالأمة، إهانة للأمة، استخفاف بالأمة، في أقدس مقدساتها، الذي يفترض أنه أهم شيء لديها، لكن على الإنسان بشكل شخصي، وعلى كل الذين يحملون الوعي ويستشعرون المسؤولية، أن يكون لهم هم موقف، حتى لو لم يحصل الموقف العام؛ نتيجةً للتخاذل، والتفريط، والتقصير، ونقص الوعي، ونقص الإيمان، ونقص الاستشعار للمسؤولية، فأن يكون لهم موقف:
بالكلام، بالتعبير عن سخطهم، عن غضبهم، بالرد.
في التوجه إلى القرآن، للاهتمام به أكثر؛ حتى يرى أولئك أن النتيجة هي: أن تندفع هذه الأمة أكثر وأكثر نحو الاهتمام بالقرآن، والتقديس للقرآن، والصلة الوثيقة بالقرآن الكريم.
ثم على مستوى المقاطعة للبضائع، أن يكون هناك موقف حازم، وأن يكون موقفٌ قوي، في المستوى الذي يمكن أن يتحقق، الدعوة تكون دعوة جامعه وشاملة للجميع، وفي الواقع العملي التنفيذي: أن يتجه الإنسان ليكون ممن يتبنى موقفه، ممن لا يتنصر، ممن لا يفرط، ممن لا يهمل، ممن يعبّر عن إيمانه، عن تقواه لله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”، عن استشعاره للمسؤولية، عن التزامه، عن تقديسه لمقدساته؛ لأن المسألة- أيضًا كما قلنا- فيها سخرية واستهتار بهذه الأمة، والله المستعان.
في شهر رمضان- كما قلنا- ينبغي أن يكون هناك إقبال أكبر إلى القرآن الكريم، وأثر القرآن التربوي، وأثره العظيم، وبركاته، في نفس الإنسان، وفي حياته، وفي واقع المجتمع الذي يُقبِل إليه، ويسعى للاهتداء به، بركات عظيمة، وأثر عظيم، وهو صلة عظيمة بالله “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى”.
نَسْأَلُ اللَّهَ “سُبحَانَهُ وَتَعَالَى” أَنْ يَهدِيَنَا وَإِيَّاكُم بِالقُرْآنِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَتَقبَّل مِنَّا وَمِنْكُمُ الصِّيَام، وَالقِيَام، وَصَالِحَ الأَعْمَال، وَأَنْ يَرْحَمَ شُهَدَاءَنَا الأَبرَار، وَأَنْ يَشْفِيَ جَرْحَانَا، وَأَنْ يُفَرِّجَ عَنْ أَسْرَانَا، وَأَنْ يَنصُرنَا بِنَصْرِه، إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاء.
وَالسَّــــلَامُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَــــةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتـــُه؛؛؛