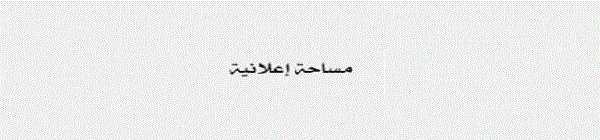كلمة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة ذكرى يوم الولاية (نص+فيديو)
كلمة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة ذكرى يوم الولاية 18-12-1443 هـ 17-07-2022
أَعُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيْمِ
بِـسْـــمِ اللهِ الرَّحْـمَـنِ الرَّحِـيْـمِ
الحمدُ لله رَبِّ العالمين، وأَشهَـدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ الملكُ الحقُّ المُبين، وأشهَدُ أنَّ سيدَنا مُحَمَّــداً عبدُهُ ورَسُــوْلُه خاتمُ النبيين.
اللّهم صَلِّ على مُحَمَّــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّــد، وبارِكْ على مُحَمَّــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّــد، كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين.
أيُّها الإخوة والأخوات
السَّـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ؛؛؛
نتوجه بالمباركة والتهاني لشعبنا اليمني المسلم العزيز، ولكافة المؤمنين والمؤمنات في مختلف بقاع الأرض، بهذه المناسبة المباركة العظيمة: مناسبة يوم الغدير (يوم الولاية).
وشعبنا العزيز احتفل بهذه المناسبة في هذا اليوم احتفالاً كبيراً وعظيماً في كثيرٍ من المحافظات، وكان الحضور الشعبي حضوراً كبيراً، ويحتفل شعبنا في هذا العام كما هي العادة في كل الأعوام الماضية، وعلى مدى الأجيال والقرون الماضية، فهي مناسبةٌ أصيلة يحتفل بها شعبنا، ويتوارثها شعبنا ضمن موروثه الإيماني؛ لأنه يمن الإيمان والحكمة، فمن ضمن موروثه الإيماني- الذي ورثه جيلاً بعد جيل- هو إحياء هذه المناسبة.
وإحياء هذه المناسبة له أهميةٌ كبيرة من جوانب متعددة:
فهو أولاً من الشكر لله “سبحانه وتعالى”؛ لأنها مناسبةٌ عظيمةٌ، لها صلةٌ بكمال الدين وتمام النعمة، ففي هذه المناسبة نزل قول الله “تبارك وتعالى”: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة: من الآية3]، وأيٌّ نعمةٍ أعظم من نعمة الله “سبحانه وتعالى” بالدين، وبكماله، وبتمام النعمة به، فهي نعمةٌ عظيمة، فواحدٌ مما نعبِّر به عن شكرنا لله “سبحانه وتعالى”: أن نحتفل، وأن نعترف لله “سبحانه وتعالى” بنعمته، وعظيم فضله، وأن نتوجه إليه بالشكر.
كما أنَّ من أهم ما في هذه المناسبة، ومن أهم ما يفيده إحياؤها، هو: أيضاً الحفظ للنص والبلاغ النبوي العظيم، الذي نزل بشأنه آيةٌ عظيمة، هي قول الله “تبارك وتعالى”: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}[المائدة: الآية67]، هذا البلاغ النبوي العظيم، الذي له هذه الأهمية التي وردت في الآية، والتي سنتحدث عن بعضٍ مما تدل عليه وتفيده في نصها الواضح، الذي يلفت النظر بشكلٍ مباشر إلى الأهمية القصوى لهذا البلاغ.
الحفاظ على هذا البلاغ، وإعلانه في أوساط الأمة جيلاً بعد جيل، من الحفظ لنصٍ مهمٍ ومبدأ عظيم من مبادئ الدين، ومن النصوص النبوية، التي تمثل أساساً مهماً في الدين، الحفاظ عليه، والتبليغ له، بلاغ حرص النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” إلى أن يصل إلى كل الأمة، قال للحاضرين، وهم كانوا عشرات الألوف، قال لهم: ((ألا هل بلغت؟))، وعندما أقروا له بالبلاغ، قال: ((اللهم فاشهد))، ثم قال لهم: ((فليبلغ الشاهد منكم الغائب))، كان حريصاً على أن يصل هذا البلاغ للأمة، وأن تسمع به الأمة، وأن تعرف به الأمة؛ لأهميته لها، للأمة نفسها، فالحفاظ على هذا البلاغ، وإعلانه، وإيصاله إلى الناس، والتأمل فيه، والتأمل في دلالاته، ولا سيما وهو محارب، محاربٌ بالكتمان، محاربٌ في دلالته ومعناه، محاربٌ فيما يفيده، حربٌ شعواء موجهةٌ ضده على مدى أجيال وقرون في داخل الأمة، فالحفاظ على هذا النص والتبليغ له أيضاً من الأعمال العظيمة، من الأعمال الدينية، مما يؤجر الإنسان ويثاب عليه، إن انطلق فيه بنيةٍ خالصةٍ لله “سبحانه وتعالى”.
مما يفيد إحياء هذه المناسبة، مما يفيده إضافةً إلى ذلك، هو: الترسيخ لمبدأٍ عظيم، هو مبدأ الولاية، الذي يحمي الأمة من الاختراق من جانب أعدائها، ويحصنها من داخلها من تأثير المنافقين فيها، والأمة في أمس الحاجة؛ لأن الأعداء يسعون إلى اختراقها فيما يتعلق بالولاية، الولاية لأمرها من جانب، والولاء في الموقف أيضاً من جانبٍ آخر، فالمسألة لها أهميتها الكبيرة، وسنتحدث عن هذه المسألة بشكلٍ أكبر في إطار الكلمة إن شاء الله.
أمَّا مضمون المناسبة، وقصة الغدير، وحديث الولاية، فالرسول “صلوات الله عليه وعلى آله”- طبعاً ومن أهم ما في المناسبة أن يُعلن هذا البلاغ، أن يتم الحديث عنه، أن تتم قراءته، هذه مسألة مهمة جدَّا، ولو تكرر هذا، ولو استغرب الناس كيف يقرأ عليهم كل عام، هذه مسألة مهمة، الأمور المهمة في الدين تحتاج إلى تكرار، إلى ترسيخ، إلى تأمل، إلى تفهم؛ ولذلك لا ينبغي الملل من مسألة أن الإنسان يسمع في كل عام، في كل مناسبة، ما ورد، الأمر في غاية الأهمية- الرسول “صلوات الله عليه وعلى آله” في أواخر السنة العاشرة من الهجرة النبوية أعلمه الله “سبحانه وتعالى” أن أجله قد اقترب، وأن رحيله من هذه الحياة قد اقترب، ورسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله” يفكر بهذه الأمة، ويهمه أمرها، ليس فقط في عصره، وفي زمنه، وللجيل الذي عايشه وعاصره؛ لأنه رسول الله للعالمين، إلى آخر أيام الدنيا، ويهمه أمته في مستقبلها، ما بعد وفاته، وللأجيال اللاحقة، هو رسول الله إليها جميعاً، وهو بما أخبره الله به، وبلغه الله به، وبما عرَّفه الله به أيضاً عن ماضي الأمم ما بعد أنبيائها، يعني: ما عرّفه الله به عن مستقبل أمته من جانب، وما بلغه وأخبره به في القرآن الكريم، وفي غير القرآن الكريم عن طريق الوحي، عمَّا حدث للأمم الماضية بعد أنبيائها، ومن ضمن تلك الأمم بنو إسرائيل، ما حدث في واقعهم بعد أنبيائهم، ما حصل في المجتمع البشري، وفي أمة عيسى “عليه السلام” بعده، وهكذا كان النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” يهمه مستقبل هذه الأمة، ويتألم ويقلق على هذا المستقبل، بما يحدث فيه من الفتن، والفرقة، والاختلاف، وما تواجهه الأمة من مخاطر وتحديات، وكان يلفت نظر الأمة إلى هذه المخاطر، إلى طبيعة هذه التحديات الآتية في واقع الأمة، وأكبر المخاطر على الأمة ما بعد نبيها، أي أمة، الأمم الماضية، وأمتنا بعد نبيها خاتم الأنبياء رسول الله محمد “صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله”، هي الفتن، ومخاطر الانحراف والزيغ، والتحريف في الدين، هذه تمثل قضية خطيرة جدَّا.
ولهذا كان النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” يلفت نظر الأمة إلى هذه المخاطر، من ضمن ذلك ما ورد عنه أنه قال: ((أيها الناس، سُعِّرت النار، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم))، وكذلك تحدث عن الانحراف، فقال في الحديث المعروف عنه، روته الأمة بمختلف اتجاهاتها ومذاهبها: ((لتحذن حذو من قبلكم))، قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: ((فمن؟))، وكذلك في روايةٍ أخرى، قال: ((لتحذن حذو بني إسرائيل))، حالة خطيرة جدَّا من الانحراف، تهدد الأمة في مستقبلها ما بعد وفاة رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، إلى درجة رهيبة، إلى درجة رهيبة جدَّا، إلى درجة أنَّ الجيل الذي عاصر الرسول “صلوات الله عليه وعلى آله”، وسمعه، وعايشه من المسلمين، معرَّضٌ لهذا الخطر، ويواجه هذه الحالة الخطيرة جدَّا، فمن المعروف بين الأمة في مصادرها المعتبرة أنَّ رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله وسلم” قال: ((ليردنَّ عَلَيَّ الحوض))، يعني: يوم القيامة في ساحة القيامة، في ساحة الحساب، ((ليردنَّ عَلَيَّ رجالٌ ممن صَاحَبَني، حتى إذا رأيتهم))، يعني: قد اقتربوا مني، ((رأيتهم، ورفعوا إليَّ، اُختُلِجُوا دوني))، يعني: يحال بينهم وبين التقدم إليَّ، ويُذهَب بهم في الاتجاه الآخر، الاتجاه الذي هو إلى أصحاب النار، ((فأقول: أَيْ رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: بُعْداً بُعْداً))، وفي الروايات الأخرى: ((سحقاً سحقاً)).
هذه الحالة الخطيرة، التي تهدد هذه الأمة في مستقبلها ما بعد رحيل النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” منها، حالة خطيرة جدَّا، تهم رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، الذي هو كما قال الله عنه: {وَسِرَاجًا مُنِيرًا}[الأحزاب: من الآية46]، نور، نور، وهادٍ للأمة، يحرص على هداية الناس، يقلق عليهم، ويخاف عليهم من الضلال، ومن الزيغ، ومن الانحراف؛ لعواقبه السيئة عليهم في الدنيا وفي الآخرة.
ولذلك اتجه رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”- بهدايةٍ من الله “سبحانه وتعالى”، وأمرٍ من الله “سبحانه وتعالى”- إلى القيام بترتيباتٍ مهمة، تساعد هذه الأمة لمستقبلها، وتهيِّئ لها سبيل الفوز، والنجاة، والأمان من الضلال، والأمان من الزيغ والانحراف، فهيَّأ في ذلك العام الذي هو السنة العاشرة للهجرة النبوية، الذي لم يلبث بعده النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” إلَّا شهرين وأيام قلائل في العام الحادي عشر للهجرة النبوية، فرسول الله هيَّأ لحجة سمَّاها المسلمون بـ (حجة الوداع)، وأعطى هذه الحجة اهتماماً خاصاً، فحرص على أن يستنفر الأمة من مختلف بلدان المسلمين، ليحضروا في ذلك الحج على نحوٍ غير مسبوق، وبأقصى قدرٍ ممكن ، فاستدعى استدعاءً عاماً إلى مختلف البلدان، وطلب من المسلمين بأن يحضروا بأقصى حدٍ ممكن، وفعلاً كان الحضور في ذلك العام للحج مع رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله” في حجة الوداع على نحوٍ غير مسبوق- ربما- من بعد وفاة نبي الله إبراهيم “عليه السلام” حتى ذلك العام، في واقع العرب لأول مرة يكون الحج بذلك العدد الهائل، بالنظر إلى عدد السكان في الجزيرة العربية، والبلدان التي كانت قد أسلمت، فالعدد كان كبيراً جدَّا مقارنةً بعدد السكان، وبالعدد المألوف في الحج، وبالعدد الذي كان يحج فيما قبل ذلك من الأعوام.
وحج رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، وفي الحج حرص على أن يُشعِر المسلمين باقتراب أجله، وبأنَّ تلك الحجة هي حجة الوداع، أنَّ ذلك الحج سيودِّع فيه أمته، وأنَّ له أهمية خاصة؛ لأنه سيقدِّم للأمة فيه أهم التوصيات التي ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار في مستقبلها، وما بعد رحيله “صلوات الله عليه وعلى آله وسلم” عنها؛ ولذلك قال لهم في حجة الوداع في خطابه في عرفات: ((ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا))، وكان يقول لهم في مقامٍ آخر: ((إني أوشك أن أدعى فأجيب))، فكان يشعرهم بقرب رحيله، وهذه مسألة هامة جدَّا، كبيرة، ومؤلمة، ومقلقة، وحسَّاسة، وتبرز عندها علامات الاستفهام: ماذا بعد رحيل رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”؟ كيف تفعل الأمة؟ لأن الدور العظيم الذي يقوم به الرسول “صلوات الله عليه وعلى آله” في قيادة الأمة، وهداية الأمة، دورٌ أساسي، ومعنى ذلك: أنَّ النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” برحيله سيترك فراغاً كبيراً جدَّا في واقع الأمة، فراغاً في هذا الموقع: موقع هداية الأمة، وقيادة الأمة على أساس منهج الله “سبحانه وتعالى”، ووحيه، وتشريعاته، وهديه، فالمسألة كانت في غاية الأهمية، ومسألة كبيرة جدَّا.
عندما عاد رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله” من الحج، ووصل في الجُحْفَة إلى وادي خم، منطقة قريبة من مكة، هي ما قبل مفترق الطرق للحجاج، هي المنطقة الأخيرة قبيل مفترق طرق الحجاج، التي يتجهون منها إلى مختلف بلدانهم، ويتفرَّقون إلى مختلف بلدانهم.
والاختيار لذلك المكان كان بتدبيرٍ إلهيٍ، بتدبيرٍ من الله “سبحانه وتعالى”؛ لأن الرسول “صلوات الله عليه وعلى آله” في تبليغه لرسالات الله، سواءً في المضمون، أو الوقت، أو الطريقة، كان يعتمد على أمر الله “سبحانه وتعالى”، وتوجيهات الله “سبحانه وتعالى”، ووفق تدبير الله وأمره؛ ولذلك فمن العجيب أن يكون ذلك الموقع، أن تكون تلك المنطقة ما قبل مفترق الطرق، وكأن فيها إشارة إلى مفترق الطرق التي ستحدث في داخل هذه الأمة، في واقع هذه الأمة، في اتجاهات هذه الأمة، وما الذي يضمن لها أن يكون اتجاهها اتجاهاً صحيحاً، قبيل مفترق الطرق، إشارة عجيبة، ولفتة عجيبة جدَّا.
في ذلك الموقع، في تلك المنطقة، نزل عليه قول الله “تبارك وتعالى”: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}، هذه الآية المباركة- وهي من آخر الآيات القرآنية التي نزلت في تلك الفترة الأخيرة من حياة رسول الله “صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله”- آيةٌ عجيبة؛ لأنها تضمَّنت التأكيد على النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” بإبلاغ أمرٍ في غاية الأهمية، أهميته لدرجة أنه لو لم يُبَلَّغ، فأثر ذلك على الرسالة بكلها، وكأنَّ رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله” لم يُبَلِّغها أصلاً، {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}، مع أنه في تلك الفترة، تلك الأسابيع الأخيرة من حياته “صلوات الله عليه وعلى آله”، قد بلَّغ مبادئ الإسلام الكبرى: في مسألة التوحيد لله “سبحانه وتعالى”، وما يتصل بمعرفة الله، والفرائض الإلهية، وأركان الإسلام… وغير ذلك من الأمور الكثيرة، والتفاصيل الكثيرة، التي أتى بها عن الله “سبحانه وتعالى”، لكنَّ هذا الأمر له أهمية كبيرة جدَّا، يرتبط به استقامة أمر الدين، حيوية الدين، فاعلية محتوى الرسالة الإلهية في واقع الأمة، وبدونه تتعطل وتتجمد الرسالة الإلهية في فاعليتها، في أثرها المفترض، في دورها الكبير، في أثرها الفاعل في حياة الناس، {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}.
إضافةً إلى أنَّ هذا الأمر يمثل حساسيةً كبيرةً لدى الناس أكثر من أيِّ مسألةٍ أخرى، يعني: ليس هناك مسألة حسَّاسة عليها تنازع، عليها تركيز، عليها تشدد، تمثل حساسية كبيرة لدى الناس، مثل هذا الأمر، موضوع في غاية الحساسية لدى الناس، ولهذا أتى ما يعبِّر ويدل على هذا الأمر بكل وضوح، قوله “سبحانه وتعالى”: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}، المسألة في حساسيتها وتأثيراتها إلى درجة أن يتخوَّف النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” على التأثيرات السلبية التي يمكن أن تحصل في واقع الأمة، في واقع الناس، نتيجةً لإبلاغ هذا الأمر، ما قد يحصل من ردة فعلٍ سلبية جدَّا في الواقع، فالله طمأنه تجاه هذا الأمر؛ لأنه يخاف على الأمة، يخاف على المسلمين، يخاف على الإسلام، فطمأنه الله “سبحانه وتعالى” تجاه هذا الأمر؛ لأن الله سيتدخل، ولن تكون هناك أية ردة فعل تواجه هذا البلاغ في تلك المرحلة، فطمأنه الله بذلك.
{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}، يعني: سيسلبهم الله التوفيق والهداية، فلن يهتدوا إلى أي طريقة لردة فعلٍ يواجهون بها ذلك البلاغ أثناء تبليغه، وما بعد تبليغه في ذلك المقام.
رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله” بعد نزول هذه الآية المباركة، بهذا التعبير القوي، الذي يدل على أهمية المسألة الأهمية القصوى، تعامل مع عملية التبليغ بقدر الأهمية التي تدل عليها الآية المباركة، فعقد اجتماعاً استثنائياً طارئاً، أوقف الناس ما قبل الظهيرة، في وقت حرارة الشمس اللاهبة والشديدة جدَّا، في ذلك اليوم، أوقف الناس، وأمر بمن قد تقدَّموا أن يعودوا، وانتظر باللاحقين ليصلوا، حتى اجتمع الجمع بكله، كل أولئك الحجاج الذين كانوا برفقته في الحج، اجتمعوا بأجمعهم، أمر المنادي أن ينادي: (الصلاة جامعة)، هذا النداء كان يأتي ليس فقط للصلاة، كان يأتي أيضاً لكل أمرٍ مهم، لكل دعوةٍ يدعو الرسول “صلوات الله عليه وعلى آله” إلى الاجتماع من أجلها، أو موضوعٍ معين استثنائي يدعو الناس للاجتماع من شأنه، اجتمع الكل، وكان النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” قد هيأ مكان الاجتماع، فأمر بدوحاتٍ كانت (عدة شجيرات) كانت موجودةً في مكان الاجتماع، أمر أن ينظف ما تحتهن من الشوك، قُمَّ ما تحتهن من الشوك، وصلَّى تحتهن، صلَّى بالناس صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر التفت إليهم، وقام يخاطبهم، فقال:
((أيها الناس إن الله أمرني بأمرٍ، فقال: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}[المائدة: الآية67]))، ونادا علياً، وأخذ بيده معه، وأصعده معه على أقتاب الإبل، التي كان قد أمر أن ترص له وأن تهيأ كمنبر، ليظهر من عليه فيكون واضحاً أمام كل الجمع، أمام أولئك العشرات الآلاف من الحجاج، فظهر على ذلك المنبر وبدأ خطابه، نحن اقتطفنا مقتطفات من خطاب الغدير من المصادر المعتبرة لدى الأمة بمختلف مذاهبها؛ لأن هذه النصوص وردت في مصادر الأمة بمختلف مذاهبها، وليست فقط لدى مذهبٍ واحد؛ لأن هذه المسألة ثابتة قطعاً، لا شك في ذلك.
كان في مقدمة خطابه “صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله” في ذلك الاجتماع، في المقدمة قوله “صلى الله عليه وعلى آله وسلم” وقد أقام عليًّا عن يمينه: ((الحمد لله))، طبعاً بعد البسملة هذه مقدمة ((الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، وأشهد ألَّا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، يا أيها الناس، إني قد نبأني اللطيف الخبير أنه لن يعمر نبيٌ إلا مثل نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني قد يوشك أن أدعى فأجيب))، وفي بعض الروايات في بعض المصادر: ((ألا وإني أوشك أن أفارقكم))، قوله: ((أن أدعى فأجيب)) يعني هذا، داعي الله “سبحانه وتعالى”: الرحيل من هذه الحياة، ((وإني مسؤولٌ، وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟))، يوجه هذا الخطاب إليهم: ((فماذا أنتم قائلون؟))، قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت، وجاهدت، ونصحت. شهدوا له بالبلاغ وإقامة الحجة، قال: ((أليس تشهدون ألَّا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق، وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حقٌ بعد الموت، وأن الساعة أتيةٌ لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وتؤمنون بالكتاب كله؟))، فقالوا: بلى. أقروا بذلك.
ثم قال، وصل إلى الموضوع الرئيسي للخطاب: ((يا أيها الناس، إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه، فهذا عليٌّ))، وأخذ بيد عليٍّ “عليه السلام” ورفع يده مع يده، في بعض الروايات، حتى رؤيَ بياض أبطيهما، ((فهذا عليٌّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله))، ثم قال: ((يا أيها الناس، إني فَرَطُكُم، وإنكم واردون عليَّ الحوض))، يعني: يوم القيامة في ساحة المحشر، ((وإني سائلكم حين تردون عَليَّ في الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر: كتاب الله “عزَّ وجلَّ”، سببٌ طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به، لا تضلوا، ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير، أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).
ثم في ذلك الخطاب، وفي ذلك المقام يستشهدهم، يستشهد السامعين والحاضرين: ((ألا هل بلغت؟))، فيقولون: اللهم بلى. فيقول، ((اللهم فاشهد))، ويكرر ذلك، ثم قال لهم: ((ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب))؛ لأنه يريد أن يصل هذا البلاغ إلى الأمة بكلها، ثم نزل قوله الله “تبارك وتعالى”: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة: من الآية3].
وهكذا قدَّم رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله” بهذا الإعلان ما يحل مشكلة الخطر الكبير الذي يهدد الأمة ما بعد رحيله، وما بعد وفاته “صلوات الله عليه وعلى آله”، من خلال هذا الإعلان.
مبدأ الولاية في الإسلام هو مبدأٌ عظيم، ومبدأٌ مهم، الإسلام بكله مبنيٌ على هذا الأساس، مبنيٌ على أن الله “سبحانه وتعالى” هو ولي الذين آمنوا، هو ولي هذا الكون بكله، خالقه، ومالكه، ومدبره، ولكن له أيضاً على عباده الولاية التشريعية، ولاية الهداية، ولاية الأمر والنهي، والإسلام مبنيٌ على هذا الأساس، الله “سبحانه وتعالى” قال في القرآن الكريم: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة: الآية257]، {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا}، هم في مسيرة حياتهم يعتمدون عليه، يؤمنون به، يتوكلون عليه، هو يرعاهم، هو يهديهم، هو ينصرهم، هو “سبحانه وتعالى” الذي شرع لهم منهج حياتهم، الذي يعتمدون عليه في مسيرة حياتهم، هو الذي يحدد لهم رموزهم وهداتهم، فلذلك هناك في الإسلام هذا الارتباط، هذه الصلة بالله “سبحانه وتعالى”، التي تبنى عليها مسيرة الحياة، تبنى عليها مسيرة الحياة في منهجية الذين آمنوا التي يعتمدون عليها في مواقفهم، في ولائهم… إلى غير ذلك من التفاصيل.
أهمية هذا المبدأ أنه يحمي الأمة من الاختراق من جانب أعدائها، ومن جانب المنافقين في داخلها؛ لأنهم يحرصون على أن يسيطروا على الأمة في كل مسيرة حياتها، في وجهتها، في مواقفها، في ولاءاتها، وفي منهجية حياتها، ولذلك رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله” بإعلانه هذا بيَّن للأمة أن الذي يصلها كما كان واقعها في حياته مبنياً على أن تسير وفق توجيهاته، وفق تعليماته، وفق الهدي الذي يقدمه إليها من الله “سبحانه وتعالى”، وأن تكون متبعةً لرسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، ملتزمةً بأوامره وتوجيهاته، بيَّن لها أن الذي يصلها بمنهجه، بهديه، بما كان عليه، يواصل مشوارها على هذا الأساس، هو أمير المؤمنين عليٌ “عليه السلام”.
وهو ما قبل هذا المقام كان يخبرها عن علي، وعليٌّ كان معروفاً في أوساط الأمة، معروفاً بكماله الإيماني، معروفاً بتميزه، معروفاً بما قاله الرسول عنه “صلوات الله عليه وعلى آله”، وما كان يقوله عنه له صلةٌ بهذا الموقع، بهذا المقام، بهذا الدور؛ لأن هذا الدور الذي يواصل من خلاله مسيرة الأمة على ما كانت عليه مع رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، بالإتِّباع لهدي الله، والتمسك بمنهج الله “سبحانه وتعالى” في مسيرة حياتها، هو موقعٌ ومقامٌ لابدَّ أن يكون الذي فيه مهتدياً بالقرآن الكريم، مستنيراً بالقرآن الكريم، متمسكاً بالقرآن الكريم، فيتحرك بالأمة، ويقود الأمة، ويهدي الأمة، ويقف بالأمة على أساس القرآن، وما يهدي إليه القرآن، ولا يفارق بالأمة عن القرآن في شيء، لا في مسيرة حياتها وفيما يقدَّم لها، ولا في مواقفها، ولا في ولاءاتها، ولا في توجهاتها.
فلذلك كان يقول لهم عن عليٍّ “عليه السلام”، كان رسول الله يقول لهم: ((عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع علي))، ليطمئنهم أن عليًّا في مواقفه، في توجهاته، فيما يقدمه للأمة، فيما يتحرك فيه بالأمة، في كل الأمور، في مختلف القضايا، في كل المسائل، سواءً المسائل التي يقدمها للأمة، كهادٍ للأمة، من موقع الهداية لها فيما شرعه الله لها، في عقائدها، في مبادئ دينها، في تعاليم دينها، أو في مواقفها وتوجهاتها، لن يحيد بها عن القرآن؛ لأنه لا يحيد عن القرآن قيد أُنمُله، سيسير بها في اتجاه القرآن، ومع القرآن.
بل قال لهم عن أمير المؤمنين “عليه السلام”: أنه يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتل النبي، وكما قاتل هو مع النبي على تنزيله، يوم يحارب القرآن في تأويله، فيما يقدمه، فيما يفيده، فيما يدعو إليه، في تعاليمه، يوم تستهدف تعاليم القرآن في واقع الأمة، تستهدف بالتحريف، تستهدف بالتزييف، وتستهدف بالانحراف في مقام العمل، في واقع العمل، في واقع الحياة، يقف عليٌّ هو لحماية هذه التعاليم القرآنية، للدفاع عنها في واقع الأمة، للحفاظ عليها في واقع الأمة، كما هو مبلغ ومعلم، وكما يقدمها بالهداية، يدافع عنها في واقع الحياة، في واقع العمل، حتى بالجهاد، حتى بالقتال، يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتل النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” على تنزيله.
من يصل بالأمة بشكلٍ صحيح برسولها، وبقرآنها، ويواصل المشوار على هذا الأساس بشكلٍ صحيح، لابدَّ أن يكون على الحق، ومع الحق، ويهدي إلى الحق، وعالماً بالحق، ومتمسكاً بالحق، وثابتاً على الحق، فلا يميل إلى الباطل أبداً، في أي موقف، في أي قضية، في أي شيءٍ يقدمه إلى الأمة، لابدَّ أن يقدم الحق نقياً، سليماً من كل شوائب الباطل، ولابدَّ أن يكون من الثابتين على هذا الحق، فرسول الله قال لهم عن عليٍّ “عليه السلام”: ((عليٌّ مع الحق، والحق مع علي))، فلاحظ كيف يطمئن هذه الأمة.
من يقوم في هذا المقام، من يصل الأمة بحقٍّ مع نبيها وقرآنها وهدي نبيها، لابدَّ أن يكون من ذوي العلم والمعرفة، بل أن يكون أعلم الأمة بهدي رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، بنور الله “سبحانه وتعالى”، ولذلك رسول الله يقول: ((أنا مدينة العلم، وعليٌّ بابها))، فيطمئن الأمة على أنه الباب إلى علم رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، فهو يصل هذه الأمة بنبيها في علمه، بنبيها في هديه، بنبيها في مسيرة حياته، فيما كان عليه، فيما يوجه إليه، فيما يأمر به.
وهكذا عندما نأتي إلى بقية الأمور، التي تحدث بها الرسول “صلوات الله عليه وعلى آله”، أو قدمها الله في القرآن الكريم، من العناوين المهمة، ذات الصلة بهذا الموقع، وبهذا المقام، وبهذا الدور، عندما قال الله “سبحانه وتعالى” في القرآن الكريم: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}[المائدة: الآية55]، يأتي ليقدم ولاية عليٍّ “عليه السلام” كصلة وامتداد لولاية الرسول “صلوات الله عليه وعلى آله” بالعناوين الإيمانية؛ لأن العنوان العظيم الذي قدَّم به عليًّا “عليه السلام” هو عنوان الإيمان، الإيمان الذي بلغ فيه عليٌّ الكمال، والمرتبة العالية، والمنزلة العظيمة، حتى سُمِّي في القرآن بصالح المؤمنين، عندما قال الله في سورة التحريم: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ}[التحريم: من الآية4]، فهو يُقَدَّم بإيمانه، بل بكمال إيمانه، بالمرتبة العالية في إيمانه.
وهو يحمل كل تلك المبادئ والقيم الإيمانية على أرقى مستوى، تحدث القرآن الكريم عن إخلاصه العظيم لله في كل أعماله، في كل توجهاته، في كل مواقفه، عن إخلاصه العظيم لله وهو يجاهد في سبيل الله، عندما قال الله “جلَّ شأنه” في القرآن الكريم: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ}[البقرة: من الآية207]، كان أول وأكبر وأهم مصاديق هذه الآية من المسلمين، من أتباع رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، هو أمير المؤمنين عليٌّ “عليه السلام”، فيشهد له القرآن أنه باع نفسه في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، يشهد له بإخلاصه الصادق، بإخلاصه التام، لا يبتغي إلا مرضات الله “جلَّ شأنه”.
شهد له في إخلاصه في مقام البذل، والعطاء، والسخاء، في قصة أولئك (اليتيم، والمسكين، والأسير) في سورة الإنسان، في إطعامهم، في إيثارهم حتى بطعامه وهو صائم، وهو جائع، {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}[الإنسان: الآية9]، ومن أهم أعمدة الإيمان، من أهم ما في الإيمان، هو: الإخلاص الصادق لله “سبحانه وتعالى”، الذي يجعل الإنسان يعمل كل ما يعمل، ويقف في كل مواقفه من أجل الله “سبحانه وتعالى”، ليس له مقصدٌ آخر، ليس له مطلبٌ آخر، ليس له أهداف، وأطماع، وأهواء، ورغبات أخرى، يعمل شيئاً من أجلها، لا سلطة، ولا هوى النفس، ولا أطماع مادية، ولا حتى المكاسب المعنوية، التي تتعلق بالصيت لدى الناس، والسمعة لدى المجتمع، {لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}.
وهكذا يقدِّمه القرآن برحمته العجيبة، في اهتمامه الكبير بأمر الناس في قوله تعالى: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}[المائدة: من الآية55]، وهو يتصدَّق بخاتمه وهو راكعٌ لذلك السائل الذي دخل مسجد رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله” يسأل الناس فلم يعطه أحدٌ شيئاً، فيشير إليه بخاتمه وهو في الصلاة، والصلاة بالنسبة لعليٍّ أعظم مقامٍ بين يدي الله “سبحانه وتعالى”، يتوجه إليه بكل قلبه، ومشاعره، ووجدانه، يعظِّم أمر الصلاة، يقيم الصلاة، ولكنه مع ذلك لا يفقد اهتمامه بأمر الناس، بأمر المستضعفين، بأمر المحتاجين، حتى في ذلك المقام المهم.
في علاقته بالله “سبحانه وتعالى”، في عمقها الوجداني، وفي جانبٍ من أهم جوانبها، يتحدث الرسول “صلوات الله عليه وعلى آله” بما يبيِّن لنا عن أعماق عليّ بشكل قاطع؛ لأن الذي يخبرنا هو الرسول، وهو يخبر عن الله، عن الله “سبحانه وتعالى” عالم الغيب والشهادة، العليم بذات الصدور.
في وقعة خيبر عندما قال رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”: ((لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله))، إنه هنا يتحدث عن إيمان عليٍّ في عمقه النفسي والوجداني، في جانبٍ من أهم الجوانب الإيمانية، التي يبنى عليها الإيمان، ويقوم عليها الإيمان، وهو المحبة لله ورسوله، المحبة الصادقة التي كانت قد ملأت قلب عليٍّ، ووجدان عليّ، وهكذا قُدِّم لنا عليٌّ في القرآن، وفيما قاله رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، قُدِّم لنا أيضاً بباطنه في عمقه الإيماني، حتى بما في سريرة نفسه، بما أخبر الله عنه: عن حبه لله ورسوله، عن حبه لعباد الله، عن رحمته بعباد الله، عن إخلاصه لله، عن كماله الإيماني، عن صدقه في إيمانه، عن تفانيه في إيمانه، وقُدِّم لنا أيضاً في واقعه العملي، وفي كماله بالمؤهلات العظيمة، في ارتباطه الوثيق بالقرآن، هدايةً، ومعرفةً، وعملاً، اهتداءً، والتزاماً عملياً، وتمسكاً صادقاً، لا يحيد عنه ولا يميل أبداً، في معرفته بالحق، في هدايته إلى الحق، في تمسُّكه الدائم بالحق في كل الأحوال، في كل المواقف، في كل الظروف لا يحيد عنه ولا يميل، في علمه، ونوره، ووعيه، وبصيرته، ويقينه الذي بلغ فيه مرتبةً عالية، هو القائل: ((ما شككت في الحق منذ أُرِيتُه))، لم يتطرق إليه الشك في لحظةٍ واحدة، وهكذا في مختلف الجوانب، ثم في منزلته الرفيعة عند الله “سبحانه وتعالى”.
في حديث الراية: ((ويحبه الله ورسوله))، هو: ((يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله))، هو ولي الله الذي يحبه الله، ويحبه رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، هو الذي يجسِّد قيم رسول الله، أخلاق رسول الله، هو أعظم الناس تأثراً برسول الله، واهتداءً برسول الله، واقتداءً برسول الله، وانتفاعاً برسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، إلى درجة أن يعبِّر النبي “صلوات الله عليه وعلى آله” عن هذه الصلة، عن هذا الارتباط، عن هذه العلاقة، عن هذا التأثر بأكمل عبارةٍ عندما قال: ((عليٌّ منِّي، وأنا من عليّ))، وحينما قال أيضاً مخاطباً لأمير المؤمنين “عليه السلام”: ((أنت منِّي، وأنا منك))، فكأنه نسخة مصغرة من رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله”، انطبعت بطابع رسول الله في أخلاقه، في إيمانه، في تقواه، في مكارم الأخلاق… في بقية أمور الكمال الإيماني، ((إلَّا أنَّه)) في حديث المنزلة ((لا نبي بعدي)).
في مرتبته، ودوره، ومسؤوليته، ومقامه، أتى حديث المنزلة، المعروف بين الأمة في مختلف مصادرها المعتبرة لديها بحسب تنوع مذاهبها، وهو قول رسول الله “صلوت الله عليه وعلى آله” لعليٍّ “عليه السلام”: ((أنت منِّي بمنزلة هارون من موسى، إلَّا أنَّه لا نبي بعدي))، له هذه المنزلة في كماله، في مقامه، في عظمته، في إيمانه، في مرتبته الإيمانية في واقع الأمة، وفي دوره، في مسؤوليته، في جهده، في طبيعة الدور الذي له في هذه الأمة، وعلى أساسه يفترض أن تُبنَى علاقة الأمة به، ونظرتها إليه.
هذا هو أمير المؤمنين عليٌّ “عليه السلام” في هذا المقام العظيم، فهو يصل بالأمة، يصلها من موقع كماله للقدوة، وجدارته بالهداية، وأصالته في الامتداد، يصلها بولاية رسول الله وولاية الله “سبحانه وتعالى”، يسير بها على أساس منهج الله الحق، بشكلٍ نقيٍ، بشكلٍ صحيح، بشكلٍ سليم، وهذا ما تحتاج إليه الأمة؛ لأنها تواجه مخاطر الزيف، مخاطر الاختراق، وصولاً إلى السيطرة عليها، والانحراف بها في ولاية أمرها، وفي ولاءاتها، وفي مواقفها، وفي توجهاتها، وهذا ما حرص عليه أعداء هذه الأمة منذ وقتٍ مبكر.
حرص المنافقون ابتداءً في داخل الأمة، وحرص أعداؤها من خارجها، إلى السيطرة على هذه الأمة في الموقع المفصلي، في الموقع التوجيهي، في موقع السيطرة على القرار، في موقع التأثير على هذه الأمة في كل التفاصيل، في إدارة شؤون هذه الأمة والتحكم بها، في منهجيتها، في مواقفها، في ولاءاتها، وهو أمرٌ خطير، يمثل تهديداً كبيراً على هذه الأمة؛ لأن الأعداء حرصوا على السيطرة الحاسمة، في الموقع الذي يحسم الأمور لصالحهم، يتحكمون من خلاله بثقافة الأمة، بتوجهات الأمة، بولاءات الأمة، ويستطيعون من خلاله بالانحراف بالأمة.
ولهذا كان من أهم ما قاله الرسول “صلوات الله عليه وعلى آله” بشأن أمير المؤمنين عليٍّ “عليه السلام”: أنَّ حبه إيمان، وبغضه نفاق، وأنَّ بغضه من علامات النفاق، والمنافقون من أهم ما حرصوا عليه في نشاطهم في داخل الأمة، هو: ترسيخ العداء لأمير المؤمنين عليٍّ “عليه السلام”، هو رسم نظرة سلبية معادية تجاه عليٍّ “عليه السلام”، وكذلك التوجه بالعداء الشديد لمن له هذه الصلة الإيمانية بأمير المؤمنين عليٍّ “عليه السلام”؛ لأنهم يرون في عليٍّ الأصالة، التي تقف بوجه زيفهم، الامتداد الصحيح، الذي يحول بينهم وبين أن يتمكنوا من إضلال هذه الأمة، من إفساد هذه الأمة، من الانحراف بهذه الأمة، يمثل عليٌّ “عليه السلام” في أصالته، في كماله الإيماني، فيما قدَّمه للأمة، في خطه في داخل هذه الأمة، عقبةً أمامهم؛ ولذلك اتجهوا بكل جهد إلى فصل الأمة عن عليٍّ “عليه السلام”، فيما يمثله من أصالة، من امتدادٍ صحيح، من قدوةٍ كامل، إلى فصل الأمة عنه؛ ليتسنى لهم التحريف والتزييف في كل شيء: في مسألة المنهج، في مسألة الرموز، في مسألة المواقف… في كل شيء، وهذا ما حرصوا عليه، فلذلك بلغوا في هذا الذروة في زمن السيطرة الأموية على الأمة، وما بعد ذلك في زمن الحكومات والأنظمة التي تبنت نفس الاتجاه الأموي في داخل الأمة.
ولأنهم يدركون أهمية هذه الصلة بالإمام عليٍّ “عليه السلام”، كامتداد قدَّمه الرسول لهذه الأمة، وضمانة حقيقية لهذه الأمة، حرصوا على فصل الأمة لهذا السبب، ولسبب آخر: هم يدركون أنَّ هذه الأمة لكي تبقى محط رعاية الله، لكي تبقى صلتها بالله، بولايته، برعايته، بنصره، بتأييده قائمة، هذا كله مبنيٌ على صلتها بدينه على النحو الصحيح، بمنهجه الحق، بالاتجاه الصحيح، الذي رسمه الله “سبحانه وتعالى” لها، صلتها مبنيةٌ على هذا الأساس، وهم يريدون أن يغلبوا هذه الأمة، أن يقهروا هذه الأمة، أن يبعدوها عن هذه الصلة، التي تحظى من خلالها بتأييد الله، كما قال الله “تبارك وتعالى”: {وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ}[المائدة: الآية56]، فحرصوا وبذلوا كل الجهد على فصل الأمة، ولا يزالون يحرصون على ذلك؛ لأنهم يتجهون على أساس التزييف حتى للعناوين الدينية، للاتجاه الديني في واقع الأمة، فلا يكون بالشكل الذي يحصِّن الأمة من سيطرة أعدائها عليها، أعداؤها الذين يحرصون على تزييف دينها، مفاهيمها، على الإضلال لها، على الإفساد لها بما يدجِّنها لهم، بما يهيئها لسيطرتهم عليها دون أن تكون مشكلة، وهذا ما يعمل عليه منافقو العصر مع أعداء هذه الأمة من الكافرين، من اليهود الصهاينة ومن معهم من النصارى، هذا ما يسعى له أعداء الأمة في واقع الأمة.
نحن نرى ونشاهد كيف بذلوا جهدهم لأن يقدِّموا ما يعنونونه بالتطبيع مع إسرائيل، وهو عملية ربط هذه الأمة بالصهاينة اليهود، أن يقدِّموه تحت عناوين دينية، بدءاً من الاتفاق (اتفاق العار والخيانة)، الذي أعطوه هم اسم اتفاق [إبراهام]، يعني: إبراهيم، نسبوا، أو قدَّموا لهذا الاتفاق، الذي هو اتفاق عارٍ وخيانةٍ للإسلام، وخيانةٍ للأمة، قدَّموا له هذا العنوان الديني، وكيف ينشطون ما بعد ذلك، من خلال لقاءات، اجتماعات، حفلات، مناسبات تحت عناوين دينية، وباسم الدين؛ لكي يخضعوا هذه الأمة- باسم الدين نفسه- لتوالي اليهود والنصارى، الذين حرَّم الله ولاءهم، الذين قال عنهم: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[المائدة: من الآية51]؛ لكي يجعلوا هذه الأمة تتقبل بأن يقودها أولئك، أن يصبحوا هم في موقع القيادة، موقع القرار، موقع التوجيه، وأن يكونوا هم من يتحكمون في هذه الأمة في كل مجالاتها، في كل أمورها، حتى في ثقافتها، حتى في تقديم دينها، فيولفوا من هذا الدين ما يتناسب معهم ما لا يعارض هيمنتهم، ما لا يثمر في واقع هذه الأمة لا استقلالاً، ولا كرامةً، ولا عزة، بل أن يقدِّموا مفاهيم مزيفة، تدجن هذه الأمة وتخضعها لأعدائها.
عندما تلحظ مثلاً حرصهم على هذا الجانب، كيف أنهم حرصوا حتى في موسم الحج الأخير في أن يأتوا بشخص هو من رموز التطبيع مع إسرائيل، ممن لهم علاقةٌ مكشوفةٌ علنيةٌ بالصهاينة اليهود، وله ارتباطٌ وولاءٌ ظاهر للصهاينة اليهود، يأتون به إلى الحج، إلى الحج بكل ما يمثله الحج، فريضة دينية، ركن من أركان الإسلام، ويجعلونه هو الذي يتولى الخطبة للحجيج في عرفات، في مقام من أهم المقامات الدينية، يأتون إليه برمز من رموز الخيانة والعار، والانحراف، والتولي لليهود والنصارى، ليتولى هو الخطبة، مع أنَّ المناسبة الصحيحة، الموقع المناسب لذلك الخطيب: كان أن يذهبوا به إلى إحدى الجمار، إما إلى جمرة العقبة… أو إلى غيرها، وأن يربطوه هناك للحجيج؛ ليرموه بالحصى، كان ذلك هو المكان المناسب اللائق به، ولكنهم يجعلونه هو الذي يخاطب المسلمين، ويوجه خطاباً يفترض أن يوجه للحجيج وإلى العالم الإسلامي قاطبة، وهكذا يتجهون من العناوين الدينية، وهم أزاحوا الأمة عن عليٍّ، عن أصالة عليٍّ، عن منهج عليٍّ، عن الولاء النقي، الذي يحصِّن الأمة من الولاء لأعدائها؛ ليهيئوها لذلك.
ثم يأتي [بايدن] في هذه الأيام، في هذه الأيام التي تتزامن مع هذه المناسبة العظيمة، ليتعامل معه الجميع على أنه هو الذي يقود البشرية، عندما أتى أعلن عن نفسه أنه صهيوني، وأنه ينتمي إلى الصهاينة، وإلى الصهيونية، وأظهر في شعائر ومراسيم يقيمونها هذا الانتماء، هذا الإعلان، ومن ذلك الموقع، أمريكا التي تخضع لذلك التوجه، تقدَّم على أنها هي التي يقود البقية، يقود أولئك الذين يقدِّمون أنفسهم على أنهم يتحالفون معها، تقودهم في توجهاتهم، تقودهم في مواقفهم، وعلى أساس ذلك ترسم السياسات التي توجِّه حتى الخطاب الديني، حتى العناوين الدينية، حتى الثقافة الدينية؛ ولذلك اتجهت تلك الأنظمة العميلة إلى التغيير في مناهجها الدراسية، والتغيير لماذا؟ للثقافة التي تتحدث عن الإسلام، أو تتحدث عن أعداء الإسلام، وعن قضايا الإسلام؛ ليغيِّروا حتى النظرة، وليدرجوا فيها نظرةً أخرى إلى الصهاينة، إلى أعداء الأمة، إلى اليهود والنصارى، إلى من يحاربون هذه الأمة، ويسعون للسيطرة على هذه الأمة.
واتجهوا عملياً كذلك على مستوى القوانين، على مستوى الأنظمة، وعلى مستوى البرامج التي يعملون فيها في الساحة في بلدانهم، في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، إلى نشر الفساد، إلى الترويج للفساد، إلى مستوى الترويج للفساد الأخلاقي، إلى نشر الرذيلة بين أوساط الشباب، إلى تهيئة البيئة المهيأة للفساد، عدَّلوا حتى القوانين من أجل ذلك، بمعنى: أنَّ هذه المسألة تنزل وتصل إلى كل مجال، حتى إلى المستوى الأخلاقي، المستوى القيمي.
اتجهوا إلى إضلال الأمة في مسألة من أهم المسائل، وهي: في تحديد من هو العدو، ومن هو الصديق، فقدَّموا أعداء هذه الأمة، الذين قال الله عنهم في القرآن الكريم: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ}[المائدة: من الآية82]، قدَّموهم على أنهم هم من تتجه الأمة لتتولاهم، لتحبهم، لتقبل بهم، لتقبل بقيادتهم، لتعادي من يعاديهم، ثم جعلوا العدو الرئيسي للأمة، هو من تجعله إسرائيل عدواً أساسياً لهذه الأمة، فإذا بإسرائيل، إذا بالصهاينة اليهود، إذا بأمريكا هي التي تحدد لهذه الأمة من هو العدو، وهذا انحرافٌ كبير وخطيرٌ جدَّا عن منهج الله “سبحانه وتعالى”، فاتجهوا ليسيطروا على هذه الأمة في ولاية أمرها، في مختلف شؤونها، في واقع حياتها ومسيرة حياتها، ليكونوا هم من يحدد السياسات، من يقرر، من يأمر، من ينهى، من يوجِّه، وفي الولاءات، وفي المواقف، وفي تحديد من هو العدو، ومن هو الصديق، فالمسألة خطيرة.
فنجـــد أهمية هذا المبدأ، الذي يفصل الأمة عن سيطرة أولئك، عن تأثيراتهم؛ لأنه يفصل الأمة عن الارتباط بهم في ولاية الأمر، في التوجيهات، في التعليمات، في السياسات، وفي الولاء في الموقف، لا يتجهوا على أساس توجهاتهم.
ولـــــــذلك تجـــد من أشد الناس كرهاً وعداءً شديداً للإمام عليٍّ “عليه السلام”، ولمن يحب الإمام علياً “عليه السلام”: التكفيريين، تجدهم من أشد الناس كرهاً لأمير المؤمنين “عليه السلام” ولمن يحبه، لماذا؟ لأنهم أداة من أدوات الصهيونية، معولٌ من معاول الصهيونية للهدم في داخل هذه الأمة، فهم يتجهون في نفس الاتجاه الذي يخدم الصهيونية، فنجد أهمية هذا المبدأ المهم في حماية الأمة في هذه المرحلة، ونجد أهمية مبدأ الولاية للأمة في كل مراحل تاريخها، وتستمر أهمية هذا المبدأ في كل المراحل والأجيال.
نكتفي بهذا المقدار، ولكن نختم هذه الكلمة وفي هذه المناسبة المباركة ببعضٍ من نصوص أمير المؤمنين عليٍّ “عليه السلام”، وتتنوع تجاه مواضيع متعددة؛ للتبرك والاستفادة.
قال “عليه السلام”: ((والله لو أعطيت الأقاليم السبعة، بما تحت أفلاكها، على أن أعصي الله في نملةٍ، أسلبها جِلْبَ شعيرةٍ، ما فعلت))، لاحظوا هذه عدالة عليّ، عدالة أمير المؤمنين، هكذا نجد ((عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ))، ((عليٌّ مع الحق))، هذه العدالة التي يربِّي عليها، تربَّى عليها ويربِّي عليها، تعلَّمها ويعلِّمها، كانت هي أساساً ومنهاجاً له وهو يحكم هذه الأمة، في مرحلةٍ عادت إليه فيها الأمة، وهو يقدِّم هذا كدرسٍ للأمة فيما بعد ذلك، على مستوى جِلْب شعيرة لنملة، وتكون المكاسب كما قال: ((الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها)): الشيء الكبير جدَّا، في مقابل أن يظلم هذا المستوى البسيط من الظلم؛ لَمَا فَعَل، ((وإنَّ دنياكم عندي لأهون من ورقةٍ في فم جرادةٍ تقضمها، ما لعليٍ ولنعيمٍ يفنى، ولذةٍ لا تبقى))، طبعاً لن نكثر من التعليق؛ حتى لا نطيل في الوقت.
قال ابن عباسٍ: (دخلت على أمير المؤمنين “عليه السلام” بذي قار)، منطقة هذه ذي قار، (وهو يخصف نعله)، وهو يصلح حذاءه، (فقال لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لها)، كان أمير المؤمنين متواضعاً حتى في مقتنياته، مقتنيات بسيطة، (فقال: والله لهي أحبُّ إليَّ من إمرتكم، إلَّا أن أقيم حقاً، أو أدفع باطلاً)، يعني: الإمرة والسلطة لا تساوي عند أمير المؤمنين “عليه السلام” كسلطة، كإمرة، كمنصب، لا تساوي مفردة نعله، واحداً من حذائه، لا تساوي هذه القيمة، ليس لها هذه القيمة، قيمتها فقط عندما تكون لإحقاق الحق، ولإقامة العدل، ولدفع الظلم ودفع الباطل، هذه هي قيمتها، عندما تكون مسؤولية لهذا الهدف المقدَّس والعظيم.
ومن خطبةٍ له “عليه السلام”: ((أمَّا بعد فإنَّ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإنَّ الآخرة قد أشرفت باطِّلاع، أَلَا وإنَّ اليوم المضمار، وغداً السباق، والسَّبَقَة الجنة، والغاية النار، أَلَا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل)): أنتم في مهلة وأمل، لكن له نهاية، له حد، هو الأجل، ((فمن عمل
في أيام أمله قبل حضور أجله؛ نفعه عمله، ولم يضرره أجله، ومن قصَّر في أيام أمله قبل حضور أجله؛ فقد خسر عمله، وضره أجله، أَلَا فاعملوا في الرغبة، كما تعملون في الرهبة. أَلَا وإني لم أر كالجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها، أَلَا وإنَّ من لا ينفعه الحق؛ يضرره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى؛ يجر به الضلال إلى الردى)).
وقال “عليه السلام”: ((ما خيرٌ بخيرٍ بعده النار))، يعني: لو تحصل من الدنيا كمَّا تحصل عليه من المكاسب في موقفٍ باطل، أو بحرام، وعاقبة ذلك النار؛ ستنسى كل شيء، سينتهي كل شيء، عاقبة رهيبة، غمسة واحدة في جهنم ستنسيك كل ما كنت قد حصلت عليه من الملذات والإمكانات في هذه الدنيا، ((ما خيرٌ بخيرٍ بعده النار، وما شرٌ بشرٍ بعده الجنة))، لو واجهت في هذه الحياة من الصعوبات، والمشاق، والآلام، والأوجاع، والمعاناة، والشرور من جانب أعداء الله، ما واجهته، وعاقبتك الفوز بالجنة، والسعادة الأبدية، والنعيم العظيم الخالص؛ ستنسى كل شيء، كل تلك المعاناة تهون، لا شيء، هي ليست لا شيء، أول ما تصل إلى الجنة ستنسى كل تلك المتاعب، والآلام، والمشاق، والمعاناة، ((وما شرٌ بشرٍ بعده الجنة، وكل نعيمٍ دون الجنة فهو محقور))، لذلك لو عُرِض عليك ما عرض في مقابل أن تخسر الجنة، أن تخسر العمل والموقف الحق، الذي يصل بك إلى الجنة، لا ينبغي أن تقبل؛ لأنك خاسر، ((وكل نعيمٌ دون الجنة فهو محقور، وكل بلاءٍ دون النار فهو عافية)).
وقال “عليه السلام”: ((اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطان))، ما كان منه من جهاد ومواقف وعمل، ((لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطان، ولا التماس شيءٍ من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك، اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله “صلى الله عليه وآله” بالصلاة))، فكان هو أول من استجاب لرسول الله.
وقال “عليه السلام” وهو يتحدث عن الأعداء، عن المضلين: ((إني والله لو لقيتهم واحداً، وهم طلاع الأرض كلها))، يعني: ملئ الأرض، بكل قوتهم، وحشدهم، وعتادهم، ((إني والله لو لقيتهم واحداً، وهم طلاع الأرض كلها، ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه، والهدى الذي أنا عليه، لعلى بصيرةٍ من نفسي، ويقينٍ من ربي، وإني إلى لقاء الله لمشتاق، ولحسن ثوابه لمنتظرٌ راج، ولكنني آسى أن يلي هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال الله دولاً، وعباده خولاً، والصالحين حرباً، والفاسدين حزباً))، هذا ما كان يؤلمه على هذه الأمة.
يقول “عليه السلام”: ((إنه ليس لأنفسكم ثمنٌ إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها))، يلفت نظرنا، يلف نظر كُلٍّ منا، نفسك غالية، ثمنها كبير، ثمنها عظيم، هو الجنة، لا تبعها بأقل من الجنة، لا يستهويك أهل الضلال، أهل الباطل، بشيءٍ من حطام الدنيا التافه، عاقبته جهنم والعياذ بالله.
قال “عليه السلام”: ((أشد الذنوب ما استخف به صاحبه)).
وقال “عليه السلام”: ((بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد)).
وقال “عليه السلام”: ((في تقلب الأحوال، علم جواهر الرجال))؛ لأن البعض من الناس قد يكون في بعض الأحوال، إذا كانت الظروف متيسرة، والأجواء مريحة، رجلاً صالحاً، وجيداً، ووفياً، لكن في الظروف الصعبة، أو الظروف التي فيها مخاطر، أو تحديات، قد يتغير تماماً، فالإنسان الذي يثبت في كل الأحوال، هو إنسانٌ مبدئي تظهر أخلاقه، في مختلف الأحوال، بل يتبين حاله بشكلٍ أفضل في الظروف الصعبة والتحديات والمخاطر.
وقال “عليه السلام”: ((من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها))، يرشد إلى أهمية المشورة.
وقال “عليه السلام”: ((إضاعة الفرصة غُصة))، يلفت إلى أهمية اغتنام الفرص.
وقال “عليه السلام”: ((لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع، ولا يضارع، ولا يتبع المطامع)):
((لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع)): من لا يداهن ويجامل، فيضيع الحق بذلك.
((ولا يضارع)): لا يضعف ويتوانى ويفتر.
((ولا يتبع المطامع))، لا يخضع للأهواء والأطماع.
وقال “عليه السلام”: ((لا يترك الناس شيئاً من أمر دينهم استصلاحاً لدنياهم، إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه))، يعني: فيتضررون أكثر؛ لأنهم تركوا شيئاً من الدين لصلاح الدنيا، يتضررون أكثر مما كانوا يتوقعونه من الضرر، فضحوا بالدين من أجله.
وقال “عليه السلام”: ((من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته، أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ، كان عليه من الله حافظ)).
وقال “عليه السلام”: ((بقيت السيف أبقى عدداً، وأكثر ولداً))، الأمة المجاهدة لا تفنى، لا تنتهي، بل إنها تكثر، يمنحها الله البركة.
وقال “عليه السلام”: ((ما أضمر أحدٌ شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجه)).
وقال “عليه السلام”: ((إذا وصلت إليكم أطراف النعم، فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر)).
نكتفي بهذا المقدار من أقواله، للتبرك والاستفادة.
أمير المؤمنين “عليه السلام”، وما قدمه، وما هو فيه من الكمال في موقع القدوة، وما قدمه للأمة من موقع الهداية، هو شيءٌ عظيم، يحقق للأمة هذه الصلة المطلوبة: صلة الولاية برسولها، وبالله “سبحانه وتعالى”، وبقرآنها، وبإسلامها، يمثل الامتداد الأصيل للأمة، الذي يحمي الأمة من الاختراق من قِبل المضلين من أعدائها، ومن منافقيها، وهذا ما تحتاج إليه الأمة، ما قدمه أمير المؤمنين هو الشيء الكثير، في مآثره، في سيرته، في جهاده، في المعارف التي قدمها للأمة، وهي نورٌ وهدى، في عهده لمالكٍ الأشتر، وهو أعظم وثيقةٍ بشأن إدارة شؤون الأمة، قُدِمت للأمة من بعد وفاة رسول الله “صلوات الله عليه وعلى آله وسلم” وإلى اليوم.
نسأل الله “سبحانه وتعالى” أن يوفِّقنا وإيَّاكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرِّج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.
اللهم إنا نتولاك، ونتولى رسولك، ونتولى الإمام عليًّا، ونتولى أعلام الهدى أولياءك، ونبرأ إليك من كل أعدائك، من المضلين، والكافرين، والفاسقين، والمنافقين، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.
وَالسَّـلَامُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه؛؛؛