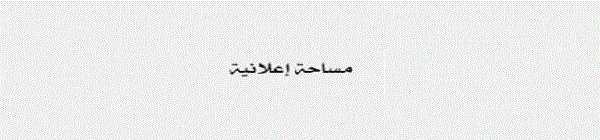صدى العقوبات ضد روسيا يسمع في واشنطن
يمانيون../
بموازاة الآفاق التشاؤمية التي تظلل الاقتصاد الدولي هذه الأيام، تستمر الصراعات الجيوسياسية في ضغوطها الهائلة على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، فتتابع الولايات المتحدة الأميركية ومعها الحلفاء الأوروبيون سياسة فرض العقوبات على روسيا، فيما تواصل الأخيرة عمليتها العسكرية بثبات في منطقة الدمباس شرقي أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تتخذ إجراءاتٍ مقابلة شديدة التأثير في اقتصادات الدول الغربية.
لقد نجحت الولايات المتحدة، إلى حدٍ كبير، في هدفها الساعي لإقامة حواجز عالية بين روسيا وكثير من الدول والأنظمة الغربية. فأخرجتها من النظام المالي الغربي، وتسبّبت، في الأسابيع الأولى للحرب، بإرباكٍ مالي واقتصادي ملموس في السوق الروسية، لكن ذلك لم يدم طويلاً، إذ استوعبت موسكو الصدمة الأولى من حزمة الإجراءات، وتابعت أعمالها العسكرية التي أفرزت ضغوطاً ثقيلة على القوى الغربية.
فالبنك المركزي الروسي أقر في مطلع أيار-مايو الماضي بتوقعات انكماش الاقتصاد بنحو 8.8% خلال العام الجاري، مع بقاء معدل التضخّم عند مستويات عالية، يرجح أن يحوم حول 20% مع استمرار النزاع في أوكرانيا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الصعوبات التي يعانيها المواطنون الروس. ومع ذلك، فإن التدهور الذي شهده سعر صرف الروبل الروسي في الأسابيع الأولى للحرب، توقف، وانقلب إلى نقيضه، حيث تحسن سعره إلى معدلات أفضل مما كان عليه ما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا. فبعد أن وصل إلى معدل 150 روبل في مقابل الدولار الواحد، سجّل في نهاية أيار/ مايو الماضي 55 روبلاً في مقابل كل دولار، وهو مستقر بهامش حركة صغير حول هذا الرقم حتى اليوم، بعد أن اتخذت القيادة الروسية قرارين جريئين زادا من قيمة الروبل، وعزّزا الطلب عليه في الأسواق الداخلية والخارجية. تمثّل القرار الأول في استيفاء ثمن الغاز الروسي المصدّر إلى الدول “غير الصديقة” بالروبل الروسي. أما الثاني فكان قرار ربط سعر الروبل بالذهب، وإعلان البنك المركزي شراء الذهب من المصارف التجارية وتحديد أسعار لذلك.
في المقابل، لا تزال القوى الغربية المتمسّكة بسياسة العقوبات ضد موسكو، تواجه رياح التشاؤم التي تهب في اتجاه اقتصاداتها. إذ يرتفع معدّل التضخم، وتزداد أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود والكهرباء. لقد أخفقت الضربة الأولى التي وجّهتها القوى الغربية إلى روسيا، وهي تعيش الآن مرحلة انعدام الوسيلة بعد تبديد الضربة التي وضعت فيها كل زخمها، وصولاً إلى معاقبة البشر، والشجر، والحجر، والحيوان.
كيف صمد الاقتصاد الروسي؟
لقد صُمّمت العقوبات الغربية التي أتت مباشرةً بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتكون ضربة حاسمة للاقتصاد الروسي، ولتجبر موسكو على التراجع سريعاً عن خطوتها الجريئة تلك. لكن تكتيك الصدمة لم ينجح، وهذا ما بات واضحاً بعد مرور أشهر على العملية، وتغيّر ظروفها، وانقلاب التأثيرات السلبية من الجانب الروسي إلى الجانب الغربي، بعدما تحوّلت الأزمة الأوكرانية إلى عبءٍ ثقيلٍ يؤرق مواطنيه وساسته.
إن البحث في أسباب هذه النتيجة يقود إلى مجموعة من الملاحظات، أبرزها ما يلي:
أولاً: طبيعة العلاقات الاقتصادية الغربية بروسيا، واعتمادها الكبير على موارد الطاقة والمواد الأولية الروسية.
ثانياً: الاختلالات الكبيرة التي يعانيها النظام الرأسمالي، الذي تتفاقم أزماته منذ سنوات طويلة، وخصوصاً منذ أزمة عام 2008، وما تبعها من أزمات كأزمة الديون الأوروبية عام 2009، وما تلاها من انعكاسات بين عامي 2010 و2012 في منطقة اليورو، ثم الانعكاسات الاقتصادية السيئة لجائحة (كوفيد 19)، وصولاً إلى تأثيرات الأزمة الأوكرانية الحالية.
ثالثاً: طبيعة الاقتصاد الروسي الذي يحفظ للدولة مكانة ودوراً كبيرين في إدارة المؤشرات الاقتصادية الكلّية، وإشراف بوتين شخصياً على هذه الإدارة، والعمل المستمر منذ سنوت طويلة على سد ثغر اقتصاد البلاد.
رابعاً: العلاقة الطردية بين سعر الغاز والنفط، والتوترات الأمنية التي يكون المنتجون الكبار طرفاً فيها.
خامساً: غياب عنصر المفاجأة في الخطوات الغربية العقابية لروسيا، خصوصاً أن إعلان العقوبات والتهديد بها أصبحا يمثلان نسقاً غربياً مستمراً تجاه روسيا، ما مكّن الإدارة الروسية من تجهيز السيناريوهات المناسبة للخطوة الغربية التالية، وهذا ما ظهر في قراري بوتين استيفاء الغاز بالروبل، وربط هذا الأخير بالذهب.
سادساً: الأسس المصلحية الجديدة التي بنت عليها روسيا تحالفاتها مع الصين ودول “بريكس” والقوى الإقليمية الأخرى كإيران، التي فتحت خيارات بديلة مكّنت موسكو من خفض تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية عليها.
سابعاً: وجود تباينات غربية حادة بشأن موضوعات مختلفة، تبرز إلى واجهة المشهد بين الفينة والأخرى. وقد شكّلت فترة ولاية ترامب، والفترة الرئاسية الحالية لجو بايدن، مساحةً جديدة خصبة لهذه الخلافات (صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا، تحالف أوكوس، تصريحات ترامب حول وجوب دفع الحلفاء ثمن حماية واشنطن لهم…)
إدارة روسية لافتة للأزمة
وبحسب البنك الدولي، يقدر حجم الاقتصاد الروسي بـ1.71 ترليون دولار، وهو إلى جانب كون مؤشراته الأساسية ترتفع قيمتها في أوقات الأزمات، يتلقى دعماً غير مباشرٍ من ثاني أكبر اقتصاد في العام وهو الاقتصاد الصيني، الذي بدوره ينمو بصورةٍ سريعة.
وإلى جانب العلاقات الإستراتيجية المميزة بالصين، نشّطت روسيا تفاعلها مع دول “بريكس” الأخرى (تسعى دول المجموعة لزيادة عدد أعضائها وإصدار عملتها الخاصة)، وشبكت علاقاتٍ متينة بإيران، وتستمر في التعاطي بهدوء وصبر مع الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الغربية التي تبدي إشاراتٍ على التمسّك بعلاقات جيدة مع موسكو. فتحليل ديناميات صناعة القرار في موسكو يفسّر عدم اتخاذها خطواتٍ حادة تجاه الدول التي دانت العملية العسكرية في أوكرانيا، ما لم تقم هذه الدول بخطواتٍ عمليةٍ مضرة. وفي هذه الإشارة، يمكن تلمّس الاختلاف الجوهري بين روسيا الاتحادية والاتحاد السوفياتي السابق من ناحية فلسفة العلاقات الاقتصادية الدولية للدولة. فروسيا هذه الأيام تتصرّف وفق المصالح، مع كثير من التفهم، وقليل من العواطف.
وفي تقدير تفصيلي، صمدت روسيا أمام الصدمة الأولى بالاعتماد أيضاً على صادراتها من المعادن والحبوب ومصادر الطاقة، التي زادت أسعارها بعد الإجراءات الغربية، لتغذّي الخزانة الروسية وتوفّر مع توفير كميات من حجم الصادرات السابق.
لقد استفاد الروبل الروسي من مسار الأحداث ليحسن قيمته إلى مستويات عام 2015، مع تعزيز صورته المتينة المدعومة من ناحية بارتباطه بالغاز الطبيعي، ومن ناحية أخرى بالذهب. حيث بات هذا الأخير السر الرابح لخطط روسيا والصين المستقبلية، فيما يخص حربهما على الدولار.
والآن، تمسك روسيا بمجموعة أوراقٍ رابحة شديدة التأثير عالمياً، أبرزها ما يلي:
أولاً: عدم وجود بدائل كافية ومستقرة في أسعارٍ منافسة للغاز الروسي.
ثانياً: احتياطات كبيرة من الذهب، يمكنها أن تشكل أساساً قوياً لدعم العملة المحلية من ناحية، وتعزيز جهود روسيا للبحث عن عملة احتياط عالمي أخرى منافسة للدولار.
ثالثاً: امتلاك أسلحة قادرة على حماية البلاد من الغزو الخارجي، وإقامة رادع في وجه القوى الكبرى.
رابعاً: امتلاك المقعد دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي، وحقّ النقض “الفيتو”، بما يمنع اتخاذ إجراءات أممية خطرة.
مؤشرات مقلقة للاقتصاد الأميركي
في حين تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخماً متسارعاً وصل إلى 11% في المملكة المتحدة، كان الرئيس الروسي يعيد الصعوبات الاقتصادية العالمية “إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة في الغرب”، لا إلى المواجهة الدائرة في أوكرانيا، معتبراً أن التذرّع بالعملية الروسية في أوكرانيا يمثّل طوق نجاة للإدارة الأميركية وللبيروقراطية الأوروبية لرمي أخطائهم على بلاده.
لكن هذه التقلبات الاقتصادية السريعة والخطرة لا تفضي إلى تراجعٍ أميركي عن تغذية المواجهة القائمة في أوكرانيا، بل إن المسؤولين في واشنطن يزيدون المساعدات العسكرية لكييف، ويتجهّزون لصراعٍ طويل الأمد في روسيا.
ففي 16 حزيران/يونيو أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ نحو 30 عاماً، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 75 نقطة أساس بهدف مواجهة ارتفاع التضخم. ويرجع السبب بحسب الفيدرالي إلى اختلالات العرض والطلب، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الضغوط التي تمثلها أسعار السلع الأخرى في السوق، والتي يعيد أهمها إلى الصعوبات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا. ولا يخفي الفيدرالي الأميركي في الوقت نفسه توقّعه مزيداً من التباطوء الاقتصادي وارتفاع البطالة في المرحلة المقبلة.
وتواجه الولايات المتحدة اليوم معركةً شرسة مع معدلات التضخم القياسية، في ظل محدودية الإجراءات الآمنة التي يمكن اتخاذها في هذه الظروف، حيث تلوح أزمة “ركود تضخمي” للمرة الأولى منذ الطفرة النفطية عام 1973، وما تلاها من تأثيرات اقتصادية سلبية حتى عام 1982.
وعلى الرغم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي التزامه “بقوة” إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، واستخدام كل الأدوات الممكنة لتحقيق ذلك، بدت كلمات رئيسه جيروم باول مخيفةً حين قال: “لا أحد يعرف إلى أين سيمضي الاقتصاد في العام المقبل”.
وعلى وقع الغضب المتنامي في الداخل الأميركي من ارتفاع معدلات الأسعار ومعدّلات التضخم، والتراجع الملموس في شعبية بايدن، لا تبدو واشنطن قادرة أو راغبة حتى اللحظة في بلورة حلٍ متوازن للأزمة الأوكرانية. مع أنها قد تكون الأقدر على تحقيق ذلك، فيما لو اعتمدت مقاربةً واقعية لشكل الحل المنتظر هناك، من دون تصفية حسابات جيوسياسية مع روسيا.
ويرى المتفائل من المراقبين للأزمة الأوكرانية وتبعاتها وللمخاطر الكارثية التي تتكاثر بمرور الوقت أن الأزمة يمكن أن تفقد زخمها شيئاً فشيئاً، مع إدراك اللاعبين الأساسيين فداحة الخسارة المتوقعة منها، من دون أن يضطروا إلى تكبد حرج التراجع، فيما يشبه “مؤامرة صمت” متبادل تفضي إلى برودٍ ميداني يفتح أبواب التفاهمات بمرور الوقت. هذا الاتجاه أيّده أحد القادة السابقين للـ”ناتو” جيمس ستافريديس حين قال: “لا أعتقد أن بوتين وزيلينسكي يمكنهما الاستمرار على المستوى القتالي الحالي سنوات أخَر. بالتأكيد يمكن الاستمرار بضعة أشهر أخرى، لكن الاستمرار سنوات غير مرجّح”.
لكنّ هذا التفاؤل لا يبدو واقعياً حتى اللحظة، نظراً إلى معطى مهم جداً يمكن اعتباره مفصلياً في مسار المواجهة، وهو تغيير القيادة الروسية إستراتيجيتها الميدانية في الأسابيع الأولى للحرب، وتركيزها على السيطرة على المناطق التي تنال فيها تأييداً شعبياً عارماً، وإغلاق الواجهتين البحريتين لأوكرانيا على بحري “آزوف” و”الأسود”، وتحويل عامل الوقت ليكون ضدّ مصلحة كييف، وضد الحلفاء الغربيين الذين يقتربون من الشتاء، بمعدلات تضخم تاريخية، وبأسعارٍ ترتفع باستمرار، وبصعوبات في توفير وقود التدفئة والإنتاج للبيوت والمؤسسات، وبآفاقٍ اقتصادية تشاؤمية، وسياسية ضبابية تضفي مزيداً من القلق على مجتمعاتها.
في الوقت نفسه، يستعيد الروبل قوته تدريجاً. ينسحب المسؤولون الصينيون مرةً أخرى من الجلسات الأممية عند بدء زيلينسكي إلقاء كلمته. يشارك بوتين في قمة “بريكس” ويعلن مع قادتها مشروع عملة خاصة بالمجموعة. يشارك أكثر من 40 دولة في مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي. توقّع عقود بقيمة تقارب 105 مليار دولار. تشارك قطر بأكبر وفد في المؤتمر. يزور لافروف طهران ويدعم إحياء الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015. وهذه الدول الثلاث الأخيرة (روسيا وإيران وقطر) هي للمفارقة أكبر ثلاث دول من حيث احتياطات الغاز وإنتاجه في العالم.