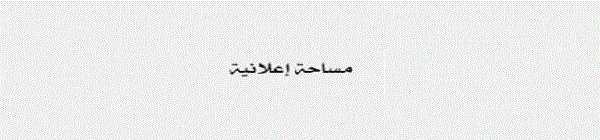ما الذي جناه جواسيس العالم عبر الأزل من عمالتهم لأعداء بلدانهم؟
يحيى الربيعي
((ليس بالضرورة أن تكون عميلاً لتخدم أعداء الوطن، يكفي أن تكون غبياً)) هذه عبارة قالها محمد الغزالي، وظلت تدور في مخيلتي منذ أن قرأتها قبيل سنوات، ظلت تدور هكذا عبثا دون أن تجد لها مناسبة أو بالأصح إحداثية كما يقال في عالم الاستخبارات العسكرية والمخابرات السرية حتى اللحظة التي عرض الإعلام الأمني فيها بعض اعترافات الخلية البريطانية التي تحاكم حاليا بجريمة التخابر لصالح الأعداء البريطانيين وتحالف الشر في العدوان على اليمن إنسانا وأرضا ومقدرات.
هذه الإحداثية التي من خلالها جاز التأكيد على أن الغباء هو قرين الجهل لا يسعف صاحبه، هؤلاء الجواسيس المغرر بهم من صديق لهم كانوا إما مجندين في صفوف وحدته العسكرية أو جهازه الأمني ارتضى الارتزاق وانسلخ عن العهد العسكري الذي قطعه ضباطها وأفرادها أنهم سيدافعون عن الوطن أرضا وإنسانا ومقدرات، ذلك الوطن الذي سرعان ما اتضح جليا أنه لم يكن شيئا يذكر في حسابات أولئك البائعين لأوطانهم مقابل حفنة من المال؛
الذين باعوا أوطانهم، بل باعوا قيمهم ومبادئهم التي أقسموا بالله أنهم سيكونون لها الحصن الحصين، حين كانوا يصرخون في ساحات معسكراتهم بدوي شعار “الله ثم الوطن الثورة الوحدة”، فلا كانوا عبيدا لله، ولا حماة للوطن، ولا حاملين لمبادئ وأهداف ثورة، وليس لهم بروح الأخوة والوحدة صلة، وإنما كانت العمالة والارتزاق والخيانة هو ما يبطنون، وأن إخلاصهم وتفانيهم لم يكن لله ولا الوطن ولا الثورة، ولا الوحدة، وإنما كانوا للشيطان أولياء، وهم الآن على حقيقتهم تلك يعملون جهارا نهارا.
أو كانوا أصدقاء معرفة لصديق لا يعرف من الصداقة إلا الخيانة والتغرير والتضليل والاستخدام غير المشروع للعلاقات الحميمة التي تربطهم به، هذا الضابط المنعدم الضمير كان من المفترض على هؤلاء الجواسيس ، إن كانوا يعرفون مصلحتهم الشخصية ويقدمونها على ما دون ذلك من مبادئ وقيم وأسس التعايش والاتصال بين الناس، ما كانوا ليركنوا إلى شخص يرون منه الشر على بلدهم جهارا نهارا، ويرون منه الالتصاق بالعدوان الذي يذيق بلدهم الأمرّين بالحرب والحصار الجائرين.
ألم يكن من الجدير بهم ألا يثقوا به لمجرد أنه كائن هذا شأنه، وهذه سلوكه؟ ألم يعلموا بأن مجرد التواصل بهكذا سلوك جريمة دستورية وأخلاقية وأمنية تعرضهم لخطر المحاكمة.
قد تكون الظروف المادية التي يمر بها المواطن اليمني صعبة وعويصة إلى درجة لم تعد تطاق، ولكن ذلك بأي حال من الأحوال لا يفتح المجال مطلقا للخيانة أو العمالة للعدو ليقتلهم.. لمن يريد أن ينهبهم وطنهم وحريتهم ويستولي على مقدراته بقدر ما يحفز الهمم لدى كل فرد في هذا الوطن نحو المواجهة والصمود في وجه تحديات هذا العدو التي يفرضها بعدوانه وحصاره لتتحول إلى فرص تخلق توازن رعب مشروع.
أليس مناسبا الاستشهاد بما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية عن “فضيحة” قيام قوات الاحتلال البريطاني بتعذيب العراقيين وانتهاك كرامتهم، والتي كشفت عنها يوم الجمعة 5-30 – 2003م أصبحت مثار اهتمام واسع حينها بعد أن خرجت عن صمتها “كيلي تيلفورد” التي أعدت “نيجاتيف” فيلم الصور، الذي أحضره إلى معملها أحد جنود الاحتلال البريطاني عقب مشاركته في العدوان على العراق، وأبدت فزعها لما شاهدته في الصور
حيث قالت الصحيفة في حينها على موقعها في الإنترنت السبت 5-31 – 2003: إن تيلفورد -22 عامًا- التي فزعت من الصور سارعت إلى إبلاغ الشرطة أن الجندي “جاري بارتلام” -18 عامًا- أحضر فيلمًا يتضمن صورًا تُظهر ارتكاب قوات الاحتلال البريطاني في العراق لأنواع مختلفة من التعذيب في حق الأسرى العراقيين، وبخاصة إكراههم على ممارسة لا أخلاقية معهم وهم مقيدون.
ونقلت الصحيفة عن السيدة تيلفورد صاحبة محل التصوير، وهي أم لطفلين، أنها شعرت بآلام في معدتها فور مشاهدتها صور تعذيب الأسرى العراقيين، ومنها صور يظهر فيها جنود احتلال بريطانيون وهم ينتهكون حقوق أسرى عراقيين، وصورة أخرى يظهر فيها أسير عراقي مكتوف الأيدي ومعلقا في رافعة آلية يقودها جندي بريطاني يظهر مبتهجا بممارسته التعذيب في الأسير العراقي”؟
أوليس مناسبا- أيضا- طرح التساؤل على هؤلاء المرتزقة ومن يسير في طريقهم: هل كان هؤلاء راضين أن تفعل التاج الخبيثة في اليمن ما صار في العراق؟ هل وصل بهم الذكاء إلى درجة أنهم نسوا أن هذه التاج وحليفتها أمريكا هم طواغيت العالم، وأنهم إن دخلوا قرية أهلكوا الحرث والنسل فيها، وأنهم من أضاع كل قيمة إنسانية على وجه المعمورة، وأن أيا منهما يمكن أن يصدق في وعوده لجواسيسه بأن يمنحوا مقامات عالية ورفاهية بعد أن خانوا بلدانهم وباعوا كل شيء من أجل حفنة من المال المدنس..؟!
كلا.. إن ذكاء من هذا النوع هو الغباء ذاته، فما الذي جناه جواسيس العالم عبر الأزل من عمالتهم لأعداء بلدانهم؟ إنهم لم يعيشوا أبدا، وقصص الجواسيس تملأ الكون ضجيجا وفضائحهم وليس ببعيد عن متناول أحد.
إن الإجابة يمكن أن تتوقف عند تساؤل أحدهم: ماذا يعني أن يكون المرء ذكيا أو غبيا؟ وماهي ضريبة كل منهما؟ ماهي الفروق بين الصفتين؟ أيمكن للمرء أن يكون غبيا فيصبح ذكيا أم العكس؟ إن وضعنا الذكاء والغباء في حلبة واحدة ليتصارعا من سيكون المنتصر في هذا الاعتراف الذي يدلي به أحد جواسيس بريطانيا الذين باعوا أنفسهم، فلنتأمل فيما يقول وهو يتحدث على لسان ذلك الضابط الذي جنده لخدمة الأهداف البريطانية في اليمن:
((قال لي: أنا أعلم أنها ورشة، هو داري أنها ورشة.. رسل لي الإحداثية من داخل الورشة.. ما دراهم إنها ورشة، مدري؟ يعني أنا داري أنها ورشة.. اشتيك تبسر لي إنهم بيصنعوا سلاح، هي وصلتنا معلومات أن هذه الورشة تصنع سلاح!
سرت إلى هناك وابسرتها حتى ما بش معها لوحة.. قال لي جنب التموين اتمنى؛ يعني بقالة.. سرت إلى هناك وابسرتها من خارج، ما دخلت إلى داخل.. ابسرتهم أنهم بيشتغلوا.. كان به قواطر هناك.. كان به حوش خلف بينه قواطر، قلت له هم بيصلحوا حق قواطر مكاين.. كنت بين ابسرهم بيخرموهن.. بيسبروا صورتها من خارج وأنا خاطي، وقلت له هذه الورشة بيسبروا.. بيجددوا مكاين الشاحنات.. قال لي تأكد ارجوك مدري ما هو.. قلت له تأكدت مابش.. قال لي ادخل إلى داخل صور لي داخل المكاين ايش هن.
رجعت إلى البيت.. فعل لي إحداثية ثانية في الأزرقين تبة فيها كسارة بيكسروا منها الحجار ويسبروا منها الحجار ويسبروها حق الزفلت.. سرت إلى هاناك وإن به كسارة شيول ومشن الذي يشنوا فيه الحجار الكبار..
جزعت إلى هناك وابسرت مابش ولا حاجة.. قال: بيسبروا معسكر! مدري ما هو؟ ما دخلتش حتى إلى داخل.. من بعيد صورتها وقلت له ما بش هذا به مناجم.. قال: بس مناجم، ورفعت له تقرير.. قلت له ما بش إن به شيول هناك صورته والحراثة التي تحفر والمشن حق الحجار؛ الغربال هاذاك.))
هذا الشاب، هل قاده الغباء الذي اختاره لنفسه سبيلا للنجاة إلى اللارشد فهل كان الذكاء في مخيلته وفي ظن رفقائه كما وصفه نيتشه مجرد “حصان جامح، تمكنوا من ترويضه وإطعامه الشوفان المناسب وتنظيفه” أم أن الغباء هو الذي استحوذ على مسار تجربتهم تلك مع العمالة، فقادهم إلى مستنقع الخيانة وما آل إليه مصيرهم؟
أم أن الحقيقة تقول إن “المال” جعلهم يتخلون عن مبادئهم إلى درجة أصبحوا فيها عبيدا لشهواتهم، فلم يعودوا يبالون بما سيلقون من الخزي والعار في العاقبة؟
بالتأمل في ثنايا الاعتراف أعلاه يدرك المتأمل نبرة الشاب الساخرة بين الكلمات رغم جِدية المحتوى الذي يرسله كإحداثية استقبلها العدو فنفذ جرائمه، فأي حال ذلك الذي يؤدي بإنسان إلى أن يختار الغباء على الذكاء فقط كي يتمكن من العيش.
أليس هؤلاء الأغبياء تظاهروا بالذكاء ليتمكنوا من العيش، وبشكل لا إرادي صاروا يتابعون الإحداثيات التي تأتيهم ويرفعوا عنها تقاريرهم من أجل غاية عارية مُجردة من أي قيمة سامية، هي غاية الحصول على القليل من المال لمجرد الاستمرار في العيش فقط لاغير.
أصبح الحصول على المال هو اللغة الوحيدة والهم الأوحد والغاية الوحيدة لهذا الدور الذكي الغبي الذي حاول أن يتقمصه هؤلاء الجواسيس حين تحركوا رغبة في التحصل على الشكليات والمظاهر كالدمى، فقد أصبح المال في وعيهم أكثر أهمية من الأوطان، بل ومن كرامتهم، لأنهم أغبياء لم يفرقوا بين الذكاء والغباء إلا في حدود ما يمكن أن يتحقق لهم من تلك الرغبات.
يذهلك مقدار السخرية والجدية في تناقض المتهم وهو يدلي باعترافاته تلك في سرد ممتنع عن الحقيقة؛ يُضحك وهو على ما هو مؤلم، حين نجد المتهم في اعترافاته لم ينفك من رؤية الشيء الذي هو لا يراه أصلا.. فإلى متى سيظل هؤلاء وأمثالهم يمارسون هذا النوع من الذكاء الغبي؟